من يقرأ المسرحية التراچيدية “ماكبث” للعبقري الإنجليزي وليام شاكسبير ، الذي ينسج فيها قصة القائد الاسكتلندي الذي دفعه طموحه المريض أن يقتل ملكه ليرث العرش، لا يملك إلا أن يشعر بوطأة الندم التي تخنق البطل وتحوّله من قائد شجاع إلى رجل مطارد بأشباح ضميره. شكسبير لم يقدّم الندم كفكرة مجردة، بل صاغها كتجربة حسّية يعيشها القارئ أو المشاهد لحظة بلحظة.
منذ اللحظة التي يقتل فيها “ماكبث” الملك “دنكن”، يبدأ الانحدار النفسي للبطل ، فيسمع أصواتًا لا يسمعها غيره، ويرى خيالات، ويغرق في عزلة داخلية. كل هذا يُشعر القارئ أن الندم ليس شعورًا عابرًا، بل سجنًا مظلما. لذا فعندما يقول البطل بعد أن شعر بفداحة ما إقترف:
“هل يغسل كل ماء البحر العظيم يديّ من هذا الدم”
فإن القارئ لا يسمع مجرد كلمات، بل يكاد يرى الدم على يدي ماكبث، ويشعر بثقل الجريمة على صدره. هذه الجريمة التي قادت بدورها البطل إلى سلسلة من الجرائم لمحاولة “إصلاح” الموقف فينتهي به الأمر إلى تصفية كل من قد يفضحه أو يهدد عرشه مما أفضى في نهاية المطاف إلى هلاكه!
مأساة ماكبث تتلخص في أن الطموح بلا ضمير يقود إلى هاوية سحيقة من الندم!
وبالنظر إلى مارتن لوثر ، الأب الشرعي لحركة الإصلاح في القرن السادس عشر ، نجد أنه تبنى ذهنية “ماكبث” في تحديه لسلطان كنيسة روما ، والعوار اللاهوتي السائد في عصره!
ذلك العوار اللاهوتي الذي ساد في الغرب اللاتيني (الكنيسة الكاثوليكية) في العصور الوسطى ، كان نتيجة لتبني الكنيسة الكاثوليكية للاهوت السكولاستكي والذي أفضى إلى حالة من فقدان البصر قادت روما إلى منتجات لاهوتية مشوهة كصكوك الغفران مثلا!
إلا أن لوثر لم يكن مجرد راهب أغسطيني كاثوليكي يسعى لإصلاح كنيسته ، لكن يمكنك أن تستشف من أقواله ، ومواقفه السياسية ، وتحالفاته مع أمراء وحكام وناخبين ألمانيا ، أن الرجل يسعى إلى الزعامة ويعرف من أين تؤكل الكتف ،وهكذا فقد عرف لوثر وأيقن أن في سلطان البابا أو في البابا نفسه حائلا بينه وبين طموحه اللامحدود للزعامة!
فقد أعلن لوثر إعلانه “الشعبوي” الشهير ، خلال دفاعه في مجمع فورمس ١٥٢١م :
«لي الحق أن أؤمن بحرية، وأن لا أكون عبدًا لسلطان أي إنسان، وأن أعترف بما يبدو لي حقًا سواء أُثبت أو لم يُثبت، سواء قاله كاثوليكي أو مبتدع. ففي أمور الإيمان، لا أرى أن لمجمع أو للبابا أو لأي إنسان سلطانًا على ضميري. وحيثما يخالفون الكتاب، أنكر البابا والمجامع والجميع. إنّ علمانيًا بسيطًا مسلّحًا بالكتاب أرفع مقامًا من أعظم بابا يفتقر إليه».
وفي طريقه “الإصلاحي” لتسديد الضربات إلى “خصمه السياسي” بابا روما ، قام لوثر -وقد لعبت خمر الزعامة برأسه- بتحطيم كل شيء اعترض طريقه ، فلم يقدر على التمييز بين الغث والسمين ، وأغلقت شهوة الزعامة عينيه فعجز أن يفرق بين الثرى والثريا!
فأخذ يكيل الضربات للكنيسة – بقضها وقضيضها – وكل ما رأي أنه قد يعترض طريق الزعامة المشتهاة ، ومن بين هذه الركائز كانت تحديه لسلطة المجامع كلها بما فيها المجامع المسكونية!
بدأ مارتن لوثر في إنكار عصمة المجامع المسكونية منذ عام. ١٥١٨، لكنه عبّر عن موقفه بوضوح لا لبس فيه خلال مناظرة لايبزيغ في يوليو ١٥١٩م. هناك، وأثناء مناظرته مع يوهان إِك، صرّح لوثر:
“أؤكد أن المجمع قد أخطأ أحيانًا وقد يخطئ. وليس للمجمع سلطة أن يضع مقالات جديدة للإيمان. لا يمكن للمجامع أن تجعل من الحق الإلهي ما ليس بطبيعته حقًا إلهيًا.”
كانت هذه لحظة حاسمة، فلم يعد لوثر يطعن فقط في صكوك الغفران أو فساد البابوية أو سلطة البابا، بل إنه رفض المجامع المسكونية ما لم تُثبت صحتها من خلال الكتاب المقدس، وهذا الطعن في المجامع صار ركيزة بروتستانتية إلى اليوم.
وقد عزّز لوثر هذا الموقف في اجتماع فورمس عام ١٥٢١م، حين قال عبارته الشهيرة:
“ما لم أُقنع بشهادة الكتاب المقدس أو بحجة عقلية واضحة… فأنا لا أثق بالبابا ولا بالمجامع وحدها”
وإحقاقًا للحق ، فأن حالة التيه الذي ضربت روما بعد الشقاق الكبير مع الشرق الأرثوذوكسي في ١٠٥٤م ، نتح عنها عده مجامع لاتينية (كاثوليكية) تعارض بعضها البعض ، وبعض هذه المجامع كان يتشكل في إطار ترسيخ سلطة الكنيسة الغربية بعد قرون طويلة من الجدال والصراع مع الملكية في الغرب.
فمثلا نجد مجمع كونستانس (١٤١٤–١٤١٨م) الذي عُقد من أجل التوصّل إلى تسوية فعّالة بين البابوية والملوك الغربيين، حيث وافق الملوك على عدم الدفع بنظريات المجمعية الكنسية (ecclesiological conciliarism)، مقابل أن يسمح لهم البابا بالإشراف الفعلي على الكنيسة داخل ممالكهم.
وجدير بالذكر أن لوثر قد استأنف قرار إدانته أمام الإمبراطور الروماني المقدس، وسعى لعقد مجمع كنسي عام ١٥٣٠م للفصل في القضايا اللاهوتية المطروحة، لكن كان اقتراحه هذا قد أصبح بالفعل غير ذات صلة, لأنه -لوثر- كان قد طعن في صحة المجامع من الأساس!
ويمكن أن نرى طلب لوثر لعقد مجمع في إطار “المناورة السياسية” ، لأن لوثر، رغم رفضه لسلطة البابا والمجامع، دعا إلى عقد مجمع كنسي عام، لكن هذه الدعوة لم تكن نابعة من ثقة حقيقية في المجامع، بل كانت “مناورة سياسية” ذكية. فقد أراد أن يكسب الوقت، ويُظهر نفسه بمظهر الباحث عن الحوار، ويمنح الأمراء الألمان مبررًا لدعمه. كانت دعوته للمجمع وسيلة لتحييد خصومه، وكسب الشرعية الشعبية، لا رهانًا لاهوتيًا على نتائج المجامع نفسها لأنه قد سبق وسدد سيفه “الإصلاحي” إلى قلبها ، رافضاً إياها!
ولو كانت النوايا “إصلاحية” خالصة ، لنظر لوثر صوب الشرق متمسكاً بالمجامع المسكونية التي سبقت الشقاق الكبير في ١٠٥٤م ، وفي عودته إلى ما قبل هذا التاريخ المشئوم ، يكون قد رفض التيه والتناقض الكاثوليكي الذي دار الغرب في فلكه منذ القرن الحادي عشر .. لكن النوايا لم تكن “إصلاحية” خالصة!
إذًا، فإن القطيعة العقائدية الكاملة ضد المجامع المسكونية جاءت عام١٥١٩م وتكرّست علنًا في عام ١٥٢١. هذا الرفض الشديد للمجامع مهّد الطريق لمبدأ “الكتاب المقدس وحده” كسلطة عليا في الإيمان.
ولأنه على الباغي تدور الدوائر ، فكان لزاماً على لوثر أن يحصد الثمار المرًة لما زرع من شقاق ، وأن يشرب من ذات الكأس – كأس الفردانية وأوهام الزعامة- التي أسقاها للغرب، وهنا دعونا نقرأ هذا المشهد كما صاغه الأب چوزياه ترينام في كتابه “صخر ورمال”:
«وُلد الإصلاح البروتستانتي في خضم الجدل، وأنجب جدلاً، واستمر في إثارة خلافات لم تُحل طوال الخمسمائة عام الماضية. كانت سنوات لوثر الأخيرة مثقلة بخلافات لم تُحسم. وكان أعظم هذه الخلافات ما وقع في مؤتمر ماربورغ عام ١٥٢٩. فقد كان هذا الاجتماع الرسمي معدًّا لتوحيد اللاهوتيين البروتستانت، لكنه عوضًا عن ذلك أبرز أعمق الانقسامات بين لوثر والمصلح السويسري أولريخ زوينجلي بشأن موضوع الإفخارستيا.
أنكر زوينجلي أن الإفخارستيا هي حقًا جسد ودم يسوع المسيح. بينما اعتقد لوثر أن تعليمه هو -والمعروف في تاريخ اللاهوت بالحضور/التواجد المصاحب (consubstantiation) – هو التعليم الواضح للكتاب المقدس، ولم يستطع أيٌّ منهما أن يفهم لماذا كان الآخر متصلبًا وعاصيًا لـ “التعليم الواضح للكتاب”.
لقد كشف مؤتمر ماربورغ والخلاف البروتستانتي حول الإفخارستيا عن أضعف جوانب تمسّك البروتستانت بعقيدة الكتاب وحده (sola scriptura)، وأظهر عبث أي اعتماد على وضوح الكتاب المقدس من أجل تأسيس عقائد مشتركة. تأثر لوثر بعمق تجاه هذه المسألة، وقال: «قبل أن يكون لي خمر فقط مع الغلاة [ويقصد بالغلاة هنا أولئك البروتستانت، وغالبًا ما يُعرفون باسم تجديديي المعمودية (الأنابابتست)، الذين – مثل زوينجلي – أنكروا أن الإفخارستيا هي جسد ودم المسيح. وهذه العبارة مدمِّرة بالنسبة للبروتستانت الإنجيليين المعاصرين، الذين ينكرون جميعًا أن الإفخارستيا هي جسد ودم المسيح، لأن لوثر نفسه، بطلهم، يتبرأ منهم ويعتبرهم غلاة لا يمكن أن يكون له معهم أي شركة.] فإنني أفضل أن أتناول دمًا صافيًا مع بابا روما».
وقد تبرّأ قادة بروتستانت بارزون مثل كارلشتات، زوينجلي، أويكولامباديوس في بازل، وبوسر في ستراسبورغ من تعليم لوثر بخصوص الأسرار الكنسية ونظام الكنيسة. ونحن المسيحيين الأرثوذكس مدعوون إلى التأمل: أين تكمن حقيقة الكتاب وحده (sola scriptura) ووضوح الكتاب المقدس، إذا كان حتى أولئك المرتبطون بالروابط التعليمية، والصداقة، والسياسة، والإيمان، عاجزون عن الاتفاق على معنى الفعل المركزي في العبادة المسيحية؟» (إنتهى الإقتباس)
أراد لوثر الزعامة ، فأذاق الكنيسة مرارة التقسيم ، وفي سعيه إلى هذه الزعامة لم يقدم إصلاحًا بل زرع بذرة الإنقسام المميتة، وفتح بابًا للتشظّي لم يُغلق منذ ذلك الحين. لم يكن انشقاقه مجرد خلاف لاهوتي، بل كان زلزالًا روحيًا مزّق جسد الكنيسة الجامعة، وأمعن في تشتيت انتباه الغرب بعيداً عن الشرق الأرثوذكسي، حيث لا تزال الأنفاس الليتورجية تتردّد كما في القرون الأولى، وحيث التراث يُحفظ لا يُمزّق.
لقد أدار لوثر ظهره لتاريخٍ من كفاح وتعب القديسين، وقطع الوصل مع آباء الكنيسة الذين صاغوا الإيمان بدمائهم وصلواتهم وصبرهم، فأنجب مسخًا مشوّهًا يُدعى “البروتستانتية”—حركة تتغذّى على الرفض والإنقسام.
لم يكن لوثر مصلحًا كما يُروّج له ، لأن من ثمارهم تعرفونهم ، بل كان غارسا لبذور الشقاق في الغرب، فأنبتت طوائف لا تُحصى، كلٌّ منها يدّعي امتلاك الحقيقة، بينما الحقيقة نفسها تنزف في صمت.


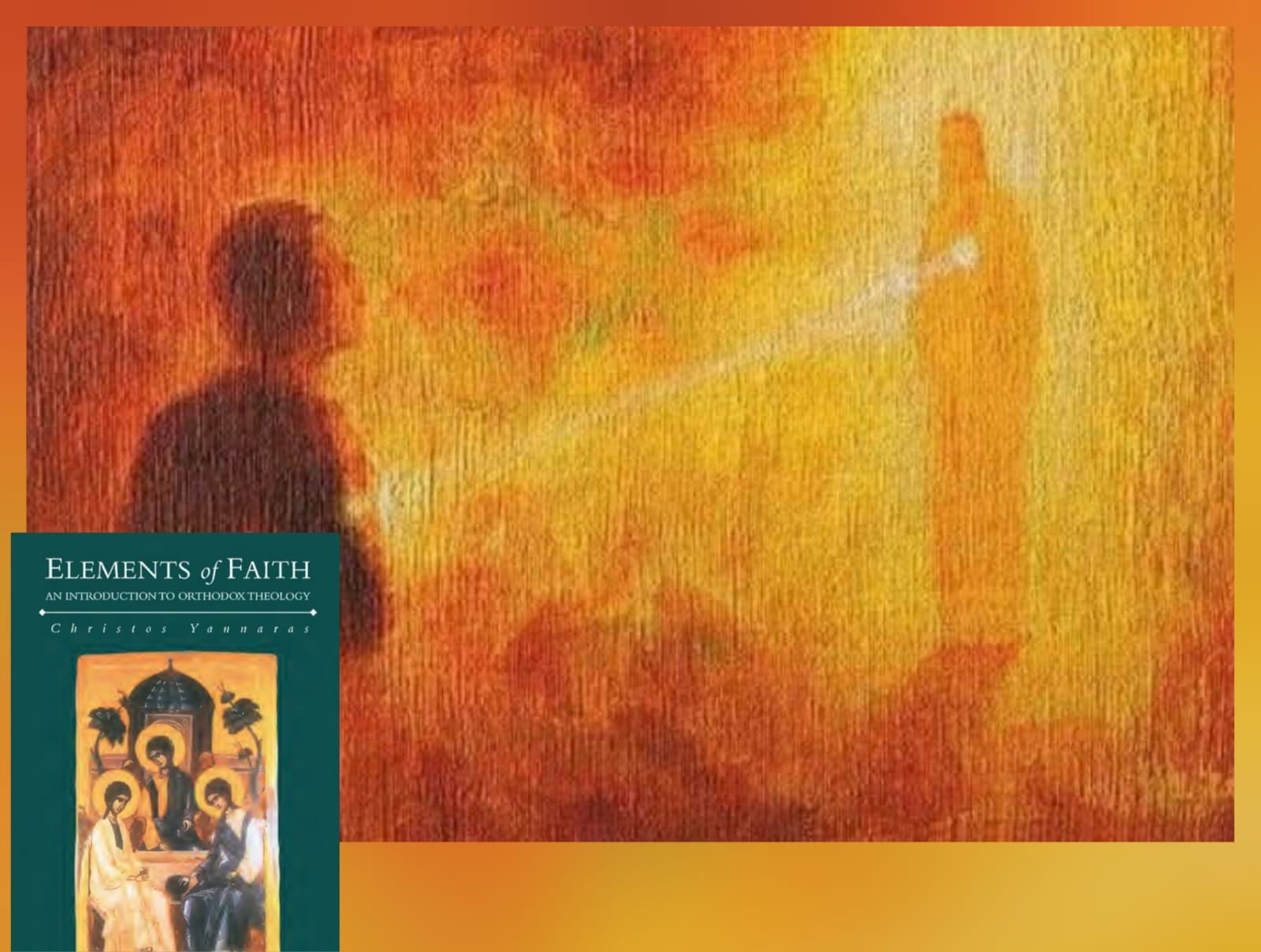

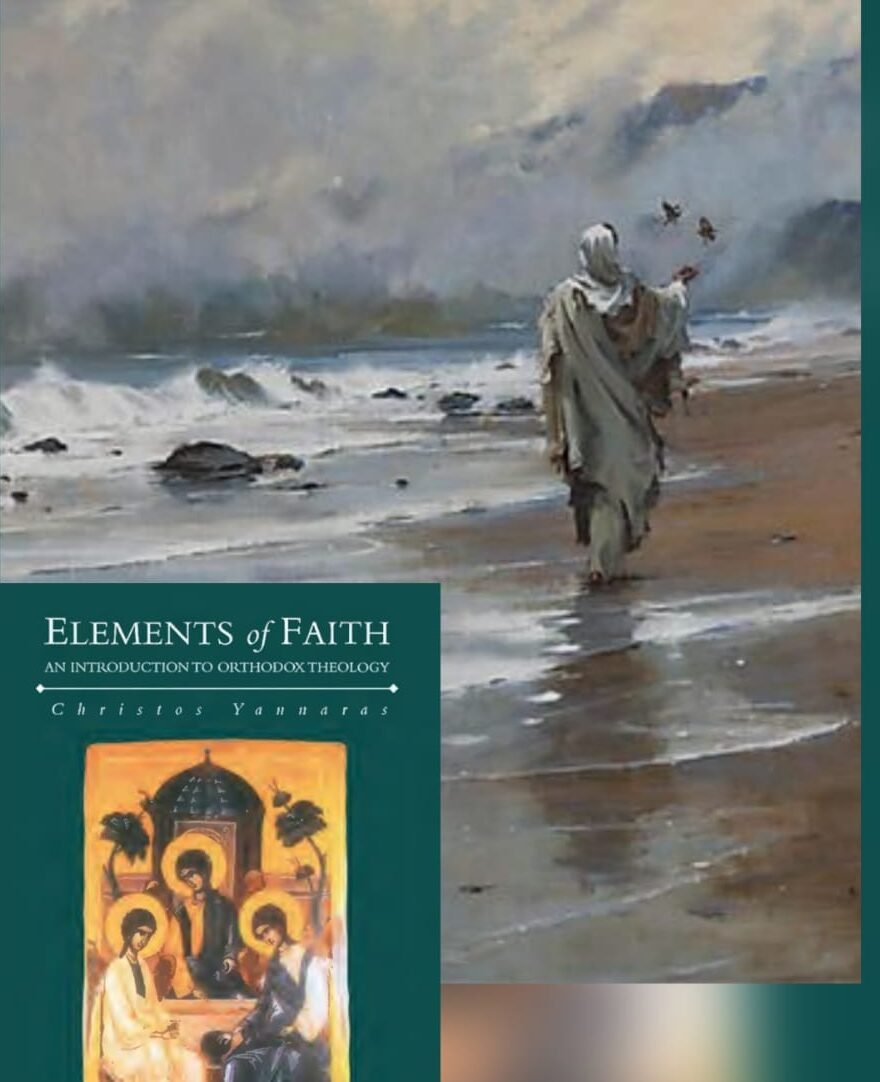

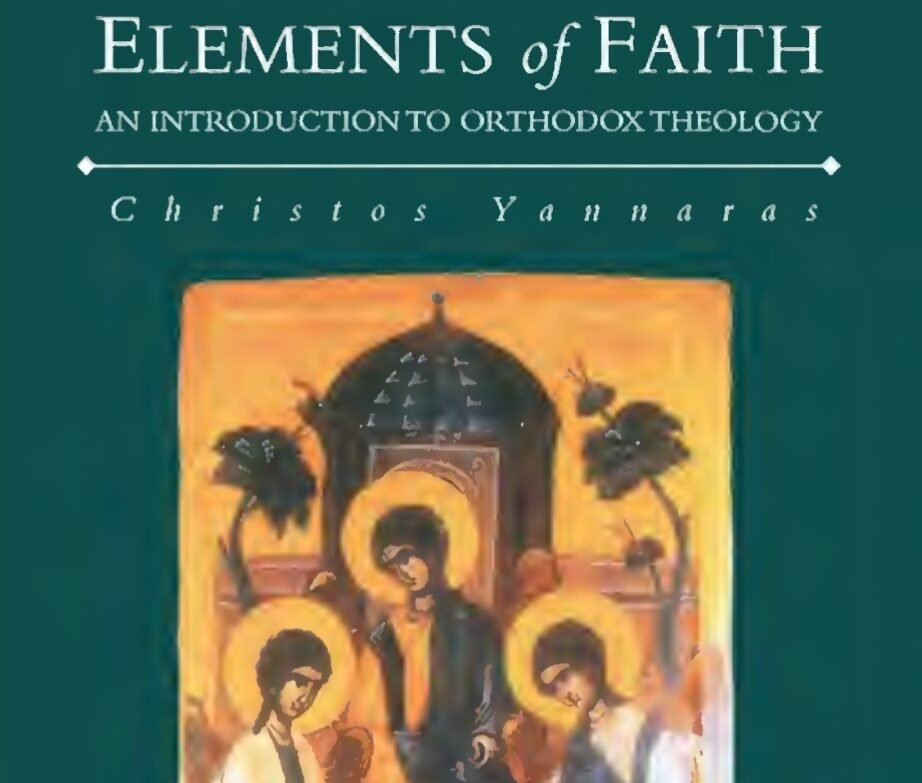

التعليقات
اشرف مدحت
مقال رائع أريد أنا أعرف أكثر عن الأسباب التي أدت لذلك وهل اللاهوتيون البروتستانت يرون أيضا أن لوثر هو مجرد زعيم وليس مصلح
ماجد شوقي
التوجه البروتستانتي العام بيدعم فصل الجانب اللاهوتي للوثر عن الشخصية التاريخية ، وده مقصود بهدف وضعه في هالة المصلح الشجاع.
لكن قراءة لوثر ينبغي أن تتم في سياقه التاريخي والسياسي، فعلى سبيل المثال Divid C. Steinmetz وهو مؤرخ وأكاديمي أمريكي ينتمي للطائفة الميثودية كان بيقدم لوثر كفاعل تاريخي ودي صورة أكثر واقعية وشمولا من سردية البطل اللاهوتي اللي فيها اختزال معيب لجوانب كتير، وديڤيد ستاينمتز كان جريء في ملاحظاته عن عدم وجود اتساق في تطبيق مباديء لوثر زي موقفة المخزي مثلا إبّان ثورة الفلاحين ١٥٢٤ – ١٥٢٥م
وفيه مؤرخين كتير كتبوا عن الازمة دي ، منهم المؤرخ الأمريكي Thomas A. Brady بيقرا لوثر كفاعل سياسي ، وبيربط مواقف لوثر السياسية وخياراته تجاه الفلاحين وتحالفاته الطبقية.
كذلك المؤرخ الألماني Hienz Schilling بيتكلم عن حركة الإصلاح بإعتبارها حركة ذات ابعاد سياسية واضحة.
ومثلا المؤرخة الأسترالية Lyndal Roper بتشوف لوثر كفاعل سياسي كانت خياراته تؤثر على حياة البشر.
لوثر في واقع الأمر كان سياسي بارع ، تحالفاته مع الأمراء الألمان وفرت ليه الحماية والغطاء السياسي ، وفي المقابل كان لوثر يوفر لهم الشرعية الدينية اللازمة في ثورتهم ضد الإمبراطور.
تحالفه مع الأمراء يعني قبوله أن يكون جزءًا من هذا المشروع السياسي.
ممكن حضرتك تطالع هذا المقال اللي بيغطي هذا الجانب.
https://alitheiaorthodoxy.com/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/
تحياتي ، وخالص محبتي.