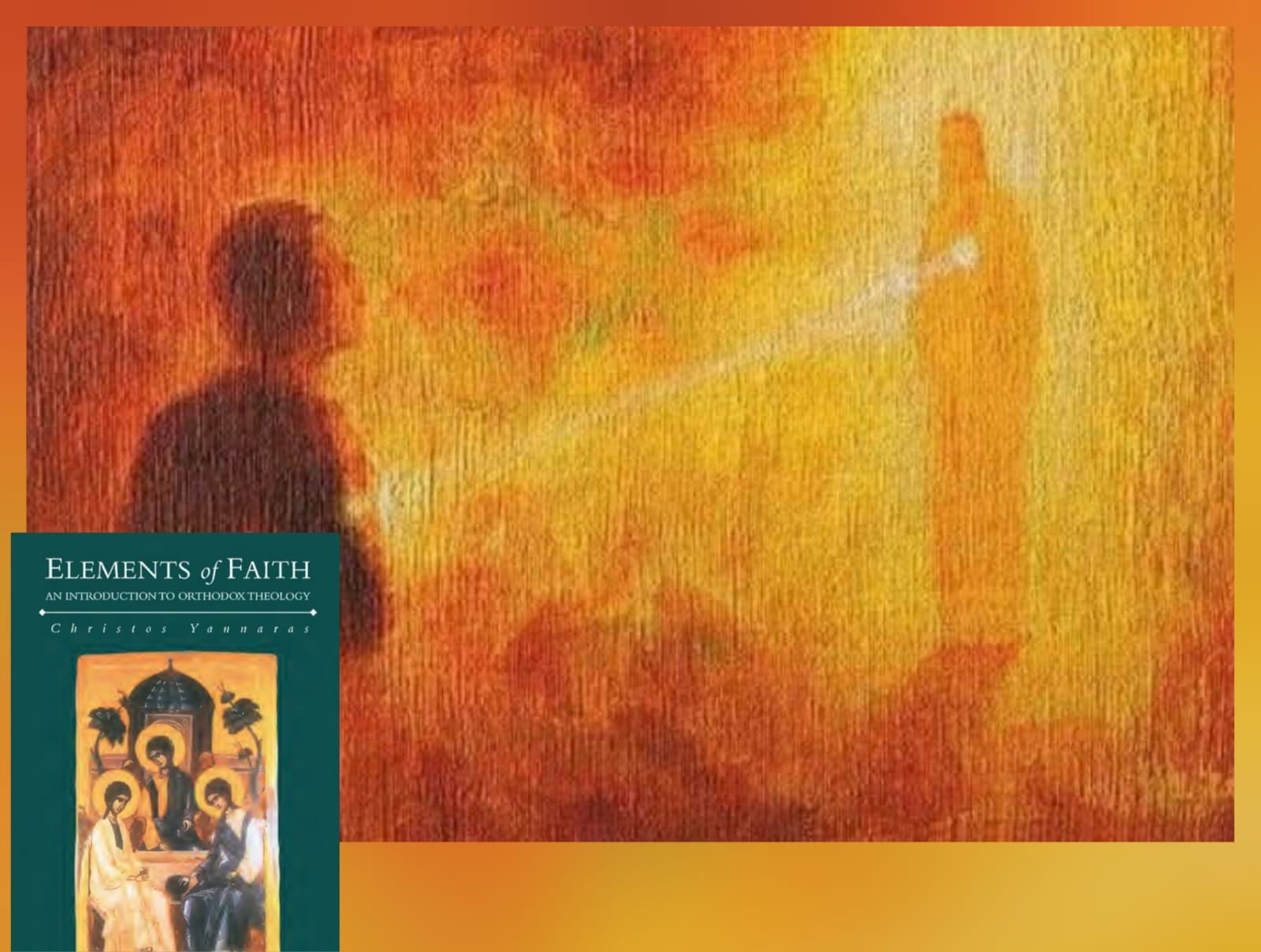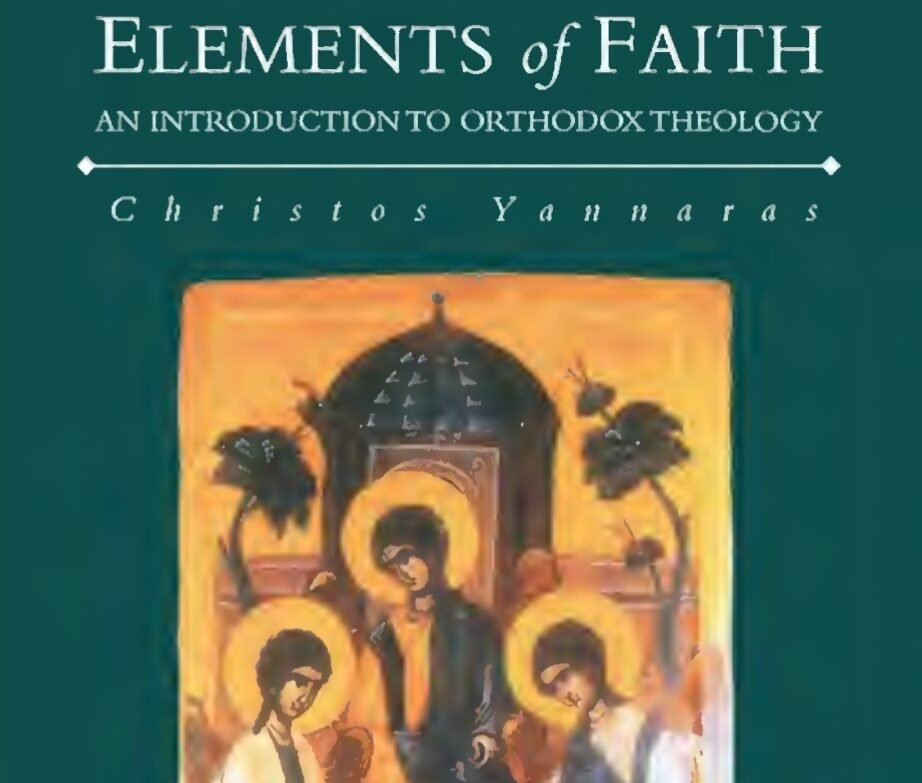مسألة الله
إذا سألنا أنفسنا كيف بدأ الناس يتحدثون عن الله، كيف دخلت هذه المسألة إلى حياتهم، فسوف نجد ثلاث نقاط أساسية ومهمة للانطلاق:
أ. البداية الدينية
الحاجة الدينية هي أول نقطة انطلاق. ففي داخل الإنسان، في “طبيعته”، يمكننا القول، توجد حاجة عفوية للارتباط بشيء يسمو عليه، بوجود أسمى بكثير من وجوده الخاص. وربما تظهر هذه الحاجة من خوف الإنسان أمام القوى الطبيعية التي تشكّل تهديدًا وخطرًا على حياته. يريد أن يسترضي هذه القوى، أن يجعلها لا تؤذيه. والطريق إلى ذلك هو أن ينسب إليها العقل، أن يعتبرها موجودات عاقلة يمكنها أن تسمعه، أن تفهمه، أن تقبل الهدايا التي يقدمها لها كذبائح. وهكذا يرى الإنسان وجودًا عاقلًا، ساميًا، عظيمًا بلا قياس، هو الذي يقذف بالصواعق، ويهيّج البحار، ويهزّ الأرض، ويخصب البذور، ويُبقي الحياة. يسمي هذه القوة “إلهًا”، وغالبًا ما يراها مجزأة؛ فيرى آلهة متعددة في العالم بقدر القوى التي تفرض نفسها عليه.
لا نعرف إن كان هذا هو الدافع الأكثر احتمالًا لبداية الدين. لكننا بالتأكيد نلتقي بمثل هذا المستوى من التدين في المجتمعات البشرية حتى اليوم. إنه تدين (متمركز حول الإنسان): يريد أن يضمن للإنسان ضعفه، أن يُسكت مخاوفه. لذلك لا يقتصر فقط على إيمان ديني بقوى عليا، بل يمنح الإنسان أيضًا سلوكًا محددًا من أجل طمأنينته الأنانية ودفاعه النفسي. إنه يمنحه عبادة ذات أشكال محددة بدقة تضمن له بعض الاتصال مع الإله واسترضائه، كما يمنحه أخلاقًا؛ أي شريعة من الأوامر والواجبات، ما يرضي الله وما لا يرضيه.
إذا اتبع الإنسان هذه الأشكال بانتظام وطبّق بدقة الشريعة الأخلاقية التي تفرضها ديانته، فإنه بالفعل “يملك الله في جيبه”، أي يمكنه أن يطمئن إلى أنه يدير علاقته مع الإله بشكل جيد. لا يخاف العقاب؛ بل على العكس، يتوقع فقط المكافآت والخدمات من الله. وغالبًا ما يكون هذا الشكل من الإنسان الديني متكبّرًا جدًا بتقواه وفضيلته، ويصبح قاسيًا تجاه جميع الناس الذين لا يظهرون إنجازات دينية وأخلاقية مماثلة.
ب. البحث عن الحقيقة
البحث عن الحقيقة والعطش للمعرفة يشكّلان نقطة انطلاق ثانية للعلاقة الإنسانية مع الله. في جميع الحضارات الكبرى التي يعرفها التاريخ، أدى بحث العقل البشري عن توضيح الأسئلة الفلسفية الأساسية إلى نشوء علم اللاهوت، أي “الكلام عن الله”. يقدم اليونانيون القدماء المثال الأكثر وضوحًا وكمالًا لذلك.
في اليونان القديمة، كان الحديث عن الله نتيجة منطقية لملاحظة العالم. عندما نلاحظ العالم، نكتشف أن كل ما هو موجود يتبع سلسلة ونظامًا منطقيًا. لا شيء يحدث بالصدفة أو بشكل اعتباطي. وهكذا نُجبر على قبول أن أصل العالم نفسه يجب أن يكون نتيجة منطقية؛ أي أن العالم نتيجة سبب محدد. هذا السبب الأول أو المبدأ للعالم نسميه الله.
نحن غير قادرين على معرفة ما هو هذا السبب الأول أو المبدأ للعالم. لكن يمكننا أن نستنتج بعقولنا بعض الخواص (الصفات) التي يجب أن تكون له: أن يكون سببًا أول يعني أنه لا يدين بوجوده لشيء سابق عليه، وبالتالي يجب أن نفترض أنه علة ذاته، وسبب كل شيء..
وبما أنه سبب ذاته ولا يعتمد على شيء آخر، يجب أن نعتبره مطلقًا (، حر من كل قيد). وبصفته مطلقًا، يجب أن يكون الله مستقلًا عن الزمن[ازلي-لا زمني] كلي القدرة، غير محدود. يجب أن يكون هو نفسه مبدأ الحركة التي تشكّل “الصيرورة” للعالم والتي تُقاس بالزمن[ يقصد حركة الكون]. لذلك، كمبدأ للحركة، يجب أن يكون هو نفسه غير متحرك بأي شكل، إذ لا شيء يسبق الله ليضعه في حركة [بحسب فلسفة ارسطو]. وكغير متحرك، يكون أيضًا غير متغير، وبالتالي غير قابل للانفعال.
لا تجعل أي من هذه الاستنتاجات وغيرها الكثير التي يمكننا أن نستخلصها بالعقل الله معروفًا لنا، إنها فقط تقنع عقلنا وتُجبرنا على قبول افتراض وجوده كواقع. إنه كما لو أننا نسير في الصحراء ونصادف فجأة بيتًا أمامنا؛ نحن حينها مُجبرون على قبول حقيقة أن أحدًا بناه – فالبيوت لا تنمو ولا تُبنى بنفسها في الصحراء. لكننا لا نعرف من هو المهندس. من خصائص البناء يمكننا أن نفترض بعض الصفات أو الملامح المميزة له، ذوقه الجيد مثلاً، أو مهارته في الإحصاء. لكن وجهه يبقى مجهولًا بالنسبة لنا؛ لم نلتقِ به أبدًا، لا نعرفه. بالتأكيد هو موجود، لكنه غير قابل لمعرفتنا المباشرة.
. العلاقة الشخصية
هناك تقليد تاريخي واحد فقط يحفظ نقطة الانطلاق الثالثة للعلاقة الإنسانية مع الله، وهو تقليد الشعب العبراني.
بدأ العبرانيون يتحدثون عن الله بسبب حدث تاريخي ملموس: قبل نحو ألف وتسعمائة سنة من المسيح، في أرض الكلدانيين (منطقة في أعالي بلاد ما بين النهرين قرب الخليج الفارسي)، كشف الله ذاته لرجل محدد هو إبراهيم. أجاب إبراهيم الله كما نجيب شخصًا بشريًا،يمكننا أن نتحاور معه ونقف أمامه وجهًا لوجه. دعا الله إبراهيم ليستقر في أرض كنعان، لأن هذه الأرض كانت مُهيّأة للشعب الذي سيخرج من نسله – الأبناء الذين ستلدهم سارة، رغم عجزها عن الإنجاب.
المعرفة التي نشأت من لقاء إبراهيم الشخصي بالله لا علاقة لها بالافتراضات النظرية أو القياسات المنطقية أو البراهين العقلية. كانت خبرة علاقة فقط، وككل علاقة حقيقية، تأسست فقط على الإيمان أو الثقة التي تولد بين الذين هم في علاقة مع بعضهم البعض. أثبت الله ألوهيته لإبراهيم فقط بأمانته لوعوده. وإبراهيم وثق بالله إلى حد الاستعداد للتضحية بالابن الذي أعطته له سارة في شيخوختها – هذا الابن الذي كان شرطًا مسبقًا لتحقيق وعود الله.
إسحق ويعقوب، ابن وحفيد إبراهيم، امتلكا نفس المعرفة بالله من خلال خبرة مباشرة لعلاقة شخصية معه. لذلك، بالنسبة لنسل العائلة التي خرج منها شعب إسرائيل، لم يكن الله مفهومًا مجردًا ولا قوة غير شخصية. عندما يتحدث العبرانيون عن الله، يقولون: “إله آبائنا”. إنه “إله إبراهيم وإسحق ويعقوب”، شخص حقيقي عرفه أجدادهم وتعاملوا معه. تقوم معرفة الله على الإيمان والثقة بشهادات الآباء، وعلى مصداقية خبرتهم.

د. اختيار الهدف والطريق
هذه النقاط الثلاث لانطلاق العلاقة مع الله لا تنتمي حصريًا إلى الماضي. إنها موجودة كإمكانيات حقيقية في كل زمان ومكان. هناك دائمًا أناس يقبلون وجود الله، دون أن يهتموا كثيرًا بحقيقته أو بالمشكلات النظرية التي يثيرها. يقبلونه فقط كحاجة نفسية للارتباط بشيء “متسامٍ”، كحاجة لأمنهم الفردي أمام المجهول، وكحاجة لسلطة ولحفظ نظام أخلاقي في العالم.
وبالمثل، هناك دائمًا أناس يقبلون وجود الله فقط لأن منطقهم يُجبرهم على ذلك. يؤمنون، كما يقولون، بـ “قوة عليا”، “كائن أسمى” خلق كل ما هو موجود ويحفظه. لكنهم لا يعرفون، وربما لا يهتمون، بماهية هذه “القوة العليا” أو “الكائن الأسمى” بالضبط. وحتى إن جمعوا يقينهم العقلي البسيط مع بعض العادات “الدينية” – بانسجامهم مع الأشكال الطقسية والواجبات الأخلاقية للدين السائد في بيئتهم الاجتماعية – يبقى في داخلهم شك عميق لا يتوافق إلا مع الفكرة العامة والمجردة عن “الكائن الأسمى”.
أما الشكل الثالث للعلاقة مع الله فهو أيضًا موجود: الإيمان والثقة في الخبرة التاريخية لإعلانه. “أبناء إبراهيم”، شعب إسرائيل، واصلوا عبر القرون موقف قبول حقيقة الله، لا بمعايير عاطفية أو عقلية، بل فقط بيقين مصداقية آبائهم. أثبت الله وجوده بتدخلاته في التاريخ، مؤكّدًا حضوره دائمًا في إطار العلاقة الشخصية. كشف ذاته لموسى وتحدث معه “وجهًا لوجه، كما يتحدث الإنسان مع صديقه” (خروج 33:11). دعا الأنبياء وجنّدهم في عمل تذكير الشعب بالوعود التي يبقى الله أمينًا لها دائمًا.
وليس من الصعب على الذين يثقون بالخبرة التاريخية لإعلانات الله أن يقبلوا تدخله مرة أخرى في حياة البشر، هذه المرة “في الجسد”، في شخص يسوع المسيح. وبالتأكيد، بالنسبة للفكر العقلاني، فإن مفهومي الألوهية والتجسد متناقضان، الواحد ينفي الآخر. ليس مفهومًا أن الله، الذي بطبيعته يجب أن يكون غير محدود، كلي القدرة، غير متناهٍ، أن يوجد ككائن بشري محدود خاضع لقيود المكان والزمان. لذلك، بالنسبة لليونانيين في زمن المسيح، كان إعلان إنسانية الله حقًا “حماقة” (1 كورنثوس 1:23).
لكن، لكي يقبل الإنسان أو يرفض هذه “الحماقة”، عليه أن يكون قد أجاب عن أسئلة أساسية تحدد بشكل عام معنى ومحتوى الحياة التي يعطيها لها: هل كل ما هو موجود مقدر سلفاً ويجب ان يوجد وفقاً للمنطق البشري.. حيث لا مكان للمعضلات الفكرية او الحيرة الوجودية؟ ام ان الوجود، حدث يتجاوز التقديرات المسبقة وانماط الفكر البشري، ما هو الموجود حقاً؟ هل هو ما تدركه حواسنا فقط، او ما يقبله المنطق الخاص بنا ؟
ام ان هناك حقائق تتجاوز إدراكنا الحسي، تتجاوز منطقنا البشري، نستعلنها فقط في إطار علاقة اكثر شمولاً ومباشرة
ثم هل تسمح لنا هذه العلاقة بإدراك معني [سري] خلف الكلمات ، هل هذه العلاقة تجعلنا نفهم ما وراء الرمز ، او ما يشير اليه؟ هل هذه العلاقة تفسر لنا غاية وجودنا، هل تكشف لنا هويتنا الذاتية الحقيقة؟ وتجعلنا نكشف الفرادة الشخصية غير المعبر عنها لكل إنسان!..
هذه الأسئلة تستحق دراسة أعمق وتحليلًا مفصلًا، لكنها ستأخذنا بعيدًا عن الموضوع الأساسي الذي يشغلنا. هنا يجب أن نميز بصورة رئيسية الطرق والمسارات التي سنتبعها لمعرفة الله. إذا أردنا أن نعرف المفهوم المجرد لله الذي يفرضه المنطق، يجب أن نتبع بدقة قواعد المنطق. وإذا أردنا أن نعرف إله علم نفس الدين والعواطف، يجب أن نزرع في داخلنا الدوافع النفسية والدينية لهذه المعرفة. وإذا أردنا أن نعرف إله التقليد اليهودي-المسيحي، يجب أن نتبع طريق العلاقة الشخصية والخبرة، طريق الإيمان. أما محاولة الجمع بين هذه الطرق المختلفة للمعرفة فهي الطريق الأكيد إلى الالتباس والمأزق.