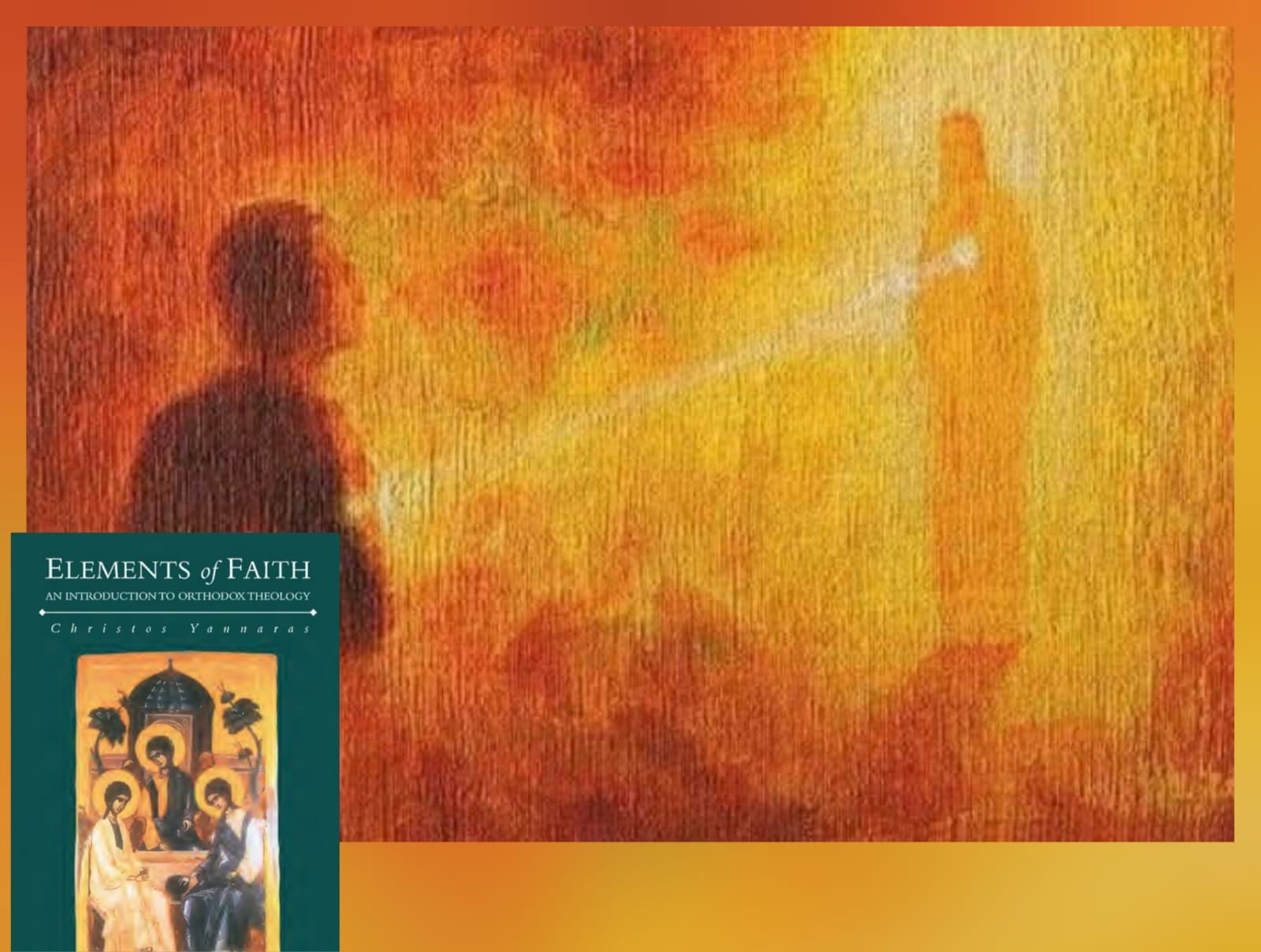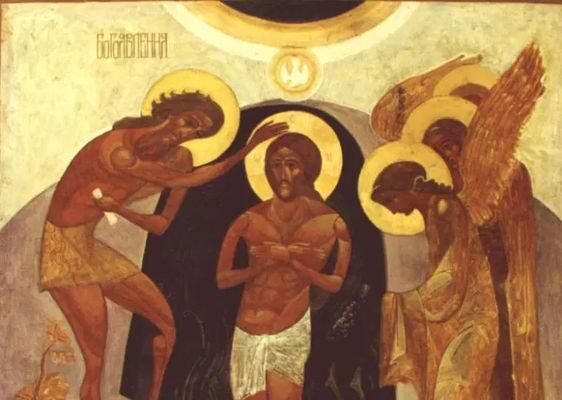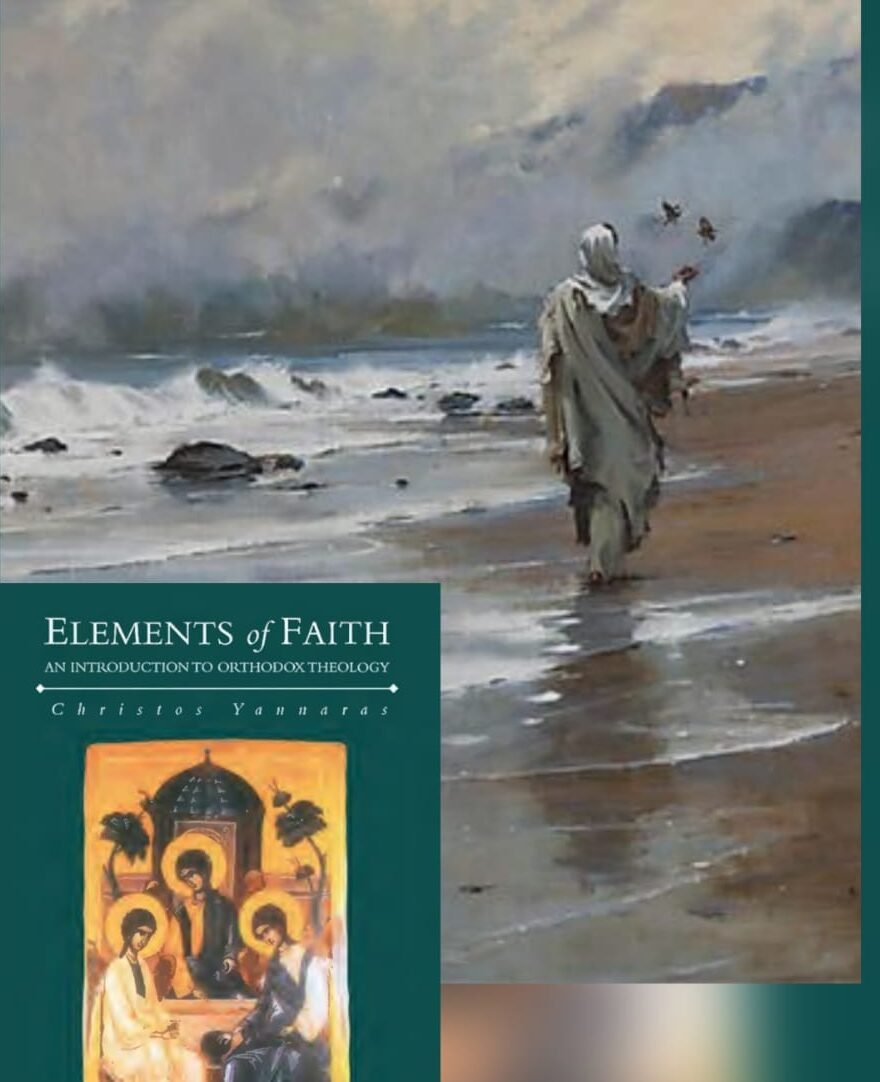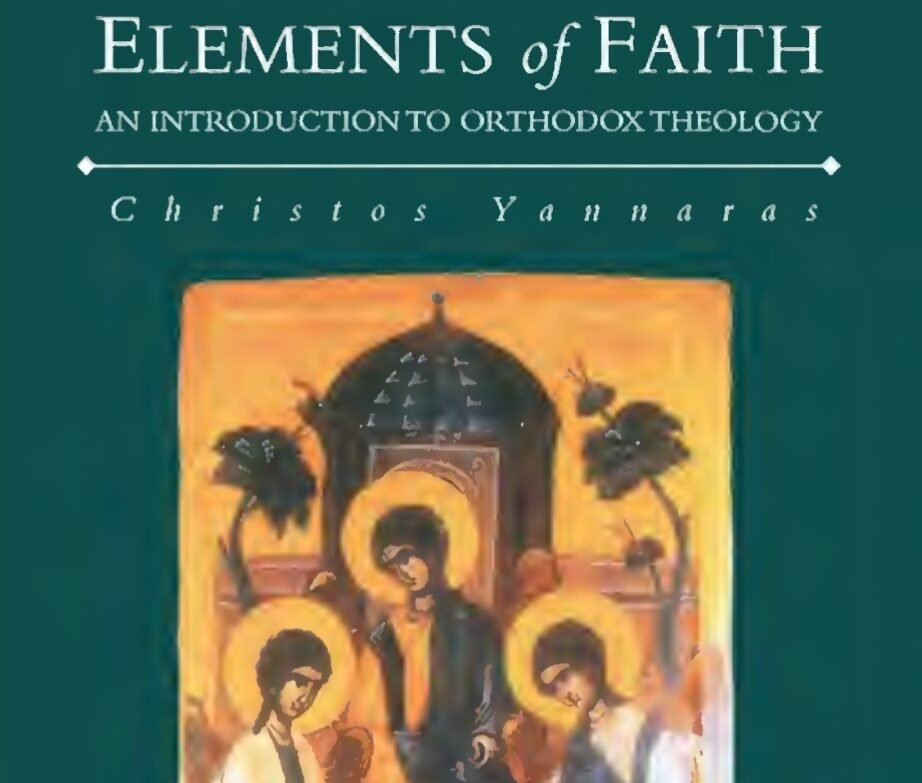مقدمة تاريخية
وُلد القدّيس نيقولاوس كباسيلاس قرابة سنة 1322م من أسرةٍ نبيلة في المدينة العتيقة تسالونيكي، وهي ثاني حواضر الإمبراطوريّة الرومانيّة المسيحيّة. وقد امتدّت حياته في عصرٍ شهد أفول السطوة البيزنطيّة في المشرق رويدًا رويدًا، إذ تناوحتها الحروب الأهليّة، والخصومات الدينيّة، والتهديدات الدائمة بالغزو، فتضافرت هذه العوامل على إلقاء الإمبراطوريّة في أتون اضطرابٍ لم تفق منه قط، واستنزفتها حتى أضحى زوال ما تبقّى من قوّتها أمرًا محتومًا.
ومع ذلك، فإنه في خضمّ تلك الصراعات المستعرة على العرش الإمبراطوري، والمجادلات السياسيّة — الدينيّة الضارية التي خاضها “الغيورون”، شهد ذلك العصر أيضًا إبداعًا فكريًّا وروحيًّا فذًّا، لا سيّما في ميدان الجدال اللاهوتي الذي احتدم فيما عُرف بـ “الخلاف البالامي” أو “النزاع الهدوئي” في القرن الرابع عشر.
وعلى خلفيّة هذا الاضطراب السياسي والروحي، يزداد بروز شخصيّة نيقولاوس كباسيلاس بهاءً وجلالًا؛ إذ كان، بعبارة عصرنا، “رجلًا نهضويًّا” بكل ما للكلمة من معنى. فقد كان هدويًّا في مسلكه، وتلقّى علومه الأولى في مسقط رأسه تسالونيكي على يد خاله الشهير نيلوس[1] — الذي تولّى منصب متروبوليت تسالونيكي بين سنتي 1361 و1363 — كما درس إلى جانب ديميتريوس كيدونيس الذي ترجم لاحقًا بعض مصنّفات توما الأكويني إلى اليونانية.
ومن سنة 1335 إلى سنة 1340 تابع كباسيلاس دراسته في القسطنطينية، فنهل من ينابيع فقه اللغة، والفلسفة، واللاهوت، ولم يقف عندها، بل ولع كذلك بفنون البلاغة والقانون والفلك والرياضيات.
وبحكم أصله النبيل وتربيته المترفة، كان كباسيلاس يتردّد على أرقى الأوساط وأكثرها نفوذًا في زمانه. ويبدو أنه، حتى سنة 1335، كان على صلة وثيقة بإسيدور الأوّل بوشيراس — أحد أعلام الهدويّين في عصره، والبطريرك المسكوني منذ سنة 1347 — الذي يُظَنّ أنّه كان أباه الروحي. وقد تلقّى إسيدور، بدوره، علومه عن القدّيس غريغوريوس السينائي (نحو 1265 – 1346)، ثم ترهّب على يد القدّيس غريغوريوس بالاماس (نحو 1296 – 1359).
وفي نحو سنة 1350، تميّز كباسيلاس بصفته موظّفًا في الدولة، ودبلوماسيًّا، ورجلَ بلاط، في حاشية يوحنّا السادس قنطقوزينوس (1347 – 1354)، إلى جانب زميله القديم ديميتريوس كيدونيس. ونجد له أثرًا في عملٍ رسميّ رافق فيه البلاماس — الذي كان قد انتُخب متروبوليتًا على تسالونيكي — إلى أبواب المدينة الخارجيّة، ثم إلى جبل آثوس حينما منعه “الغيورون” من دخولها. وفي سنتي 1353 أو 1354، برز اسمه مرشّحًا لمنصب البطريرك. وأمّا أواخر حياته، فما زالت غامضة المعالم، وإن كانت الرأي السائد اليوم يرفض القول بأنّه تولّى يومًا كرسيّ متروبوليت تسالونيكي.
وممّا لا جدال فيه أنّ كباسيلاس، سواء في مجال العلم أو الدبلوماسيّة أو اللاهوت، كان رجلًا نادر المثال عظيم الموهبة. وأشهر ما وصل إلينا من تراثه عملان جليلان: كتابه “عن الحياة في المسيح”، و”تفسير الليتورجيا الإلهية”؛ وقد استحقّ هذان الكتابات أن يُعَدّا من عيون اللاهوت المستيكي المسيحي، بما يحملانه من طابع مسيحيّ متمحور حول المسيح والأسرار المقدّسة، وبلغةٍ رصينة فخمة لا تُجارى، حتّى عُدّ كباسيلاس من أعظم الشهود على سرّ المعموديّة والميرون، ولا سيّما الإفخارستيّا الإلهيّة.
عظات كباسيلاس عن والدة الإله
وممّا لا يعرفه كثيرون أنّ كباسيلاس ألّف أكثر من العملين الشهيرين السابق ذكرهما. ومن بين آثاره الأقلّ ذيوعًا ثلاث عظات عن “ميلاد والدة الإله” و”البشارة” و”رقاد والدة الإله”، تتجلّى فيها العبقريّة ذاتها التي أشرقت في كتاب “عن الحياة في المسيح” و”تفسير الليتورجيا الإلهية”، وهي التي تقوم عليها دراستنا هذه.
وغاية هذه الدراسة النظر في الدعوى التي أطلقها أوّلًا الباحث مارتين جوجي Matrin Jugie —الذي ندين له بجميل نشر نصوص هذه العظات الثلاث— ومفادها أنّ تعليم كباسيلاس عن براءة والدة الإله وطهارتها يوافق العقيدة اللاتينيّة في “الحبل بلا دنس” Immaculata Conceptio، التي أعلنها البابا بيوس التاسع سنة 1854، والقاضية بأنّ العذراء المباركة مريم قد أُعفيت من الخطيئة الجَدّيّة منذ اللحظة الأولى التي حُبل بها في بطن أمّها القدّيسة حنّة.
على أنّ عقيدة الحبل بلا دنس إنّما نشأت في الغرب في القرن الثامن كرأي لاهوتي، ثمّ أيّدها الفرنسيسكان بحماسة في القرون الوسطى، ولا سيّما في القرن الثالث عشر، مع أنّها لقيت رفضًا قاطعًا من أعلام كبار مثل برنارد الكليرفوي Bernard of Clairvaux (نحو 1090 – 1153)، وألبرت الكبير Albert the Great (نحو 1200 — 1280)، وبونافنتورا Bonaventure (نحو 1217 – 1274)، والرهبنة الدومينيكانيّة وفي طليعتها توما الأكويني Thomas Aquinas شخصيًا (نحو 1225 – 1274). فالتقليد المدرسي Scholastic tradition في ذلك العصر كان يرى أنّ والدة الإله قد حُبل بها في الخطيئة الأصلية[2]، ثمّ طُهّرت منها وهي بعدُ في بطن أمّها[3].
غير أنّه يُلحَظ أنّه في الشرق أيضًا، في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، ظهر مثال المطران إسيدور غلاباس Isidore Glabas (نحو 1341 – 1396)، مطران تسالونيكي في ولايتين (1380 – 1384 و1386 – 1396)، الذي يبدو أنّه وعظ بأنّ والدة الإله قد أُعفيت من الخطيئة الجدّيّة عند الحبل بها. ففي عظته عن “دخول الدائمة البتوليّة مريم إلى قدس الأقداس”، يلمّح إسيدور إلى أنّ قول المزمور: “هأنذا بالإثم حُبل بي، وبالخطيئة ولدتني أمي” (مز 5:51) لا ينطبق على والدة الإله، وأنّ إعفاءها من ذلك إنّما يُعزى إلى “العظائم” التي “صنعها لي القدير” (لو 49:1).
من هنا، تسعى هذه الدراسة إلى إثبات أنّه، وإن بدا في بعض المواطن أنّ كباسيلاس يجنح إلى مثل هذه الآراء، فإنّ التأمّل المتأنّي في تعليمه عن والدة الإله يُظهر بجلاء أنّه يسلك مسلكًا مغايرًا، يقوم على افتراضات مبدئيّة مباينة لتلك التي انطلق منها سائر اللاهوتيّين الغربيّين المذكورين آنفًا.
أولًا، إذن، يتحدث كباسيلاس عن يواقيم وحنة لا كـ “أداة” محضة لله فحسب، بل كـ “شريكين” معه في عمله، مشاركين Synergia فعليًا في التدبير الإلهي، أي في عمل الله الخلاصي. فمن بين جميع أبرار العهد القديم — موسى ونوح وإبراهيم وغيرهم — الذين من خلالهم جاءت نِعَم عظيمة إلى الجنس البشري، لا يقارن أحد، كما يُدلل كباسيلاس، بصلاح والدي الدائمة البتولية، اللذان كانا أكمل حافظي الناموس، وبالتالي أحبَّاء الله الأعزَّاء.
لذا يمدح كباسيلاس يواقيم وحنة على فضيلتهما العظيمة، التي تجلَّت من خلال تآزرهما أو تعاونهما مع الله. ومخاطبًا إياهما مباشرة، يقول: “إنَّ ميلاد مريم كان ميلادًا طبيعيًا حقيقةً، وإن لم يكن ميلادًا بسيطًا من جهة الطبيعة؛ إذ كان ميلاد والدة الإله أيضًا ثمرة صلاتهما وصلاحهما. أما الطبيعة، فقد كانت ممثلةً في شيخوخة الجدَّين القديسين وعقمهما، لكن أيًا منهما لم يكن عقيمًا في الفضيلة؛ إذ كان بفضيلة القديسين يواقيم وحنة، التي أعطت قوةً لصلاتهما، أذن الله بحدوث مثل هذه المعجزة. ويبرِّر كباسيلاس عظيم نعمتهما أمام الله بثمرتهما التي أثمرتاها (انظر متى 7: 16)، أي والدة الإله، التي تكشف عظمتها أيضًا عن عظمة فضيلتهما. ويضيف كباسيلاس أنَّ هذا يجب أن يكون كذلك بالضرورة، إذ «من المستحيل أن يكون الله محابيًا للأشخاص».
من هنا، وإن كان ميلاد العذراء القديسة قابلًا للوصف بأنه «فوق الطبيعي» بل وحتى «إلهي»[4]، إلا أنَّه لم يُوصف بأنه «بتوليًا» أو «عذراويًا». وهذا يبدو متَّفقًا تمامًا مع الإجماع الآبائي الأقدم، الذي يلخِّصه صرخة يوحنا الدمشقي البلاغية: «يا أحشاء يواقيم المباركة جدًّا، التي منها خرجت بذرة لا عيب فيها» و«أنتِ (أي والدة الإله) منَّا (أي من آدم وحواء) ورثتِ جسدًا قابلًا للفساد». وقول أثناسيوس الكبير (حوالي 296 – 373): «مريم أختنا؛ إذ إننا جميعًا من آدم». لذا، فإنَّ والدة الإله، مثل باقي البشرية، ورثت الخطيئة الأصلية، لأنَّها وُلدت من بذرة يواقيم. ونرى أنَّ كباسيلاس إنَّما يُعيد التأكيد على هذه العقيدة الأساسية في عبارات مثل «من بشرٍ انبثقت»، و«كانت مشاركةً في كلِّ الخصائص المميزة للجنس البشري».
وفي الوقت نفسه، مع عبارات مثل «لم ترث نفس الإطار الذهني، ولم تُغَرّْ بشرور الحياةِ الجسيمة، بل انتصرت على الخطيئة»، يبرز كباسيلاس أيضًا غياب “الخطايا الشخصية”، التي هي نتيجة العمل الإرادي للخطيئة الأصلية: إذ يؤكِّد أنَّ العذراء القديسة وحدها من بين كلِّ البشر لم تحول الإمكانية للخطيئة potential to sin إلى عمل واقعي actual operation. وهذا يعزوه إلى ثبات إرادة العذراء القديسة.
لقد سبق ورُمِزَ لوالدة الإله بـ”قدس الأقداس”، «المكان» الذي هو «حضور الله»: «إنَّ قدس الأقداس»، يصرُّ كباسيلاس، «يشير بالتأكيد إلى الأقدس جدًّا الدائمة البتولية»؛ وأنَّها سُمح لها بدخول ذلك المكان المقدَّس — مكان يدخله رئيس الكهنة وحده مرَّةً في السنة (انظر عب 9: 7) — يجب أن يكون بالتأكيد علامةً على أنَّها كانت خاليةً تمامًا من كلِّ شرٍّ. ومرةً أخرى، يمكن العثور على أوجه تشابه عند يوحنا الدمشقي (حوالي 675 – 749)، الذي يعلِّم أنَّ ثمرة فضيلة مريم وقداستها تبدأ بدخولها الهيكل، وأنَّها هناك «أصبحت مستقرًّا لكلِّ فضيلة».
هنا، من الانصاف أن يُقال: إنَّ كاباسيلاس يبدو محتضناً موقفاً أكثر تطرفاً. إذ يؤكِّد أنَّه في شخص والدة الإله نرى لأوَّل مرَّة تجلِّي القوَّة المغروسة في الإنسان من قبل الله لمقاومة الشرِّ. بل إنَّ كاباسيلاس يُدلل أيضاً على أنَّ الناموس الموسوي لم يكن قابلاً للحفظ فحسب — كما يشهد بذلك أبرار العهد القديم — بل إنَّ الثيوتوكوس هي الشخص الأوَّل الذي حفظه فعلاً في كماله التامِّ. هي وحدها عاشت كما أراد الله للإنسان أن يعيش؛ هي وحدها كشفت الطبيعة البشرية كما قصد الخالق أصلاً أن تكون.
وفي مكان آخر، يُبدي كاباسيلاس ما يبدو للوهلة الأولى تأكيداً جريئاً مذهلاً، وهو أنَّ «هي نفسها {والدة الإله} أبادت العداوة التي كانت قائمةً في الطبيعة البشرية ضدَّ الله، وفتحت السماء، وجذبت النعمة، وتلقَّت القوَّة للجهاد ضدَّ الخطيئة». غير أنَّه حتى هنا، كما يشير نيلاس، ينبغي ألا يُخدع المرء بظنِّ أنَّ كاباسيلاس يدَّعي أنَّ جهاد الدائمة البتولية ضدَّ الخطيئة لم يتطلَّب معونة الله — هذا سيكون تفسيراً خاطئا، كما تدلُّ الكلمات «وتلقَّت القوَّة للجهاد ضدَّ الخطيئة» — بل إنَّها لم تتلقَّ أيَّ معونة إلهية إضافية خاصَّة. «وبالتالي، فإنَّ المعونة التي أعان بها أمَّه ليست أعظم بأيِّ وجه من تلك التي منحها لجميع البشر». لذا، تكمن عظمة والدة الإله تحديداً في أنَّها لا تختلف عنَّا البتَّة.
الله، كما يفسِّر كاباسيلاس، كان ينتظر ظهور الطبيعة الحقيقية للإنسان ليتحَّد بها؛ وكانت العذراء القديسة هي التي قدَّمتها له نقيَّةً طاهرةً لا دنس فيها. ولذلك أيضاً، ينسب كاباسيلاس إلى الثيوتوكوس العبارة: «صائرةً {لله} الأكثر ملاءمة كشريكةً أعمال». ولذلك، هي وحدها على مرِّ التاريخ كلِّه، استحقَّت أن تسمع التحيَّة: «افرحي!».
هنا، عند هذه النقطة، يدلي كباسيلاس بأجرأ تصريح له. ففي عظته عن «البشارة» يُصرّ على أن «لا ذِكر في البشارة المفرحة التي جاء بها الملاك عن خلاصٍ من الذنبِ أو مغفرةٍ للخطايا»[5]. إلا أن هذا الرأي يبدو متعارضًا مع التقليد الآبائي. فمثلًا، يُعلّم كلٌ من القديس كيرلس الأورشليمي (315 — 386) والقديس غريغوريوس النزينزي (329 — 389) أن الروح القدس طهّر والدة الإله أثناء البشارةِ. ويكتب القديس يوحنا الدمشقي قولاً واضحًا: «فبعد أن قبلت العذراء القديسة {البشارة}، حلّ عليها الروح القدس حسب قول الرب الذي قاله الملاك، مطهّرًا[6] إياها ومعطيًا لها القوة لتقبل وتلد كلمة الله».
مع ذلك، وبَينما كان كباسيلاس مدركًا تمامًا لما قاله الآباء في هذا الشأن، فسّر إشاراتهم إلى «تنقية» العذراء القديسة على أنها دلالة على «إضافة نعمة». وعندما تسأل مريم: «كيف يكون لي هذا؟» (لوقا 34:1)، فإنها لا تسأل لأنها في حاجة إلى تنقية إضافية، بل لأن الأمور التي تحدث عنها رئيس الملائكة تتعارض مع قوانين الطبيعة. ومن هنا، نرى أن مفهوم كباسيلاس لكمال العذراء القديسة يميل نحو الكمال المطلق والطهارة الكاملة للوالدة الإلهية حتى قبل لحظة «التبشير».
غير أن هذا ليس الحال عند القديس باسيليوس الكبير (330 – 379)، الذي يقدم مثالًا على نقص الكمال في العذراء القديسة؛ إذ يربط باسيليوس بين «السيف» الذي تنبأ به سمعان الشيخ، والذي سيخترق نفس العذراء القديسة (راجع لوقا 35:2)، وبين الشكوك والمخاوف التي انتابتها في بداية مهمة ابنها وأثناء صلبه[7] أيضًا.
في تفسير القديس يوحنا ذهبي الفم لمتى 46:12-50، يُحلّل ظواهر النقص والضعف الإنساني في شخصية العذراء القديسة وأخوة المسيح. فعندما يبحث في سبب رغبة والدة المسيح وأخوته في رؤيته في تلك اللحظة المحددة — «بينما كان يتكلم إلى الشعب» — يعزو ذهبي الفم (347 – 407) هذا إلى نوع من المجد الباطل لديهم. ويواصل ذهبي الفم عظته مؤكدًا أن أمومة العذراء الإلهية لن تكون ذات قيمة بدون كونها فاضلة[8].
على النقيض من ذلك، يختلف تفسير كباسيلاس لهذا الحدث ذاته اختلافًا جوهريًا عن تفسير ذهبي الفم. إذ يرى أن المسيح هنا يشير إلى عظمة أمه، وأن عبارة «هؤلاء الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها» (لوقا 21:8) تخص العذراء الدائمة البتولية فقط، التي هي مقياس كل فضيلة. وبناءً عليه، فإن الغرض الرئيسي من كلمات المسيح، حسب كباسيلاس، كان تمجيد أمه[9].
وأخيرًا، يشير كباسيلاس، في حديثه عن العلاقة الوثيقة جدًا بين العذراء القديسة والمسيح، إلى ما يبدو تصريحًا جريئًا ومقدامًا آخر: «لقد صارت مساوية له في الاحترام (homotimos) مشاركةً إياه ذات العرش (homothronos) وواحدة مع الله (homotheos)». ويقول كباسيلاس: “إن دمها صار دمه؛ دم الإله المتجسّد. والأهم من ذلك، أن والدة الإله تقف كأول مخلوقٍ يُدرك تمامًا القداسة المحتملة التي دُعينا إليها جميعًا.”. وكما يقول فلاديمير لوسكي: «جنبًا إلى جنب مع أقنوم الإله المتجسّد هناك أقنوم بشري متألّه».
وقد قيل بحق إن علم «المريولوجي» هو ببساطة امتداد لعلم «الكريستولوجي». والمسألة الجوهرية في كل قضية طهارة والدة الإله يجب أن تكون الحفاظ على تفرد طهارة المسيح. فإن عمل المسيح الخلاصي سيُشوّه أو يُلغى كليةً لو قبلنا أن شخصًا آخر يفي بشروط الطهارة؛ أي لو قبلنا أن الدائمة البتولية وُلدت خالية من الخطيئة الأصلية (الحبل بلا دنس)، فهذا سيعزلها تلقائيًا عن بقية البشر ويضعها في فئة أخرى — فئة الإلوهة — الفئة التي ينتمي إليها المسيح منفردًا بصفته الإله-الإنسان، بحكم حمله وولادته من الروح القدس ومن العذراء مريم.
والفهم الأرثوذكسي لهذه المسألة عبّر عنه فلاديمير لوسكي ببلاغة: «لا تقبل الكنيسة الأرثوذكسية فكرة أن العذراء القديسة قد اُستثنيت هكذا من مصير بقية الإنسانية الساقطة؛ أي تلك الفكرة بوجود “امتياز” يجعلها كائنًا مُفدى قبل عمل الفداء، بفضل استحقاقات ابنها المستقبلية. ليس بفضل امتياز … نكرّم والدة الإله أكثر من أي مخلوق آخر … فهي لم تكن في لحظة البشارة في حالة مماثلة لحالة حواء قبل السقوط… إن حواء الثانية — التي اختيرت لتكون والدة الإله — سمعت وفهمت الكلمة الملائكية في حالة الإنسانية الساقطة. ولهذا فإن هذا الانتخاب الفريد لا يفصلها عن بقية البشرية … سواء كانوا قديسين أو خطاة، الذين تمثل (هي) أفضل جزء منهم».
أما القضية الثانوية هنا فهي تحديد اللحظة الدقيقة التي بدأت فيها النعمة الإلهية تعمل على العذراء القديسة لتنقيتها وتقويتها، وعلى هذا النحو يعرض كباسيلاس وجهة نظر فكرية ذات طابع خاص بعض الشيء. ورغم أن بعض عباراته وتحولات تركيزه قد تُفسر أحيانًا على أنها تشبه آراء المدرسية Scholastic في القرن الثالث عشر، بل وأحيانًا تختلف عن أسلافه المباشرين، فإن هذا الرأي لا يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ حقيقة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فروضه اللاهوتية تنتمي إلى عالم مختلف جوهريًا.
وبالفعل، فإن تعدد الآراء في التقليد الآبائي لا يعني بالضرورة تناقضها حول مسألة براءة وطهارة العذراء القديسة، كما يظهر بوضوح في العمل المعاصر لكباسيلاس والقديس غريغوريوس بالاماس، الذي يشترك معه في كثير من الأمور. فقد اختار كل من بالاماس وكباسيلاس التركيز بالدرجة الأولى على إعداد الله لأمه المقدسة منذ لحظة حملها على يد يواقيم وحنة، وعلى الحالة الفريدة من الفضيلة التي بلغت إليها من خلال تعاونها الاستثنائي مع إرادة الله ونعمته منذ طفولتها المبكرة، مشيرين إلى أن انتخابها كوالدة لمخلّص العالم لم يكن من قبيل الصدفة بأي حال.
وقد قُدّم رأي مفاده أن كباسيلاس «يبالغ في تقدير» و«يبالغ في تمجيد» والدة الإله إلى درجة تؤدي إلى تمجيد عام لشخصها ولدورها في خلاصنا. ولكن بلا شك، هذا ليس سوى تعبير عن توقير كباسيلاس العميق لوالدة الإله المقدسة. والأمر الثابت بلا جدال هو أن لا مكان في لاهوت القديس نيكولاس كباسيلاس لقبول أو ذكر أو إشارة إلى عقيدة الحبل بلا دنس.
المصدر:
Christopher Veniamin, The Orthodox Understanding Of Salvation: Theosis In Scripture And Tradition, 2014, P. 43-57
_____________
[1] لأسباب تتعلق بالمكانة والهيبة، فضّل نيقولاوس استخدام اسم والدته العائلي “كباسيلاس” على اسمه الأبوي “خمايتوس Chamaetos”.
وربما يرجع سبب الخلط أحيانًا بين نيلوس وابن أخيه إلى أن نيلوس، كعلماني، كان يُدعى أيضًا نيقولاوس.
[2] من الناحية الدقيقة، لا وجود في التقليد الآبائي الأرثوذكسي لمفهوم «الخطيئة الأصلية» بالمعنى الذي فهمه اللاتينيون والبروتستانت. ويفضل الأرثوذكس غالبًا استخدام تعبير «الخطيئة الجدية» (ancestral sin)، إذ يشير هذا التعبير إلى الابتعاد عن فكرة أن الطبيعة البشرية قد ورثت ذنب آدم نفسه. ووفقًا للآباء، فإن سقوط آدم أفضى إلى الموت (وهو ليس مخلوقًا من الله) والفساد، واللذان يؤديان بدورهما إلى خطيئة الإنسان، ومن ثم ميلنا إلى الشر. كما تجدر الإشارة إلى أن العقيدة الأرثوذكسية تتجنب مفهوم الضرورة وتحافظ بذلك على حرية الاختيار أو «الإدارة الذاتية» للذات الشخصية—الجوهر الإنساني.
وللتحقيق الأعمق في الفهم الآبائي للسقوط مقارنة بالعقائد الغربية اللاتينية والبروتستانتية، يُرجع إلى العمل الرائد ليوحنا رومانيدس بعنوان «الخطيئة الجدية» (المترجم: الكتاب موجود بالعربية، صادر عن منشورات ثيؤلوجيا—Theologia Press)
كما يُنصح بقراءة بحث إنغليزاكيس Englezakis «رومية 12:5—15 وتعليم بولس عن موت الرب: بعض الملاحظات»، في مجلة Biblica عدد 2 المنشور عام 1977، الصفحات 231—236، حيث يشير إلى مخطط A—B—B—A في لاهوت بولس عن السقوط، أي مفهوم: الخطيئة—الموت—الموت—الخطيئة.
[3] كتب توما الأكويني عن نوعين من «التقديس» للعذراء الدائمة العذرية: التقديس الأول (Sanctificatio prima)، وهو الفترة بين لحظة حملها في رحم أمها وولادتها؛ والتقديس الثاني (Sanctificatio secunda) أثناء حملها المسيح. ففي التقديس الأول، تحررت نفسها من اندلاع الأهواء، ومن فعل تأثير الخطيئة الأصلية؛ أما في التقديس الثاني، فقد تحرر جسدها كذلك، أو تنقى تمامًا حتى من جوهر الأهواء، ومن الفعل المحتمل للخطيئة الأصلية، أي من فساد الجسد ذاته (infectio carnis)، الذي قد يفسد أيضًا الآخرين بالخطيئة الأصلية.
[4] راجع: طروبارية على اللحن الثامن لباسيليوس الراهب، عيد دخول والدة الإله إلى الهيكل: «الذين حملوك إلهيًا يا طاهرة ونقية…»،
[5] يحذّر فلاديمير لوسكي من احتمال المبالغة في هذا الصدد قائلاً: «لا يمكننا القول إن الإنسانية التي اتخذها المسيح في رحم العذراء المقدسة كانت تتمة لإنسانية أمه. فهي، في الواقع، إنسانية شخص إلهي، ذلك “الإنسان السماوي” (1كورنثوس 15: 47—48). فطبيعة والدة الإله الإنسانية تنتمي إلى شخص مخلوق، هو ثمرة “إنسان الأرض”. وليس والدة الإله، بل ابنها هو رأس الإنسانية الجديدة، “وجعَلَ كُلّ شيءٍ تَحتَ قَدَمَيْهِ ورَفَعَهُ فَوقَ كُلّ شيءٍ رَأْسًا لِلكنيسَةِ، التي هِيَ جَسَدُهُ ومِلؤُهُ” (أفسس 1: 22—23). وهكذا تكون الكنيسة هي تتمة إنسانيته. ولذلك، فمن خلال ابنها وفي كنيسته، استطاعت والدة الإله أن تبلغ الكمال المحجوز لمن يحملون صورة “الإنسان السماوي”». انظر كتاب «كلية القداسة (باناجيا Panagia» الصفحتان 204—205.
[6] كتاب: شرح الإيمان الأرثوذكسي، PG 94، 985B. الخط المائل من تأليفي.
يقبل متروفانيس كريتوپولوس (1589—1639) أنه بعد البشارة تحررت العذراء القديسة من الخطيئة الأصلية، مع أنه يضيف أنها كانت أيضًا بحاجة إلى التنقية والخلاص، ويستشهد بقول لوقا 1:46—47: «تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلّصي».
يكتب فلوروفسكي أن «مريم نفسها كانت مشاركة في سر إعادة الخلق الفدائي للعالم. لا شك أنها تُحسب من بين المخلصين. فهي كانت بوضوح في حاجة إلى الخلاص. ابنها هو مخلصها ومنقذها، كما هو مخلص العالم». لكنه يضيف أيضًا أن «هي الإنسان الوحيد الذي يكون فيه مخلص العالم أيضًا ابنًا، ابنها الحقيقي الذي حملته حقًا. يسوع بالفعل… هو ثمرة رحم مريم»، في كتاب «الخلق والفداء»، المجلد الثالث من الأعمال الكاملة لجورج فلوروفسكي، ص. 177.
[7] يكتب دوسيتيوس الأورشليمي Dositheus of Jerusalem (1641 — 1707) أن نقائص وضعف القديسين (بما في ذلك القديس يوحنا المعمدان ووالدة الإله) تنتمي إلى «ثمار» الخطيئة الأصلية، التي يشعر بها جميع الناس في هذه الحياة.
[8] حين يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: «أن أمومة العذراء الإلهية لن تكون ذات قيمة بدون كونها فاضلة»، فهو يؤكد أن شرف ومكانة مريم كونها والدة الإله مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بطهارتها وفضائلها الروحية. بعبارة أخرى، إن مجرد كونها حاملة المسيح — أي والدة الإله (Theotokos) — لا يكفي بحد ذاته ليمنحها تلك القداسة أو الاستحقاق. إن الذهبي الفم يشير إلى أن قداسة مريم الشخصية، وفضائلها، هي التي تعطي قيمتها الحقة ومعناها الروحي لدورها كأم الله. فلو لم تكن فاضلة — مؤمنةً، متواضعةً، مطيعةً، وطاهرة — لأفقدت أمومتها الإلهية معناها وقيمتها الحقيقية في الجوهر الروحي، بل حتى إننا لنقول إن الله ما كان ليختارها في المقام الأول ليتجسد منها. وهكذا، فالأمومة ليست مجرد حقيقة بيولوجية أو ظاهر خارجي، بل هي لا تنفصل عن قدسيتها الداخلية. وهذا يؤكد على أن القداسة الشخصية هي الأساس الذي يعزز ويُعلي من شأن دورها الفريد في تاريخ الخلاص.
[9] ومن الملاحظ، كما يشير لوسكي، أن وقوع لوقا 19:8—21 مباشرة بعد مثل الزارع ليس بالأمر العابر: «فإنها بالضبط تلك القدرة على حفظ الكلمات التي تُسمع عن المسيح في قلب أمين وصالح — القدرة التي يرفعها المسيح في موضع آخر فوق حقيقة الأمومة الجسدية (لوقا 28:11) — التي لا ينسبها الإنجيل لأي شخص سوى والدة الرب. ويصرّ القديس لوقا على ذلك، إذ يذكرها مرتين في سرد طفولة المسيح: “وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة فيها في قلبها” (لوقا19:2)».