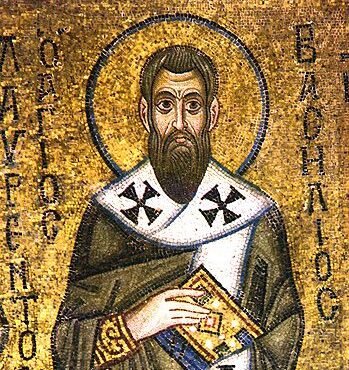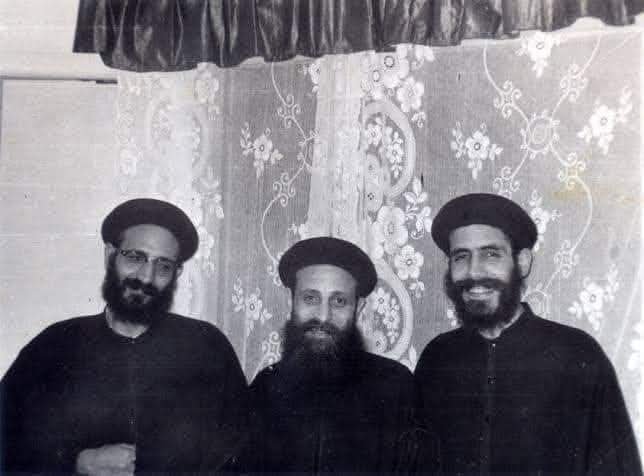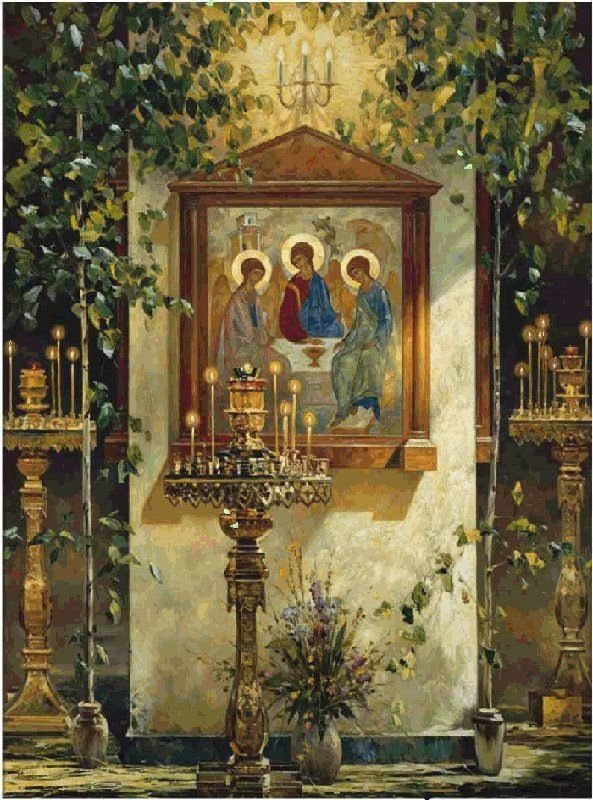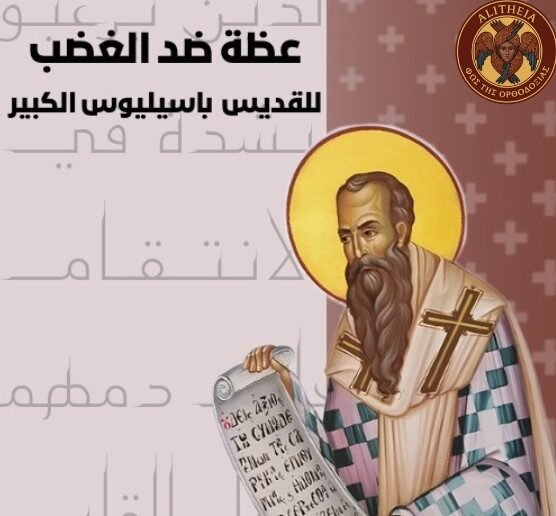مقدمة وتلخيص:
يناقش النص موقف الأرثوذكسية من العقل والإيمان، موضحًا رفضها للجدل العقلي كوسيلة لتثبيت الإيمان بالله، واعتبار الإنجيل سرًّا لا موضوعًا للمناظرة. تركّز الكاتبة على محدودية العقل البشري أمام الإلهيات، ويرى أن التوبة الداخلية، لا الأخلاق الظاهرية، هي جوهر الحياة الروحية. ينتقد تغيّر مفهوم الصوم الأرثوذكسي وانزلاقه نحو الشكليات، مقابل روحانيته الأصيلة التي تدعو إلى كبح في الأساس إلى كبح الشهوة. ويبرز دور “صلاة يسوع” كممارسة روحية تُطهّر القلب، وتحفظ الإيمان من التحجيم العقلي. كما يبيّن موقف الأرثوذكس من القداسة، مؤكدًا أن القديس يُعاش لا يُصنّف، وأن القداسة ليست اعترافًا مؤسسيًا بل إعلانًا إلهيًا وشعبيًا يتجلّى.
يجب الإشارة إلى أمر بديهي، هو أن الكاتبة الأم تكلا راهبة. التعامل مع الأدب الرهباني يتطلب قدر من التمييز والفحص، وهو لا يمثل دعوة دعوة عامة لجميع الأرثوذكسيين. يظهر هذا الأمر بوضوح في رؤية الكاتبة للعلاقة الزوجية في فترة الصوم. لا يجب أن يُفهم من النص أن الأرثوذكسية ترفض “العقل”، ولكنها ترفض إقحام العقل في غير مجاله؛ أي فحص ما لا يُفحص من الإلهيات.
——————————————————————————————————————————–
إنّ الجدل البشريّ لا يُمكن أن يُقيم للإيمان دعامةً أشدّ صلابة، بل لا يزيد على أن يُقوِّضه بمنطقٍ جدليٍّ خلافيّ. لا نستطيع أن نُقيم البرهان على وجود الله. فالإنجيل ليس وسيلةً للحجاج الدينيّ، ولا هو أصلٌ للمناظرة، بل هو السرّ الإلهيّ الأقصى. بل هو، في حقيقته، يُظهِر التناقض ويُبرزه. ألا ترى كيف أنّ قتلة المسيح كانوا يتلهّفون على آيةٍ تُنقِذه من الموت. وكيف أنّ إبليس جرّب أن يستدرجه في البرية ليُثبِت ألوهيّته، فأبى؟ الله لا يطلب براهين. الله يطلب إيمانًا.
نحن الأرثوذكس، من حيث المبدأ، نُقِرّ بحدود العقل البشري، وإن كنّا -كغيرنا من بني الإنسان- لا نبلغ دومًا إلى سُموّ هذا الإقرار في عيشنا اليوميّ. نحن نعلم أنّه لا يجوز لنا أن نطلب برهانًا على ألوهيّة المسيح. ونعلم أنّ في روايات الأناجيل تناقضاتٍ صارخة للعين المجردة. ونعلم -وقد أُثبت ذلك مرارًا- أنّ سفر الرؤيا، على الأرجح، لم يكتبه يوحنا الإنجيليّ. ونعلم، ومع ذلك، فإنّا نفرح. فإن لم نُؤهَّل بعدُ لأن نُستشهَد لأجل إيماننا، فلنا، على الأقل، أن نحمل بفرح وصمة “اللاعقلانية” الكاملة، والتبلُّد في وجه “الحقائق المثبَتة”.لن نُدفَع دفعًا إلى إسقاط حدود العقل البشريّ على ما لا يُدرَك من الإلهيّات. لن ننزل إلى ساحة الجدل، ولا نُقحم إيماننا في مناظرات العقول. لسنا نُعنَى بالتحقيقات التاريخية المفرطة في التدقيق والتفنيد. فحسبنا أن نُجاهد في مشقّات حياتنا اليومية لنسلك بحسب تعليم المسيح، دون أن ننشغل في نقاشٍ حول مشروعيّته.
غير أنّ هذا يُفضي بنا إلى وجهٍ آخر من أوجه الأرثوذكسيّة في حياتها اليوميّة، وجهٍ أكثر إشراقًا، مليءٍ بالبهجة: بهجة الصوم والعيد. وربّما كانت بهجة الصوم -في البلاد غير الأرثوذكسيّة- أعمق وأصدق! لكنّنا، في المجمل، قد فقدنا شيئًا من المفهوم الجوهريّ للصوم، ومن ثمّ ضعُف لدينا الشعور بضرورة بساطة الطعام في أوقات الصيام، وتلاشى الاكتراث بالامتناع عن الأطعمة “المبتكرة”، أيًّا كانت مكوّناتها، ما دامت تُغذّي الشهوة وتُرضي الذوق. فالفكرة الأساسية في الصوم الأرثوذكسيّ -أي تجاهل الشهوة من جميع وجوهها، سواء أكان في الطعام، أم في اللهو، أم في متعة العلاقة الزوجية- قد تشوهت شيئًا فشيئًا عمليًا، إن لم تكن قد تشوهت أيضًا نظريًا.
في الغرب، حيث “طعام الصوم” لا يرقى إلى أن يُسمّى فقرًا غذائيًا، فمثلًا، اشتراط أكل السمك يوم الجمعة، قد ينقلب بسهولة إلى مغامرة تذوّق للأطباق الغريبة: أن يُستبدل سمك القدّ بالحبّار، وأن يُقدَّم الكافيار أو الكَرْكَنْد بدلًا من معجون السلطعون! إنّ السعي خلف “المكوّنات المناسبة” لا يُعدّ تقييدًا للحواس، بل بالعكس. ومع ذلك، فلعلّ هذا اللهو الغذائيّ يحمل معنًى أرثوذكسيًا ضمنًا، إذ لا يُمكن لأحد أن يتّهمنا بالـ”فطرة السليمة”(1) فنحن، وإن شربنا حليب الصويا بدلًا من الحليب، وأكلنا الشوكولا السوداء بدل البيضاء، وغضضنا الطرف عن الحروف الصغيرة على العبوات التي توضح مكوناتها، فإنّنا -على الرغم من كل ما سبق- نُكثِر من طلب المغفرة في الصوم، أكثر من سواه من المواسم.
وهنا نصل إلى جوهرٍ أساسيّ في الروحانية الأرثوذكسية: التوبة. مرّةً بعد مرّة، تكون الأخلاقيّة عدوًّا مباشرًا للروحانيّة، وفي حقيقتها، عدوًّا للمسيحية، أي لعمل الروح القدس فينا. فالأخلاق، كاللطف، والكرم للفقراء، والضيافة، وعدم السرقة أو القتل، وزيارة المرضى -وإن كانت ممدوحة- قد تكون ضربًا من ضروب الغرور الشيطانيّ، إن بقيت في حدود السلوك فقط. قد تظلّ مجرّد إتمامٍ للناموس، بينما الروح قد يكون في جمودٍ قاتل، بل في اضطرابٍ عميق.
والكسل الروحي، ولا سيّما حين يتغطّى بمظهر اللطف والكرم والاحترام، لا يُقاوَم إلا بالتوبة، بالسجود أمام الله، في اعترافٍ بالعجز، بالتوبة عن بؤسنا الروحيّ، وضيق صدورنا، وطبقات “برّنا” الخارجيّ: نصوم، ونذهب إلى الكنيسة، ونتصالح مع زملائنا… لكنّ التوبة الحقيقية، كما نفهمها، ليست ندمًا على خطيئة بعينها، ولا كفّارة عن تقصير أخلاقيّ أو كنسيّ، بل هي توبة عارية، خالصة، انسحاق بسبب خطيئة القلب، خطيئةٍ لا تُعرَّف بسهولة، وتبقى أشرس ما يُهدِّد الحياة الروحية للمسيحي.
ومن هنا تنبع أهمية صلاة يسوع في تقليدنا. صلاة يسوع هي صلاة القلب في مواجهة خطيئة القلب، هي التركيز على الاسم -على شخص ابن الله المتجسّد- حتى لا يبقى في القلب متّسعٌ لشيء سواه. وحين يُطرد الشرّ ببطء، إنشًا بعد إنش، لا يبقى في الروح فراغ يستقبل جوقةً أوسع من الشياطين. وطبعًا، لا تُنال هذه الطهارة الداخليّة للروح الخاطئة، ومن ثمّ لا يبقى لنا إلا التوبة الدائمة: تُب، ثم تُب مرّةً أخرى. وإنّ مثل هذه التوبة، في صرخة القلب، تطرد الخوف، حين نطرح أنفسنا سُجّدًا أمام المخلّص الحبيب.
وصلاة يسوع هي صلاة إيجابية: فكلّما كرّرنا اسمه -مرّةً بعد مرّة- نجد السلام في حضوره، اللؤلؤة الثمينة التي تُغنينا برجاء الخلاص. وبصلاة يسوع، نبلغ وجهًا آخر من الموقف الأرثوذكسيّ العميق: رفض التحديدات العقلية الضيّقة، ورفض تقنين الإيمان بمصطلحات عقائدية. نحن نتمسّك بالسرّ. فماذا بوسع عقولنا البشرية أن تدرك من العناية الإلهية، أو الدينونة، أو الصلاح الإلهي؟ لا تعاريف بشرية، بل دعوةٌ إلى الإيمان الأعمى، خارج حدود محاولات الإنسان اليائسة لجعل ما لا يُفهَم، مفهومًا. علماؤنا، عبر القرون، لم يكونوا يضعون الإنجيل على طاولة النقاش، إلا إذا اضطرتهم الهرطقة إلى ذلك. وحتى عندئذ، كانوا يشرحونه، لا يُجادلون فيه.
أعرف كاهنًا قبرصيًا، أراد يومًا أن يحصل على شهادة أكاديمية في اللاهوت بجامعة إنجليزية. لكنّه ما لبث أن انسحب بعد بضعة أسابيع. سألته: “لِمَ تركت سريعًا؟” فأجاب، في اشمئزازٍ مما رآه “هرطقة! لن أسمح أن يُمسّ المسيح.”. لقد عاش عمره مُعفى من الجدل العقيم، وكان لاهوته شرحًا للمسيح، لا نقاشًا حول أهليته كإله. وبوجه عام، لا نُساوي بين البدعة وبين التقليد. لكن لعلّ علينا اليوم أن نكون أكثر حذرًا، وقد صار انفتاحنا على التأثيرات الغربية أوسع، تلك التي تُعظّم “حرّية” البحث العقائدي. الحرّية؟ نعم. لكن ليس على طراز الإنسانوية النهضوية.
ينبغي أن تُقودنا الأرثوذكسيّة نحو الصلاة، والتأمّل، والقدّيسين. كلمة لا بدّ منها عن موقفنا من قدّيسينا: القديس سرَافيم روّض الوحوش حول قلايته، والقديس يوحنا الذهبيّ الفم مات في سبيل الإيمان القويم. فإن كانت مكانة سرَافيم واضحة، فما مكانة يوحنا؟ شهيد؟ أم أب من آباء الكنيسة؟ أم كليهما؟ قدّيسونا لا يُصنَّفون. فالكلمة الوحيدة المهمّة عندنا هي: Holy “مقدَّس” ، أما كلمة “قديس” Saint في الإنجليزية، فذات دلالة قانونية (2). كأنّ الكنيسة تُمنحها اعترافًا رسميًّا بالقداسة، كما يُمنح اللورد لقبًا شرفيًّا. أما عندنا، فالقدّيسون يظهرون من تلقاء أنفسهم، برؤية، بمعجزة، أو بطلب شعبيّ متزايد لإكرام رفاتهم. ورغم أنّ هذا قد يفتح بابًا للخرافة وسوء الاستخدام، فأيّ شيء لا يُستَغَل؟! ومن نحن لنُنكر ذَرّةً من حقّ قد تبقى في أسوأ مظاهر التعلّق العاطفيّ الشعبيّ؟
——————————————————————————————————————————–
Mother Thekla, The Dark Glass: Meditations in Orthodox Spirituality, Introduction, 2022