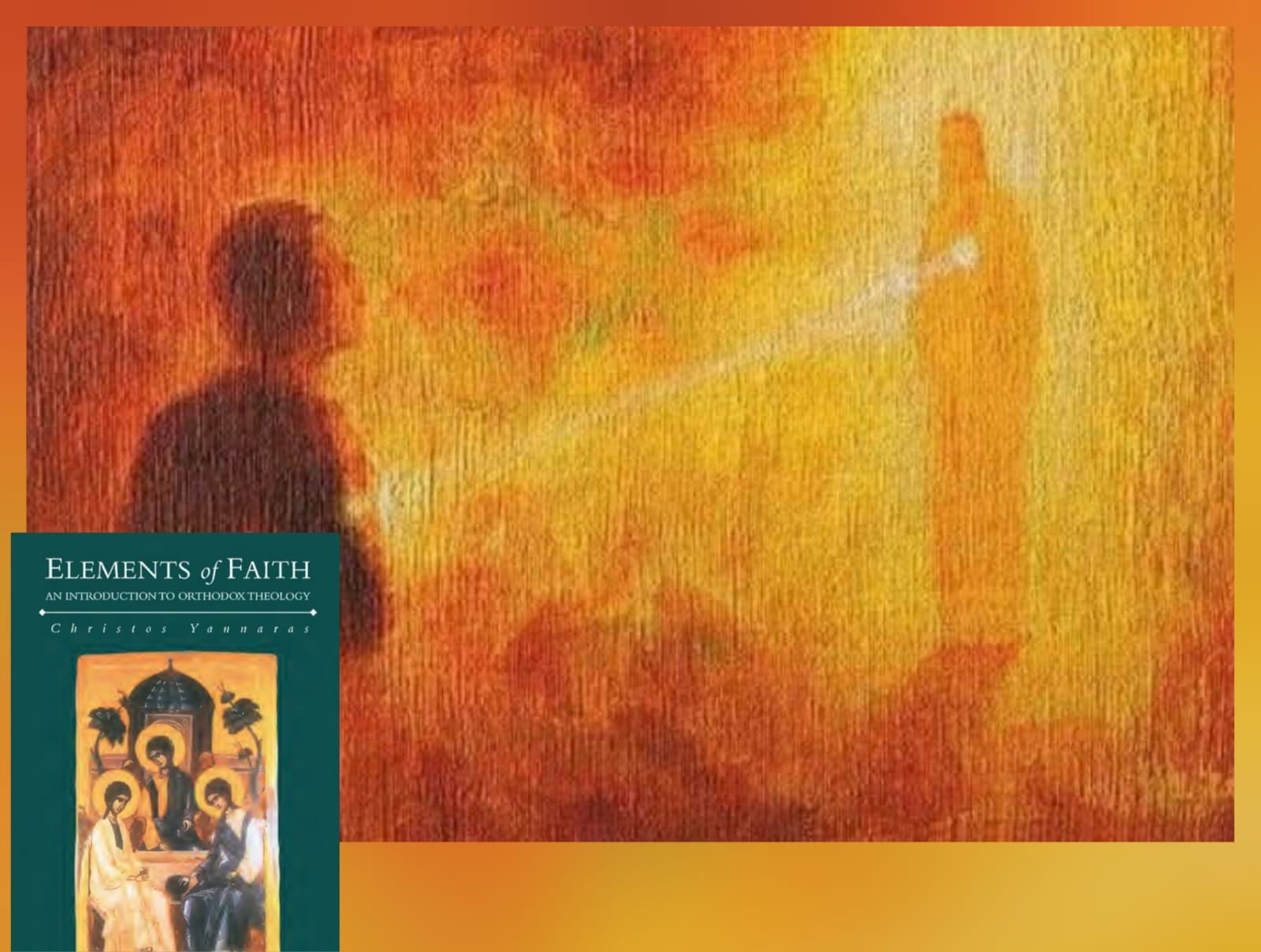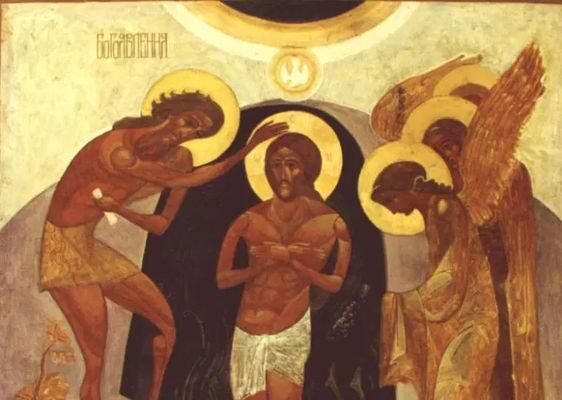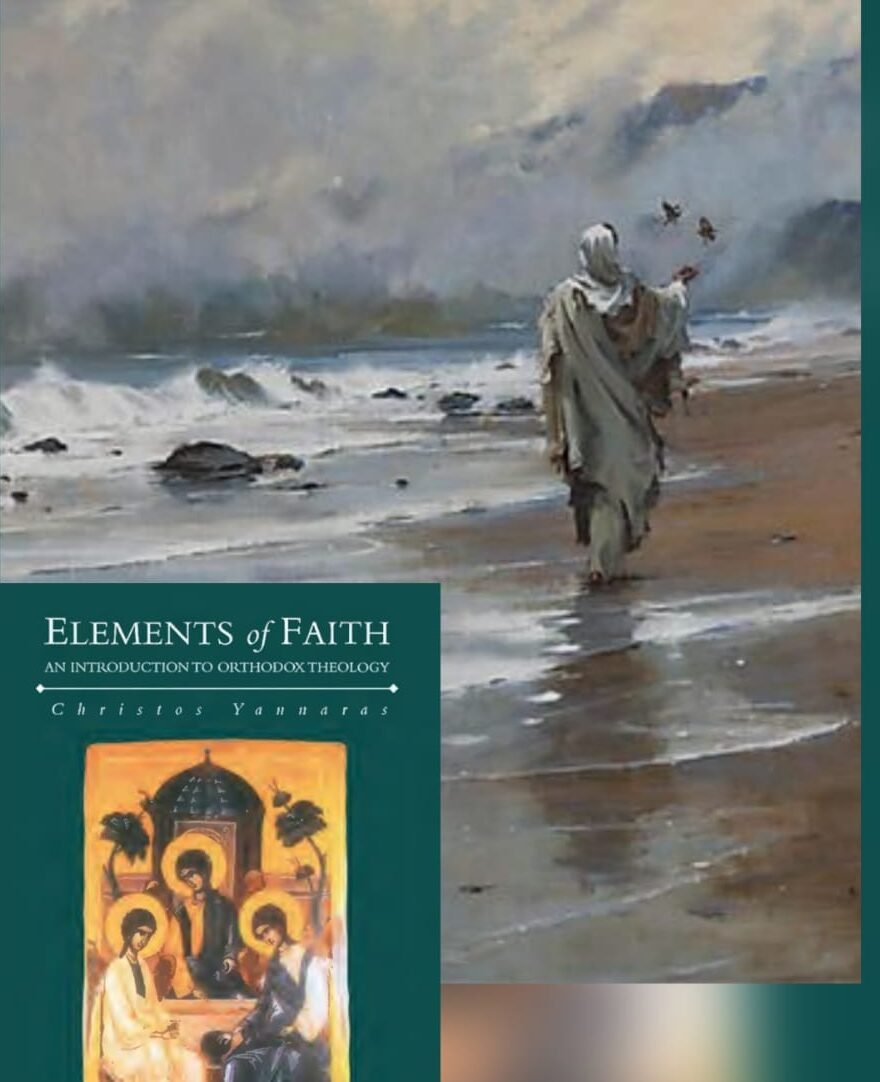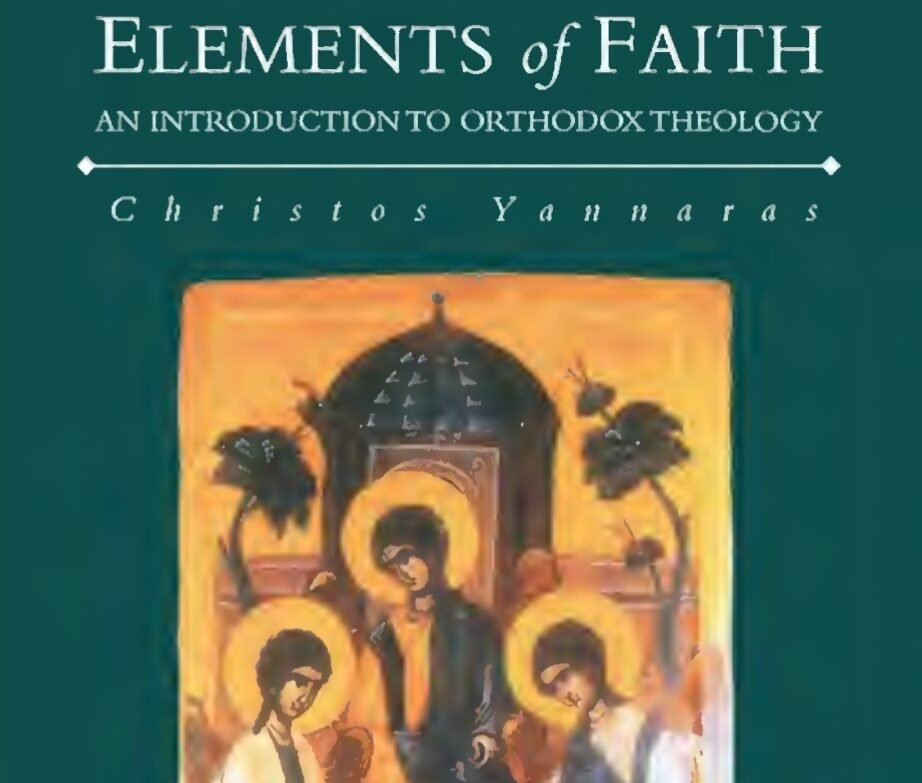يُعتَبَر الفيلسوف الروسي نيكولاي برديايف أحد الفلاسفة الوجوديين الذين يركّزون على اللاهوت والروحانية الأرثوذكسيَّين. ومع ذلك فإنّه لا يجب وضع برديايف في صف واحد مع اللاهوتيين الأرثوذكس سواء الفلاسفة المجددين منهم مثل سيرغي بولغاكوف وبافل فلورنسكي أو الأكثر تقليدية مثل جورج فلوروفسكي وفلاديمير لوسكي. ينتمي برديايف بشكل ما، ومن جهة أخرى، إلى تراث الشخصانية الأوروبية، وهو ينطلق من مفاهيم الحرية وأولويتها على الكينونة، والشخص الإنساني، والنظرة الإسخاتولوجية المناهضة لتقديس أي شكل من أشكال الاجتماع البشري التقليدي، مثل الدولة والقبيلة والمجتمع والعائلة والكنيسة المُمَأسسة.
في كتابه “قَدَر الإنسان” يقسّم برديايف الأخلاق إلى ثلاثة مستويات تصاعدية:
- أخلاق الناموس أو الشريعة، وتشمل الشرائع الدينية والمدنية أي القانون الحديث. وهي ضرورية لتنظيم الحشود والحياة الشخصية للإنسان في أدنى مراتب وعيه. هذا المستوى الأخلاقي يعتمد عادة على فرض القانون من الخارج، وتميل فيه الكفّة إلى سحق الجماعة لشخصية الفرد جزئياً أو كلياً. أو بالأحرى لا يمكن أن يوجد فرد ذو شخصية فاعلة وإبداعية في مثل هذا النمط الأخلاقي الاجتماعي.
- أخلاق الفداء أو الأخلاق المسيحية: وهي الأخلاق التي تتجاوز أخلاق الناموس، الأخلاق المسيحية التي تعتبر أنّ الهدف الأسمى للإنسان هو خلاص نفسه. يعتبر برديايف أنّ هذا النمط الأخلاقي قابل بسهولة إلى الانقلاب إلى نقيضه. وهو إذ يتخذ من التواضع والمحبة، وليس الناموس الثابت، أساسين، إلا أنه يمكن أن ينتهي بسهولة إلى عكسه؛ فالتركيز المبالغ به على النفس من أجل تخليصها قد ينتهي بالإنسان، وهو بالفعل انتهى بالكثيرين، إلى الكبرياء والبرود العاطفي وكراهية الناس العاديين أو على الأقل النفور منهم بسبب عدم إمكانية التماهي مع صعوبات حياتهم وآلامهم الملموسة واليومية، وإلى رفض الإبداع والتطور والاستسلام أمام الواقع وفقدان الأمل بالعالم والناس. وفي أكثر من عمل من أعماله يذكر برديايف الأب ثيوفان الحبيس كمثال على النسك “غير المستنير”. ويستغرب برديايف كيف يمكن لهذا النمط من النسك أن يدين الجسد والأهواء والإبداعات البشرية مثل الحبّ والفنون وفي نفس الوقت يبقى متصالحاً كلياً مع أخلاق الطبقة البرجوازية ورياء زواج الصالونات ومؤسسة الأسرة بشكل عام والنشاط التجاري بكل ما يحتويه من ألاعيب لا يمكن فصلها عنه. ومن المثير أنّ عالم النفس كارل يونغ يقدم ملحوظة شبيهة في مقدمة كتابه “علم النفس والخيمياء”؛ فهو يلاحظ أنّ أخلاق “الاقتداء بالمسيح” imitatio Christi في الكنيسة الكاثوليكية تنتهي في غالبية الأحوال إلى شكل خارجيّ للعبادة من دون أي تحول في الإنسان الداخلي، لا بل قد يصل المرء إلى ظهور جروح “عجائبية” على جسد المؤمن (في مكان جروح المسيح) من دون أن يتقدّم هذا الإنسان خطوة واحدة على صعيد الكينونة (المقطع 7).
- الأخلاق الإبداعية: وهي أخلاق عالم ما وراء الخير والشرّ، وفيها يبدع الإنسان قيمه (ويمكن ملاحظة تأثير نيتشه هنا) بناءً على القيم الروحية العظمى وأهمها المحبة والتآزر الإلهي-الإنساني؛ فالإنسان ليس تحت سلطة الناموس، وليس خائفاً مأخوذاً بنفسه لتخليصها من الجحيم، بل هو يركّز على الخلق والإبداع، وهذا يشمل الإبداع الخارجي كما في الفن، أو الإبداع الداخلي حين يبتكر قيمه الخاصة تماشياً مع تجربته الحياتية العميقة. كمثال على ذلك يمكن أن نأخذ مثالاً من العالم المعاصر: أن يرفض الإنسان مساعدة مالية مثلاً هي من حقه تماماً قانوناً، لكي يتركها لمن هو بحاجة، أو لأنه يعتقد أنّ ما لديه يكفيه باعتدال. في هذه الحالة أبدع الإنسان قيمة أخلاقية، ليس من أجل إتمام ناموس ولا لكي يطهّر روحه بالمعنى الديني الجزائي، بل فقط لأنه يعتقد أنه مكتفٍ. وكمثال آخر على سبيل المثال، أن يضحي الإنسان بحرّيته أو بحياته أو بمجتمعه من أجل حبّ ما، أو أن يضحي بحبّ ما من أجل حرّيته.
يرى برديايف أنّ هذا النمط من الأخلاق قد يصل أحياناً بالمرء إلى الفوضى في حال لم يكن راسخاً في بعض المبادئ الروحية الكبرى أو بما هو فوق-شخصيّ. وهنا يكمن البارادوكس الإبداعي: نموّ شخصية الإنسان يشير جنباً إلى جنب مع اعتناق القيم اليونفرسالية فوق الشخصية. ولكن هذه القيم اليونفرسالية لا تطابق قيم المجتمع أو الجماعة المحدودة بالزمان والمكان، بل على العكس تماماً. القيم اليونفرسالية سماوية لا متناهية، باستعمال الاصطلاح الشائع، بينما قيم الجماعة (الميراث والتقليد وأخلاق الأمة والقبيلة) أرضية متناهية.
ولكنه بالعموم يرى بأنّ قدر الإنسان هو أن يصل إلى الأخلاق الإبداعية التي تخلق قيمها الوجودية الشخصية، بما أنّ الإنسان على صورة الله الخالق، ولو أنّه من المستبعد أن يتمكن من التخلص كلياً من النمطين السابقين، وخاصة من القانون الضروري لتنظيم المجتمع.
هذا برأي برديايف أمر مؤسف للغاية وتراجيديّ. ولكن الفرق هنا أنّ برديايف في اعترافه ببعض المنافع التاريخية والاجتماعية للناموس والأخلاق المسيحية الكَنَسيّة لا يقرّ بقداسة ما ينجم عنهما، بل هما مجرّد أداتين اجتماعيتين للتنظيم وتسيير بعض الأمور ضمن المكان والزمان أو ضمن مكان وزمان محدّدين. برديايف هنا يتفق مع الفيلسوف الألماني فويرباخ في إعادة كثير من الظواهر الدينية إلى مجرد حاجات اجتماعية، وبالتالي لا يعتبر أنّ الإنسان مجبّر على طاعة هذه التنظيمات. مفهوم الطاعة بالنسبة لبرديايف هو إحدى بقايا أنظمة العبودية والاستعباد المختلفة التي حكمت البشرية طوال تاريخها. وسعي الإنسان نحو الحقيقة العظمى لا يجب أن تعرقله أيّة عراقيل، بما في ذلك الدين نفسه في صيغه الواقعية التاريخية المتعددة. وهنا أجد في فكرة ألبرت شفايتسر، وهو لاهوتي ليبرالي، عن الحقيقة مثالاً على ذلك—هذه الحقيقة التي قد تجد التقوى الدينية أحياناً صعوبة في قبولها؛ فبعد دراساته التاريخية عن “يسوع التاريخي”، التي عدّل بها بعض دعاوي اللاهوت الليبرالي نفسه، يتساءل شفايتسر: ما الفائدة من كل هذه الدراسات، وخاصة أن بعضها قد يسبب المتاعب الفكرية والروحية للناس العاديين؟ ولكنه يعود فيجيب:
“بما أنّ الطبيعة الجوهرية لما هو روحيّ هي الحقيقة، فإنّ كل حقيقة جديدة تمثّل مكسباً. والحقيقة تحت أيّ ظرف من الظروف أكثر قيمة من اللاحقيقة، وهذا ينبغي أن ينطبق على الحقيقة في مجال التاريخ كما هو الحال مع باقي تجليات الحقيقة؛ فهي حتى لو أتت مقنّعة بطريقة تجعل التقوى تجد فيها غرابة، مما يخلق في البداية بعض الصعوبات، إلا أنّه لا يمكن للنتيجة النهائية أن تكون مؤذية. هذه الحقيقة لا يمكن إلّا أن تعمّق التقوى. ولهذا السبب لا يوجد ما [يجب أن] يخيف الدين من المواجهة مع الحقيقة التاريخية.” وهذا يعني أنّنا إذا كنا فعلاً نبتغي المعرفة فلا يجب أن نخشى من البحث والتفكّر، فما قد ينتج عن هذه السيرورة لن يكن بأقلّ قيمة مما كان لدينا، مهما كان عزيزاً على قلوبنا. هنا جوهر الروحانية بالنظر إليها في مقابل الصنمية؛ فهذه الأخيرة تقدّس العادة والمعروف أكثر من الجديد والممكن اكتشافه. هذا لا يعني بطبيعة الحال أنّ الجديد أفضل من القديم في المبدأ. الفلسفة الوجودية الشخصانية التي ينطلق منها برديايف لا تزعم التقدّمية، كما أنها معارضة للتمسّك بالتقاليد—إنها تنطلق من مفهوم الحرية كحالة بدئية كانت في البدء ولها أولوية على كل “كينونة” وشكل تاريخي وصيغة لغوية ثابتة وأخلاق مجتمعية أو “مسيحية”. كذلك الأمر، لا يرى برديايف إمكانية لأن تكون دولة ما “مسيحية”، إذا فهمنا بالمسيحية تلك الأخلاق الإبداعية والروحانية العميقة والحقة.
هذا التصنيف الثلاثي للأخلاق يتفق بشكل تقريبيّ مع التصنيف الثلاثي للروحانية الذي يقدّمه برديايف في الفصل الأخير من كتابه “الروح والواقع”؛ فهناك روحانية المحدوديات الطبيعانية وروحانية المحدوديات الاجتماعية والروحانية المتحرِّرة النقية. يرى برديايف أن روحانية المحدوديات الاجتماعية توافق الأخلاق المسيحية التقليدية، أما الروحانية المتحررة والنقية فلا تقدّس ما صنعه الإنسان عبر التاريخ، بل “تقدّس فقط الله والطبيعة الإلهية للإنسان، والحق، والمحبة، والإحسان، والعدالة، والجمال، والإلهام المُبدِع”.