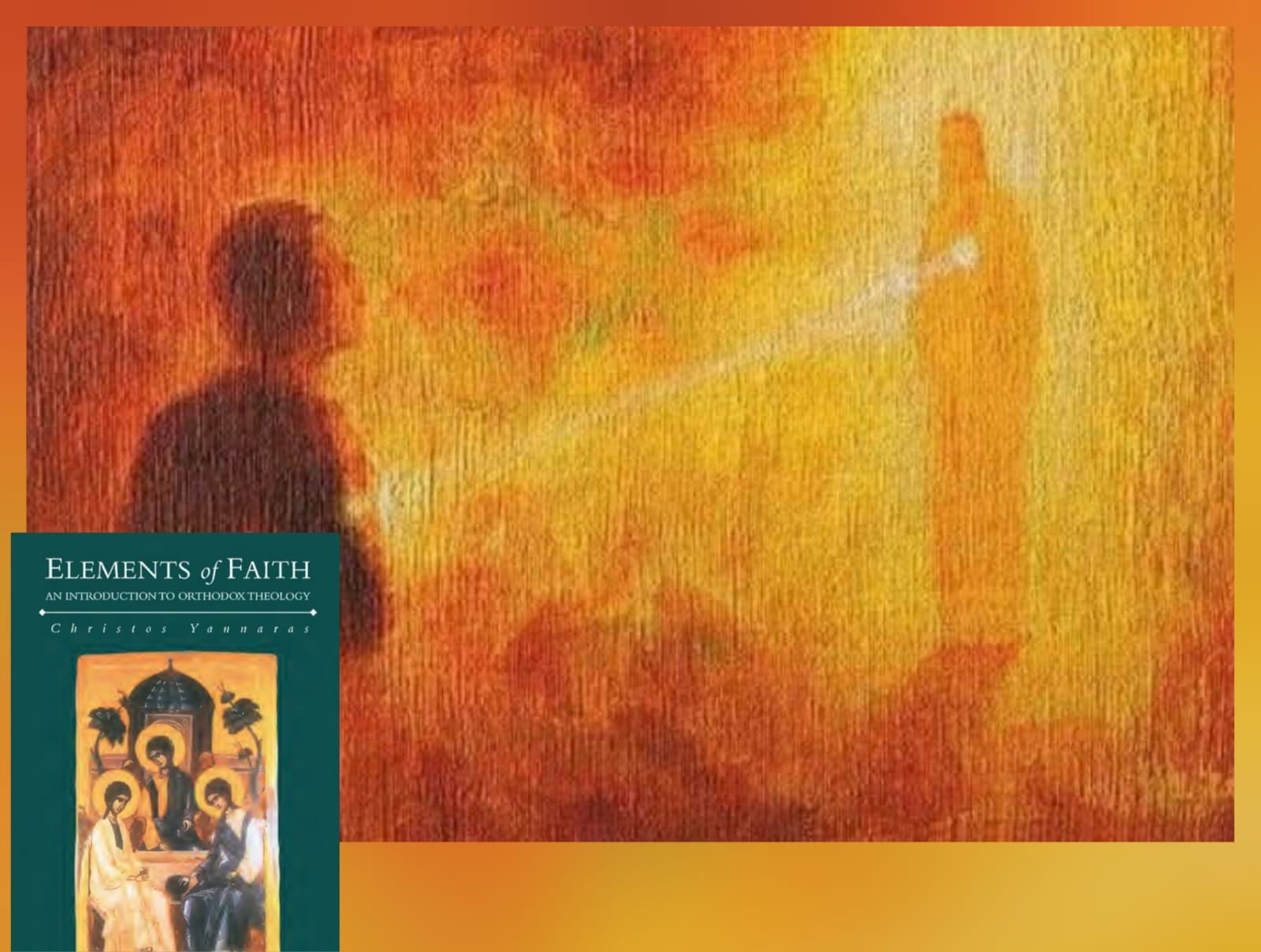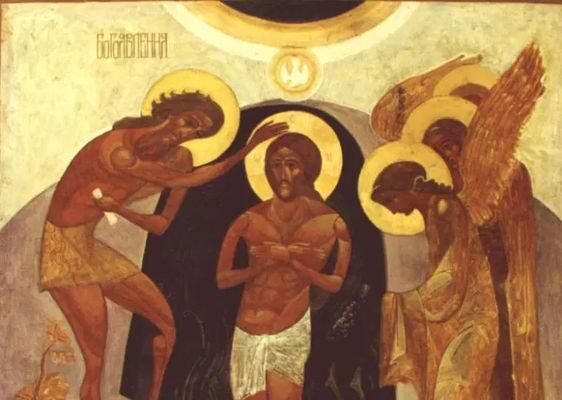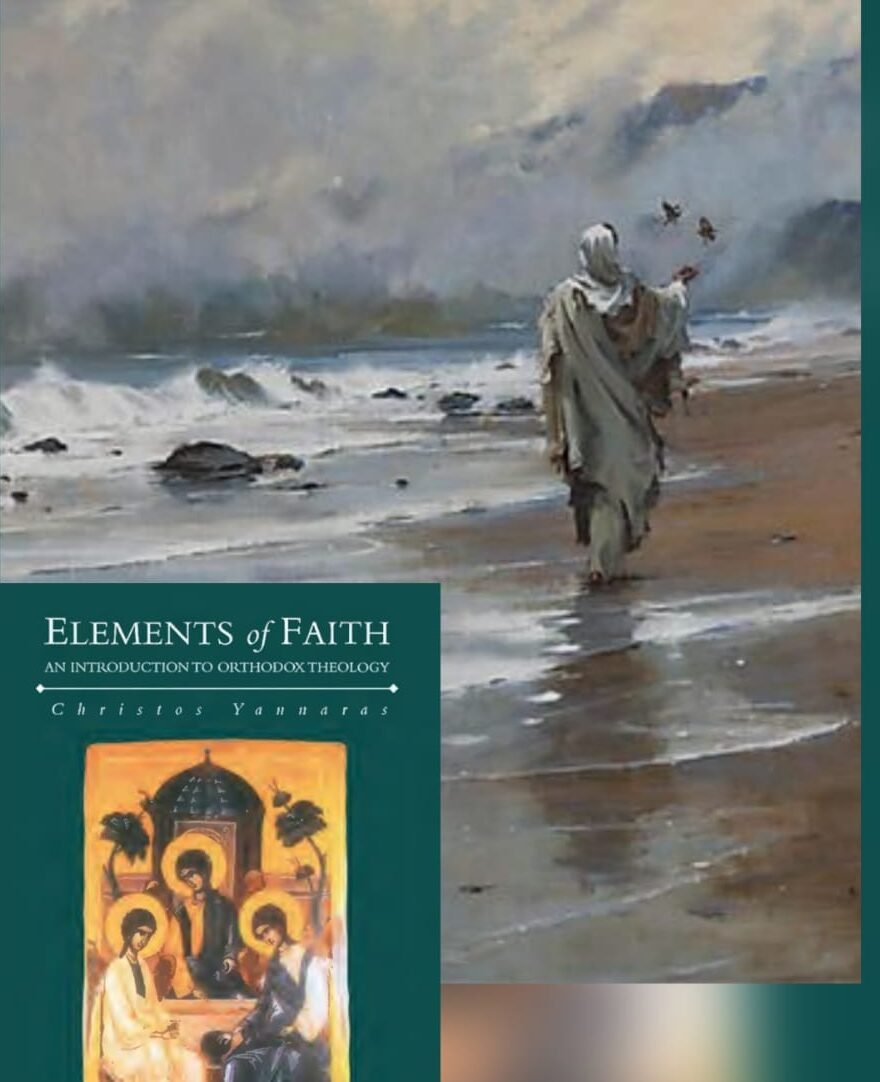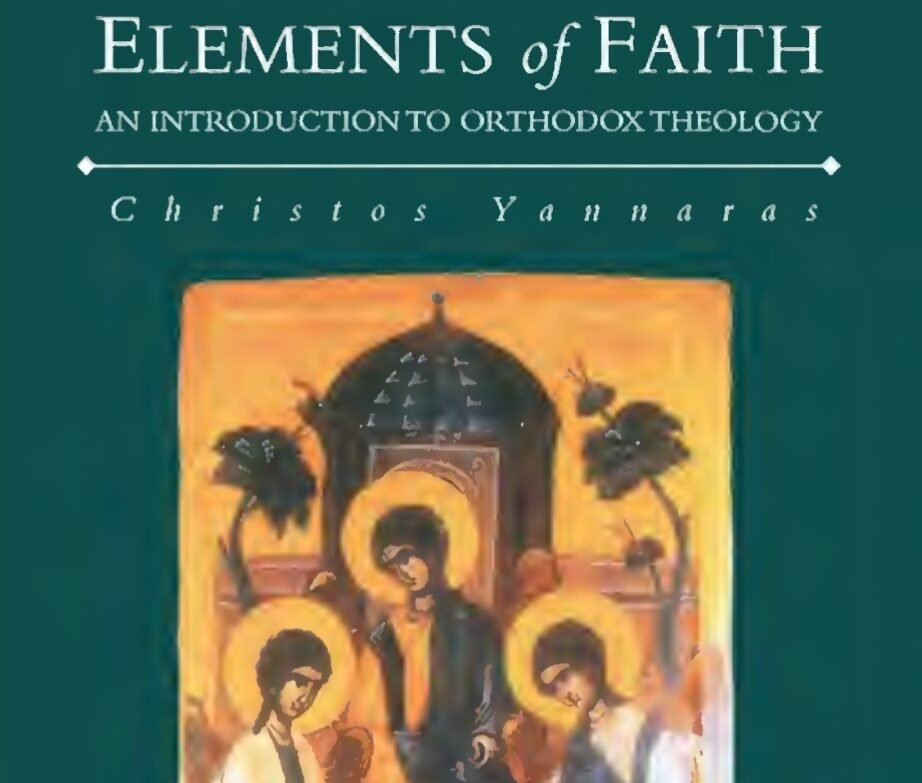من هو كليمندس السكندري؟
إن كليمندس أحد أبرز اللاهوتيين في عصور الكنيسة الأولى، وفي أواخر القرن الثاني الميلادي أصبح الزعيم الفكري للمسيحية في الإسكندرية. فقد كتب العديد من الأعمال الأخلاقية واللاهوتية، وحارب الهراطقة مثل الغنوصيين. ولكننا لا نعرف بالتحديد سبب نياحة كليمندس، إذ إن بعض الروايات المبكرة تشير إلى أنه ربما سُجن أو قُتل بإلقائه في البحر خلال عهد الإمبراطور تراجان، ولكن لا تزال الحقائق بشأن نياحته غير معروفة.
من أبرز المفاهيم التي تناولها كليمندس هو مفهوم النور الإلهي، الذي اتخذه رمزًا للإرشاد والحقيقة والخلاص. ونريد أن نسلط الضوء على هذا المفهوم وتحليله في سياق فكر كليمندس السكندري، والربط بين أصوله الفلسفية ودوره في اللاهوت المسيحي المبكر.
الخلفية الفلسفية واللاهوتية: النور بين الكشف الإلهي والبنية المعرفية للروح
في فكر كليمندس السكندري، النور الإلهي ليس مجرد استعارة رمزية أو تصور مجازي، بل هو حقيقة وجودية ومعرفية تكشف العلاقة الحقيقية بين الله والإنسان. النور هنا مبدأ كشفي يتجاوز الإدراك الحسي والعقلي العادي، ويفتح إمكانًا لمعرفة من نوع آخر، معرفة غير قائمة على التراكم المنطقي، بل على التحول الكياني. فالنور لا يُدرَك فحسب، بل يُستقبَل عبر استعداد داخلي للروح يعيد تشكيل الإنسان من الداخل ويوجه حركته نحو المطلق.
من هذا المنطلق، تتخذ المعرفة عند كليمندس بعدًا روحيًا مركزيًا، إذ لا يمكن للروح أن تبلغ الحقيقة الإلهية ما لم تدخل في حالة التنوير الداخلي، متجاوزةً ثنائية العقل والحس. وهنا يصبح النور الإلهي ليس أداة للفهم، بل قوة تحويلية تغير ماهية المدرك ذاته. فالمعرفة ليست فقط ما يُعرف، بل ما يُصبح عليه الإنسان عندما يعرف. وهذا التبدل في الذات يشير إلى أن النور لا ينقل فقط محتوى معرفيًا، بل يُحدث تحولًا في بنية الكائن الإنساني.
وفي هذا السياق، لا يُفهم النور الإلهي كمبدأ خارجي، بل كحضور متجذر داخل الإنسان، يشرق فيه بقدر ما يطهر ذاته. ولهذا لا يأتي النور دفعة واحدة، بل يتدرج وفق طهارة القلب ونقاء القصد. فالعين النقية وحدها تُبصر النور، كما يلمح كليمندس في تعليمه.
لذا، يُفهم النور كاستجابة متبادلة: من جهة هو عطية إلهية، ومن جهة أخرى نتيجة الاستعداد الأخلاقي والمعرفي للإنسان. وبهذا التصور، يقدم كليمندس رؤية معرفية روحية عميقة لا تفصل بين الحقيقة والممارسة، بين الرؤية والسلوك. فالنور ليس فقط ما نعرف، بل هو الطريقة التي بها نعرف، ولمن نعرف، ولماذا نعرف. المعرفة في النهاية هي العودة إلى الأصل، والنور هو ما يُرشد هذه العودة دون أن يُختزل في صورة أو مفهوم.
ما هي وسائط النور الإلهي؟
في إطار الرؤية اللاهوتية لكليمندس السكندري، لم يصف النور الإلهي بأنه انكشاف عشوائي أو عطاء مباشر بلا وسائط، بل رأى أن هذا النور يتجلى عبر مجموعة من الوسائط الإلهية، التي تعبر من خلالها الحقيقة إلى النفس البشرية. وهذه الوسائط ليست فقط وسائل تعليمية أو رمزية، بل تحمل بعدًا سريًّا وكيانيًّا، وتجعل من الإنسان كائنًا قابلاً للتقديس والمعرفة. ويمكن حصر هذه الوسائط في ثلاثة:
1. اللوغوس: النور بوصفه كينونة متجسدة
في قلب فكر كليمندس، يقف “اللوغوس” (أي الكلمة الإلهية) لا بوصفه مجرد وسيط معرفي بين الله والإنسان، بل بوصفه الوجود النوراني نفسه الذي يكشف الله ويحمل الإنسان إلى حضرته. الكلمة في فكره ليست فكرة ولا صوتًا، بل شخصًا نورانيًا يتجلى في التاريخ، وهو في الوقت نفسه مبدأ الخليقة ونهاية معرفتها.
من هنا، لا يمكن الحديث عن النور الإلهي إلا بوصفه تجسدًا ديناميكيًا. فالله في محبته لا يرسل نورًا كمجرد إشعاع عقلاني، بل يعطي ذاته في الكلمة، لتصير المعرفة فعل علاقة، لا مع مضمون، بل مع شخص. وهكذا، الكلمة تفيض بالنور لأنه هو النور، لا لأنه ينقل نورًا. وبهذا المنطق، يتجاوز كليمندس أي فهم معرفي للألوهة محصور في التجريد العقلي، ويفتح الباب أمام معرفة وجودية استعلانية يكون فيها الله معروفًا في ذاته، لا كفكرة، بل كحضور.
2. السلوك الأخلاقي: النور كقابلية داخلية
يربط كليمندس بين النور الإلهي وبين التهيؤ الداخلي للروح البشرية. أي أن المعرفة الإلهية لا تُمنح إلا لمن صار في ذاته نورًا. لذلك، يقدم السلوك الأخلاقي لا كمجموعة من القواعد، بل كجهد كياني ينقي الإدراك ويوسّع القلب ليتسع للنور.
وفي هذا، يتماهى الطهر الأخلاقي مع القابلية النورانية، حيث يصبح السلوك الصالح شرطًا وجوديًا للقاء الله، لا مجرد التزام أخلاقي. فالخطيئة ليست فقط خرقًا للشريعة، بل حجب للنور الداخلي، والطهارة ليست مجرد فضيلة، بل هي الشكل الأول للاستنارة.
3. الكتب المقدسة والتقليد: النور كتاريخ حي
أما الكتب المقدسة والتقليد الكنسي، فهما عند كليمندس الشكلان التاريخيان لحضور النور في الزمن. فالله ينير العالم لا فقط عبر العقل الفردي، بل عبر جماعة حاملة للحق، قادرة على حفظه ومنحه. الكتاب المقدس هو سجل النور المتكلم، والتقليد هو ذاكرته الحية. لكنه ليس نصًّا مغلقًا، بل يتطلب تأويلاً روحيًا لا يتم إلا في سياق الصلاة والإيمان والمحبة. فالتقليد ليس تكرارًا ميكانيكيًا للماضي، بل استمرارية استنارية، حيث ينمو فهم الإنسان للنور بقدر ما ينمو في حياة الكنيسة.
( المسيح كنور إلهي( اللوغوس
لا يتحدث كليمندس عن النور بلغة الرموز المجردة، بل يربطها بفلسفة الكينونة والمعرفة. فالمسيح باعتباره “اللوغوس” هو الوسيط الذي من خلاله تنبع المعرفة. ولكنه ليس مجرد وسيلة عبور، بل هو مصدر المعرفة وعين حقيقتها. النور هنا ليس مجرد حالة معرفية، بل هو تحوّل وجودي: من الجهل إلى الفهم، من الظلمة إلى النور، من التبعثر إلى الاتحاد.
يقول كليمندس إن المسيح هو استنارة النفس، وبدون هذه الاستنارة لا يمكن للعقل أن يدرك الأمور الإلهية. وهذا النور ليس مفهومًا منفصلاً عن الشخص، بل هو فعل مستمر يشرق في النفس بحسب استعدادها. فالنور لا يُعطى خارج المسيح، ولا يُرى خارج العلاقة الحية معه. من هذا المنظور، يصبح المسيح الشرط الضروري لكل معرفة روحية، لأنه في ذاته يجمع بين الحقيقة الإلهية وقابلية التواصل مع الإنسان.
فمن دون المسيح تظل المعرفة مجرّدة، خرساء، وغير فعّالة. أما به، فتصير الكلمة حيّة، والنور ناطقًا، والحقيقة محبة. إن استنارة المسيح ليست معلوماتية، بل كيانية، لأنها تعيد تشكيل العقل على صورة الحق، وتقيم علاقة جديدة بين الإنسان والله، قوامها الشركة لا المراقبة، النور لا الغموض.
في هذا السياق، يرتبط النور الإلهي بالمسيح، بالنعمة التي تهيئ النفس لتقبل النور، وبالإيمان كبوابة استنارة، لا كتصديق فكري فحسب. فالمعرفة هي اتحاد بالله، لا اكتساب نظري فقط. هكذا لا يكون المسيح مجرد مرشد إلى النور، بل هو النور الذي به نُبصر النور، وفيه يتم تجاوز التفرقة بين ما هو عقلي وما هو إيماني، حيث إن المعرفة بالله لا تقوم بوسائط منفصلة، بل عبر الحضور الإلهي ذاته، كما انكشف في اللوغوس المتجسد.
ويعود كليمندس ليؤكد أن الإنسان يستمد قوته من المسيح لكي يكون ذهنه راسيًا في مرفأ النور الإلهي، مستقِرًا في تلك المعرفة، وأنه دائم الصلاة لله، وفي الوقت نفسه شريك ومشارك مع المسيح، الذي ينال منه نور الله وفرحًا دائمًا. وهنا تُعرّف الحياة المسيحية بأنها حياة تبادلية، تفاعل مستمر مع الله، يحكم الفكر والعمل والكلمة، وهو ما يسميه كليمندس “حياة المسيحي وفكره”.
النور الإلهي، والإيمان، والمعرفة: بين الحضور والتحول
من منظور كليمندس، لا تُدرك الحقيقة الإلهية عبر العقل المجرد أو التأمل الخارجي، بل تُستنار النفس بنور يُمنح من خارجها ويدخلها دون أن يُلغي حريتها. هذا النور فعل إلهي غير مخلوق، يتجلى في النفس كمشاركة في حياة الله. ولكي يُستقبَل، لا يكفي أن تكون النفس قادرة على الفهم، بل يجب أن تُعاد تشكيل بنيتها الوجودية عبر الإيمان، بوصفه بوابة الاستنارة.
فالإيمان ليس حالة نفسية، أو تصديقًا فكريًا، بل انفتاح كياني على النور، واستعداد داخلي لقبوله، ذلك النور الذي يتجاوز الطبيعة والعقل. إنها النقطة التي تلتقي فيها حرية الإنسان بمبادرة الله، حيث لا يُنتج الإنسان النور، بل يستقبله. ومن هنا، تصبح المعرفة في مفهوم كليمندس فعلاً نورانيًا، لا عقلانيًا صرفًا، حيث يتحول العارف إلى مستنير، ويصبح الكائن في ذاته نورًا.
ويقول: “كما تُضاء الغرفة لا لأن فيها نورًا، بل لأن النور قد دخلها، هكذا النفس لا تُبصر الحق لأنها تعرفه، بل لأنها أُصيبت به، فأصبح فيها، ومن خلالها يُرى”.
روحانية النور الإلهي: حركة النفس نحو الله
في فكر كليمندس، لا يُفهم النور الإلهي كحدث لحظي أو مجرد كشف معرفي، بل كمسار وجودي تتبعه النفس، يتسم بالتحول المستمر والارتفاع التدريجي نحو الكمال الإلهي. النور لا يُنير فحسب، بل يدعو النفس إلى الحركة، إلى السير، إلى التشبّه. هذه الحركة هي “روحانية النور”: مسار داخلي لا يقوم على الجهد الإنساني وحده، ولا على النعمة فقط، بل على التفاعل بين عطية الله واستجابة الإنسان.
فالنور لا يُبقي النفس ساكنة، بل يُشعل فيها توقًا لما هو أعلى، ويوقظ فيها الذاكرة الإلهية، ويحثّها على العودة إلى الأصل، إلى الحقيقة، إلى الواحد. يقول كليمندس: “النور يعطي المعرفة، والمعرفة توقظ المحبة، والمحبة تُطلق النفس نحو الله”.
هذه الروحانية ليست عاطفية، بل فلسفية، بمعنى أنها سلوك الكائن نحو غايته القصوى. فالنفس لا تكتمل إلا إذا اتحدت بما يُضيء كيانها من الداخل. وبما أن النور الذي تستقبله هو من طبيعة إلهية، فإن النفس في نهايتها لا تعود فقط تعرف الله، بل تشترك في نوره، وفي فرحه، وفي حياته. وهكذا ندخل في هذه الحالة من التأمل، وكما أن النار تُحوّل ما تلمسه إلى نار، كذلك النور الإلهي لا يستقر في النفس دون أن يُحوّلها إلى ما هو منه.
المحبة الثالوثية والنور الإلهي: الإشراق الذي ينبثق من الوحدة
في رؤية كليمندس، لا يمكن فصل النور الإلهي عن المحبة، لأن النور ليس مجرد طاقة عقلية، بل هو فيض محبة نابع من الله الواحد في ذاته، الثالوث في علاقاته. فالنور، بما هو إعلان إلهي، لا ينبثق من مجرد عقل مفارق، بل من علاقة محبة أبدية بين الآب والابن والروح القدس.
المحبة في هذا السياق ليست شعورًا، بل حقيقة أنطولوجية، وهي ما يجعل النور نورًا، والحياة حياة. فالله يُضيء لأنه يُحب، ويُحب لأنه في ذاته شركة وجود لا انقسام فيها. ومن هذه الشركة ينبثق النور، لا ككائن خارجي، بل كفاعل داخلي أزلي، يُعلن الله للخلق، ويدعوهم للدخول في هذه المحبة.
في هذا الإطار، الابن (اللوغوس) هو النور الذي يُعلن الآب، لكنه لا يُعلن معرفة باردة، بل معرفة مشبعة بالمحبة، لأن كل ما في اللوغوس هو انعكاس لما في الآب. والروح القدس هو الذي ينقل هذا النور إلى النفس، لا كضوء يُبهر، بل كمحبة تُنير وتُحوّل.
ولذلك، لا تُدرك النفس هذا النور خارج السياق الثالوثي: فالآب هو مصدر النور، الابن شعاعه وكلمته، والروح القدس هو الذي يسكبه في داخل النفس. وبهذا تصبح المحبة هي الشرط الداخلي للرؤية، أي إن من لا يُحب لا يُبصر، ومن لا يدخل في محبة الله لا يمكن أن يتشرب نوره. فالنور ليس معرفة عقلية فقط، بل هو شركة في الحياة الثالوثية، حيث يُولد الإنسان من جديد، لا بعقله، بل بكينونته.
في النهاية، إن الإنسان في هذه الرؤية الفريدة التي يقدمها كليمندس السكندري، لا يُدعى فقط إلى أن يعرف الله، بل إلى أن يُصبح نورًا، كما أن الله نور. فالمعرفة لا تنتهي عند حدود العقل، بل تعيد صياغة الكيان كله، حيث يصبح الإنسان مرآة تعكس الله، لا عبر التشابه، بل عبر الحضور، حيث لا يعود النور مفهومًا، بل واقعًا يُرى ويُعاش. وكل من دخل هذا النور، لم يعد يتكلم عن الله فحسب، بل صار كيانه يشهد لله.
1 Britannica, E. (n.d.). *Clement of Alexandria*- Encyclopedia Britannica. Retrieved from
[https://www.britannica.com/biography/Clement-of-Alexandria](https://www.britannica.com/biography/Clement-of-Alexandria)
2 .كليمندس السكندري: موسوعة عظماء المسيحية في التاريخ للراهب جورچ رحمه. ص. 100، 111.
3 Osborn, E. (2005).Clement of Alexandria. Cambridge University Press.p 276
4. Lilla, S. R. C. (1971). Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford University Press.
5.Clement of Alexandria. Miscellanies (Stromata)
6.clement of Alexandria and the beginnings of Christian apophaticism Oxford early Chris
tian studies.
7. The theology of Clement of Alexandria by Edward M.sausaman 1939