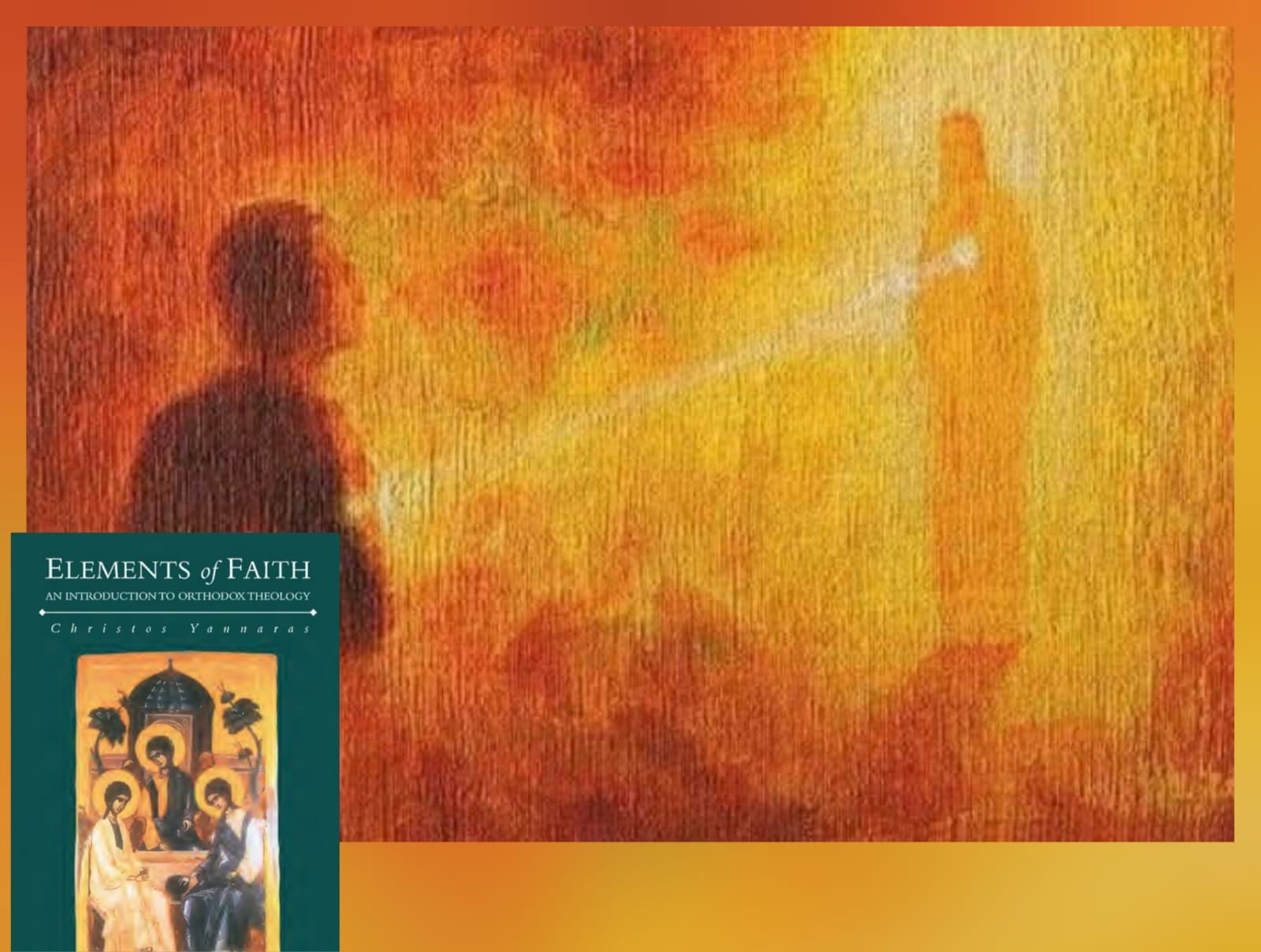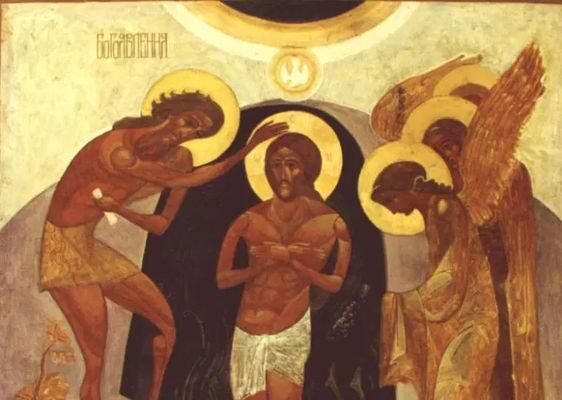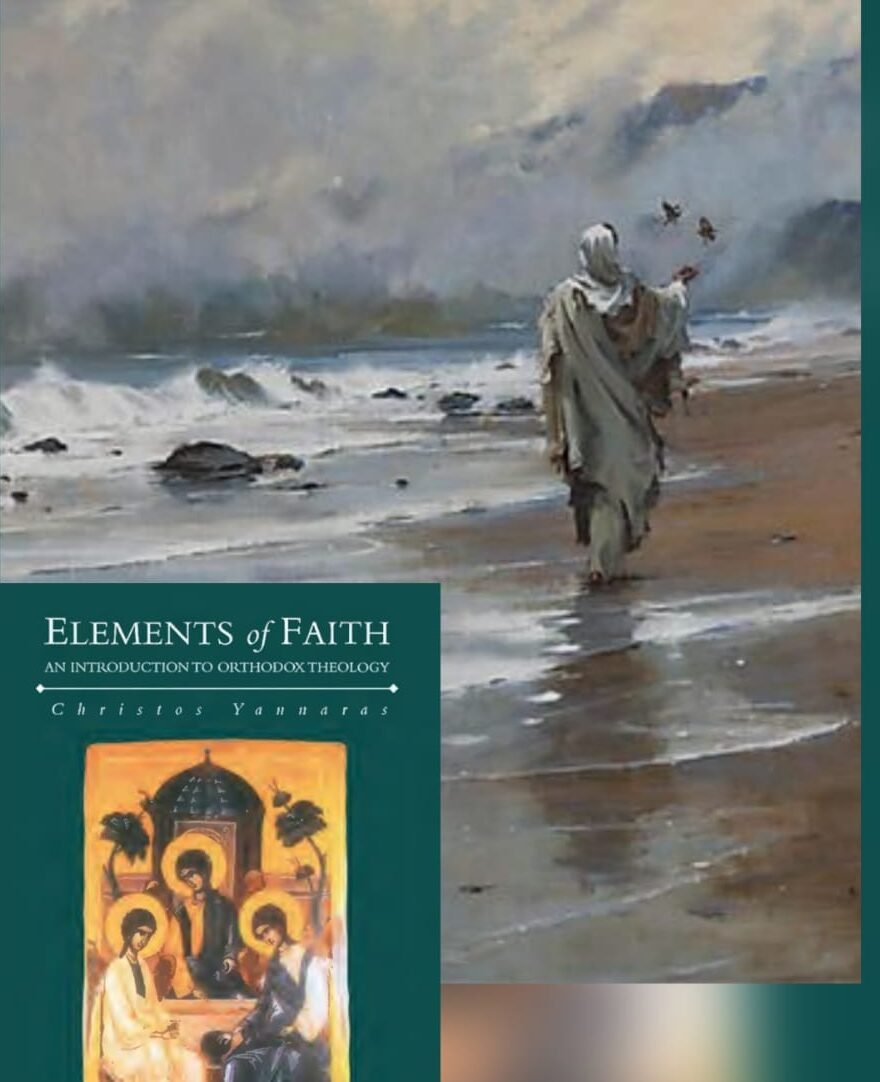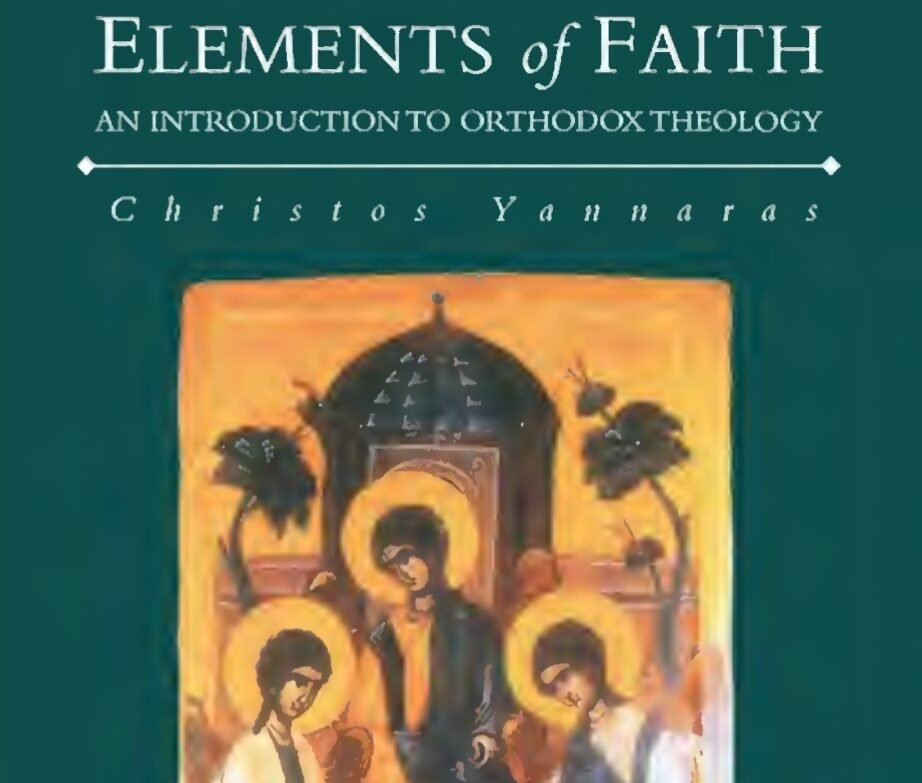مقدمة:
في عدة مقالات نقوم بترجمة ونشر أجزاء من كتاب الكأس السوداء: تأملات في الروحانية الأرثوذكسية للأم تكلا. هذا المقال الأول هو جزء من مقدمة الكتاب، وهي نص مطول وعميق، ويحوي تلخيصًا بغير إخلال لكثير من النقاط الجوهرية في التقليد الأرثوذكسي بحث لا يمكن إغفاله أو العبور عنه كمجرد مقدمة عادية لأي كتاب. بنعمة الثالوث القدوس نترجم لاحقًا أجزاء مختارة من متن الكتاب نفسه.
أما عن الأم تكلا، فهي روسية المولد، وُلدت باسم مارينا شارف Marina Sharf في 18 يوليو 1918. بعد الثورة الشيوعية في روسيا هربت مع عائلتها إلى إنجلترا، ودرست في جامعة كامبردج وتخصصت في اللغة الإنجليزية، وعملت كمعلمة في مدرسة للبنات. أختارت طريق الرهبنة وصارت راهبة أرثوذكسية مع الجماعة الأنجليكانية في دير القديسة مريم في ويست مالينغ بكنت The Anglican Community of St. Mary’s Abbey at West Malling in Kent. لاحقًا وبمساعدة الدير، وُجد منزل للأم تكلا والأم ماريا -معلمتها وأمها الروحية والتي كان لها تأثير بالغ عليها- حيث استقرتا كـ”أم روحية وتلميذة”، تعيشان حياة شبه صامتة، تُكرّس النهار والليل “لعمل القلب والعقل”. ثم انضمت إليهما الأخت كاثرين، وأسسوا معًا ديرالصعود في يوركشاير. أنتقلت الأم تكلا يوم 7 أغسطس 2011.
في هذا النص العميق والصادق، تُشارك الأم تكلا تجربة شخصية وتأملات روحية حول سرّ الإيمان الأرثوذكسي وتقليده الحي. ومن موقعها كراهبة لا تسعى إلى التنظير اللاهوتي ولا إلى كتابة التاريخ الكنسي، تُقدّم شهادة قلبية حية تنبض بالولاء للتقليد، كما عاشته وتعلّمته. تنقل القارئ إلى قلب الروح الأرثوذكسية، المتمسكة بثبات الروح القدس وتعاليم الكنيسة الأولى، والرافضة لكلّ ما يطمس حضور الله الحيّ وسط التقلبات الثقافية والفكرية الحديثة.
تلخيص:
يتناول النص موقع التقليد الروحي في الحياة الأرثوذكسية من خلال تأملات شخصية ووجودية، تبدأ باعتراف الكاتبة بمحدودية معرفتها الأكاديمية، وتؤكد أنّ التقليد يُنقل بالعيش والشهادة، لا بالاستشهادات الأكاديمية. تُحدّد النقطة الجوهرية في التمايز بين اللاهوت الأرثوذكسي والفكر الغربي المعاصر في الموقف من الروح القدس: فهو ليس مفهومًا متكيّفًا مع تطورات العالم، بل هو شخصٌ إلهيّ لا يحدّه زمان ولا مكان، والشخص لا يُعرف إلا في إطار علاقة شخصية، وهو ميزان الحقّ الإلهي في وجه تبدّلات الإنسان وتطاوله المعرفيّ.
ينتقل النص للتأكيد على جوهرية الألم في الروحانية الأرثوذكسية، التي ترى في الصليب والوجع تكريسًا للمعنى، لا عائقًا للسعادة. فالألم مبارك ومقدس، وانكسار الإنسان هو موضع للنعمة أكثر من انتصاراته الزائفة. ويمتدّ هذا الفهم إلى تعاطف الأرثوذكسيين مع المهمّشين والمنبوذين، بوصفهم مواضع ممجدة لحضور الله. يُشدِّد النص على ضرورة حفظ التقليد في التفاصيل اليومية: من الأيقونات، والألحان، واللغة، والتعبير، وصولًا إلى ترتيب العبادة. كلّ هذه المظاهر، وإن بدت شكلية، هي حاملات للجوهر، وإهمالها يفتح الباب للانزلاق من الإيمان الحيّ إلى تكيّف ثقافيّ مُمِيت.
ويختتم النص بإعلان واضح: لا تغيير. فالتمسّك بالتقليد هو في جوهره تمسّكٌ بالروح القدس، ورفضٌ لتطويع الإلهيّ بمنطق العقل البشريّ. فالإيمان الأرثوذكسي ليس ماضويًا، بل حيٌّ الآن، حيّ بالروح، ولا يُحفظ حيًّا إلا بواسطة هذا الروح عينه الذي يربط الأزل بالزمن، ويُبقينا، رغم ضعفنا، واقفين في حضور الله الحيّ.
الترجمة:
كيف لي أن أجرؤ على أن أكتب تمهيدًا لموقف الإيمان الأرثوذكسي؟ فلستُ لاهوتيةً، ولا مؤرِّخةً كنيسة، وإنما أنا راهبةٌ أرثوذكسية فحسب. أفَيَكون هذا هو السر؟ إليك سرٌ أخر: حين كتبت الأم ماريا، مؤسِّسة ديرنا في إنجلترا وأمّي الروحية، كتابها “الكنز المخفي”، دفعته إلى كاهنٍ عالمٍ لاهوتي كي يُبدي رأيه فيه. قرأه ذلك الكاهن باهتمامٍ بالغ، ثم أشار عليها أن تُثبت المراجع التي نقلت عنها من أقوال الآباء. أما الأم ماريا فلم تقل شيئًا. كان الجواب بسيطًا: إنها لم تكن قد قرأتهم أصلًا إعدادًا لكتابها، ولم يكن “الكنز المخفي” تلخيصًا منتقى من أحد آباء الكنيسة على وجه التعيين. أقول “على وجه التعيين”، لأن الآباء قد حَمَلوا التقليدَ، وصانوه، وسُفكت دماؤهم في سبيله، وهو التقليد عينه الذي يرثه كلّ واحدٍ منا، من أحكم الحكماء إلى أبسط البسطاء، ويصونه بحسب ما أُوتي من قدرة.
ما هو هذا التقليد، الذي هو -حتى بغير وعيٍ منّا- ميراثُنا الشخصي، وأساسُ إيماننا، وأصلٌ لما يقوم عليه كثيرٌ من عاداتنا اليومية وعملنا الروحي؟
أقول: أولًا وقبل كل شيء، إن الفجوة – أيًّا ما كانت هذه الفجوة – بيننا وبين الغرب، إنما تكمن في أصلها في موقفنا من الروح القدس. فالروح القدس، في نظرنا، لا شأن له بالقرن ولا بالمكان الذي نعيش فيه. الروح القدس لا يمتّ بصلة إلى الأخلاق السائدة، محليّةً كانت أو معاصرة، ولا إلى غياب هذه الأخلاق، ولا إلى نظرةٍ “مستنيرة” إلى الجنس أو القتل، ولا هو يتصل بالنظريات الحديثة في علم النفس، أو التربية، أو اللغة الدارجة، بل ليس له ارتباطٌ بأي أمرٍ من الأمور التي تعكس تغيّر العالم عبر الأجيال، تغيّراتٍ مؤسسةً على تجارب علمية متجددة في شتى ميادين الحياة اليومية.
إنّ “روحنا القدس” هو شخص. شخصٌ من الثالوث الأقدس، الذي، على الرغم من تغيّر العالم، وتقلّب الأهواء، وزعم “التقدُم”، يُثبِّتنا راسخين، بقدمٍ واحدة -إن لم يكن بكليهما- في ذلك الموضع السريّ، حيث يتقاطع الزمان بالأبدية. روحنا القدس يُنكر أن تكون الحقيقة عرضة للتبدُل بين جيلٍ وآخر، ويُبطل دعوى المعرفة البشرية. روحنا القدس، كـالآب نفسه، لا يُدرَك، ولا يُعرَف، ولا يُلمَس. هو الترياق لكلّ ما هو موجود في هذا العالم وزائل. هو الجواب الإلهيّ على كلّ غوايةٍ من إبليس، تُريد أن تُلبِس الغايةَ الروحية لبوسَ الشهوة الماديّة، فتخلط بين الحبّ الإلهيّ والحبّ الإنسانيّ، بين الله والإنسان. إنّ الروح القدس هو جوهر الشهادة، هو القوّة، والجرأة، والبأس في أن نُصرّ -رغم كلّ ما يفرضه الزمان من مواضعات- على أن يكون الله أولًا، والإنسان ثانيًا. الروح القدس، إن جاز لي التعبير، هو ميزاننا الذي يُقاوم كبرياء الإنسان، ذاك الكبرياء الذي لا يزال، بوهمٍ واستحقاقٍ موهوم، يطلب فردوسًا على الأرض. وهكذا نصل إلى سِرّ الألم.
إحدى الوجوه الموروثة في الأرثوذكسيّة هي رفض السعادة كحقٍّ مُكتَسب. ولا يعني هذا أنّنا، في الواقع، لا نسعى لتخفيف الألم، بل إنّما نعترض على تلك النزعة التي تطالب بسعادةٍ دنيويّةٍ صرفةٍ. نحن نتمسّك بتلك التجربة: تجربة المسيح في البرية حين رفض، مرةً وإلى الأبد، فردوس العالم. ونتشبّث، على وجه الخصوص، بعكس ما يُسمّى بالنعيم الأرضي: بسرّ الصليب، ذلك السرّ الأبديّ الذي لا يزال يحمل في طيّاته مغزى الألم ومعناه. بطريقةٍ ما -لا نعلم كيف على وجه التحديد، ولكن بطريقةٍ ما- الألم مُبارك. إنّ الميل الروسيّ إلى اعتبار أي إنسان في حضيض البؤس مختارًا على وجهٍ خاص من الله، والرأفة التي تُبديها النفس الروسية نحو البغايا، والشفقة على المجرم المقيّد بالسلاسل وهو يسير إلى منفاه الطويل في سيبيريا، كلّ ذلك ينبع من التماهي الإيجابيّ مع الألم، أيًّا كان نوعه، في سياق التقليد المسيحيّ. الضعفاء عقليًا، الحمقى، المتشرّدون، المنبوذون على اختلاف صنوفهم -هم أولى الناس بشفقتنا، ليس بالرغم من رفضهم أو جهلهم لروح الحقّ، بل بسبب ذلك عينه. إذ ليس الحكم لنا، بل الحزن على الخاطئ هو ما يُطلَب منا. هل هذا الأمر إفراط في العاطفيّة؟ لعلّه كذلك. وربّما بالغ بعضهم فيه. لكن مع ذلك فإنّ الامتناع عن الحكم بحسب معيار العالم، هو عملُ الروح القدس فينا: روح الحقّ، روح الفهم، العامل في قلب كلٍّ منّا.
التقليد:
ولكن كيف نحرص على أن نظلّ في كنف هذا التقليد؟ لا نملك إلا أن نعمل على نطاق ضيّق، في حياتنا اليومية البسيطة. ومن خلال معرفة الروح القدس، ومن خلال معرفة التقليد، نعين أنفسنا، ونستنفر في معونتنا كلّ ما في التقليد من وجوه، حتى تلك التي تبدو غير مهمّة أو ثانويّة في ظاهرها. إنّ الأمور الصغيرة -التي قد يُظنّ بها أنها مجرّد مظاهر عصرية أو “زينة” شكلية- نستخدمها نحن كأدوات تعيننا على التمسّك بالتقليد. ونرفض التغيير رفضًا مبدئيًّا، لأن فتح الباب للتغيير، ولو يسيرًا، يُفضي إلى تتابُع تغيّراتٍ تتراكض وتتعاقب، بحجّة مجاراة الأجيال الجديدة، وباسم التكيّف مع “الحقوق الإنسانية”، على حساب التمسك بالحقّ الواحد الثابت الذي لا يتبدّل. فإذا نحن ألقينا بالتقليد، عبر تجاهلنا للـ”تقليد” -مهما بدا قديمًا، أو غير دارج، أو حتى مُضحكًا – فقد فتحنا بذلك بوّابة السيل التي تصرف أنظار قلوبنا عن وجه المسيح في عُري فقرنا، لتوجّهها نحو السعادة، والرضى، والاكتفاء، والتحقُّق، وكلّها أمور تُناقض أشدّ التناقض الوقوف الحقّ أمام المسيح. لذلك نتجنّب التغيير -أو على الأقل نحاول ألّا نُغيّر- وإن غيّرنا، التمسنا لذلك العذر في حدود الضرورة الإنسانية، لا أن نُبرّر التغيير فنرمي به على الروح القدس، وكأنّه هو من ابتدع هذا الابتكار.
ولكن كيف لي أن أبدأ -ولو تلميحًا- في توضيح هذا السرّ العظيم، سرّ التقليد في الحياة الأرثوذكسية اليومية؟
لدينا تقليد الأيقونات: الإيمان بأنّ المسيح نفسه بارك الأيقونة الأولى، وأنّه ينبغي لنا أن نُبقي دائمًا حضور الله وأمّه وقدّيسيه بيننا. إنّها تُجسِّد شركة القديسين -حيث لا حاجزَ بين الأحياء والأموات، بل هي شركة واحدة، متّصلة، لا تنفصم- فتُقدِّم لنا الأيقونات عزاء ضد الوحدة، وتُثبِّتنا على معرفةٍ تقول إنّه لا حاجة بنا إلى أن نشعر بالوحدة أبدًا، ولا بالخذلان، ولا بحرمانٍ من الأبد، وذلك في خضمّ حياتنا الزائلة المؤقّتة. لسنا مَنْ تُلقي بهم الرياحُ في لجّة القيم البشرية المتقلّبة، بل إنّ أيقوناتنا تُمسك بأيدينا على تخوم الحياة. وما هي الحياة؟! هي اليد الإلهية الممتدّة إلى بطرس في البحر. وبمعونة الأيقونات، نتذكّر -لا بفتورٍ، بل بيقظةٍ وحرارة- أنّ هنالك شركة واحدة، أنّ الموتى يتشفّعون من أجلنا، كما نتشفّع نحن من أجلهم، وأنّنا نُحبّ موتانا بعد رقودهم كما أحببناهم في حياتهم، وهم يرقدون في التراب بيننا -بعد أن شاركونا في ليتورجيا أخيرة- في حضن الكنيسة، لا في صالات دفنٍ مُنمّقة مُعقّمة من الروح!
وكما هو الحال في الأيقونات -التي لا يجوز رسمها إلّا ضمن إطار التقليد، خاليةً من النزعات الذاتية والانحرافات العصرية الفردية- كذلك الأمر في موسيقانا: فلا مكان فيها للآلات، بل الصوت البشريّ وحده هو المكرَّس للعبادة، وصوتُنا لا يسير إلّا على نغمات الألحان الثمانية، الموروثة أبًا عن جدّ، جيلًا بعد جيل. وهكذا أيضًا في التعبير اللفظي عن إيماننا -في كلمات العبادة- ما أصدقَها ينبغي أن تكون، إذ هي التجلي اللفظي المنطوق للـ “حق”، وإن كان ذلك ضمن حدود اللغة البشرية. وأحد الإشكالات الجديّة التي تواجهنا هو غِنى اللغة الإنجليزية بتعدّد مصطلحاتها وتفريعاتها، وما يترتّب على ذلك من إغراءٍ باستعمال عبارات عقائدية دقيقة لا وجود لها في النصوص الأصلية. فالمسيح، إلهنا، في ترتيلة “الثلاث تقديسات” الأرثوذكسية، حين نُنشِدها أو نُصلّيها، ليس هو “immortal” (أي خالدًا بحسب المفهوم الفلسفيّ)، بل هو “deathless” (أي غير مائت) وهذه ليست صياغة عقيدة، بل إعلان إيمان.
حتى العبادة في الكنيسة الأرثوذكسية لها طابعها التقليديّ أو بالأحرى، لها طابعها الذي يخلو من النمطية الصارمة والتنظيم العسكريّ. نحن نقف أمام المسيح، ونُسرع إلى المناولة كما كانت الجموع تُزاحمه في الطريق، ولا مجال لصفوفٍ منظّمة أو طوابير منضبطة! لا مقاعد عندنا، فالكنيسة برمّتها سماءٌ على الأرض، وفيها نحن أحرار في أن نطوف، وأن نُسلِّم على القدّيسين الذين نُحبّهم في الأيقونات، وأن نصغي إلى الترتيل، وكلّ ذلك في أحضان شركة القديسين الأحياء منهم والأموات، إذ نُشعل الشموع من أجل الذين نحبّهم، سواء أكانوا بيننا في الجسد، أم عبروا إلى الراحة الأبدية.
كلّ كلمة من كلمات الخدمات الكنسية تبقى على حالها دون تغيير، إلا -ويا للأسف- بعض الترجمات الإنجليزية التي اعتراها شيءٌ من التفرّد أو التصرّف! أما اليونانية والسلافونية، فقد اندمجتا أحيانًا على نحوٍ متناغم، وأحيانًا على نحوٍ لا يُفهَم تمامًا! ومع ذلك، فإنّه أينما أُقيمت خدمة أرثوذكسية، فاللغة تصبح أمرًا ثانويًّا، إذ نعرف تمامًا أين نحن، متى ما كنّا متمرّسين بأيّ لغة من لغات الأرثوذكس.
لا تغيير. فذاك، عندنا، هو العمل الأسمى للروح القدس. التمسُّك بالحق، وإن كان على غير تمام الكفاية؛ واجتناب التدخّل البشريّ في ما هو إلهيّ، وفي المحاولة العقيمة لجعل ما لا يُدرَك قابلًا للإدراك، وفي إخضاع الكلمة غير المعقولة (اللوغوس) لمنطق العقل البشريّ. إنّ إيماننا الأرثوذكسيّ هو إيمانٌ حيّ، ولا يُقال هذا كثيرًا أمام جيلٍ يرى في الإيمان تابعًا لمواكبة الأزمنة. الروح القدس عاملٌ الآن – وهذا الـ”الآن” إنّما هو، في نظرنا، تقوْقُعُ الأبديّة في الزمن، تجلٍّ من تجلّيات السخاء الإلهيّ. وليس لنا من سبيل إلى إبقاء تعليم المسيح حيًّا إلا بالروح. وهنا، لعلّه يحسن بي أن أوضّح أمرًا لا يحتاج، في منظورنا، إلى توضيح.