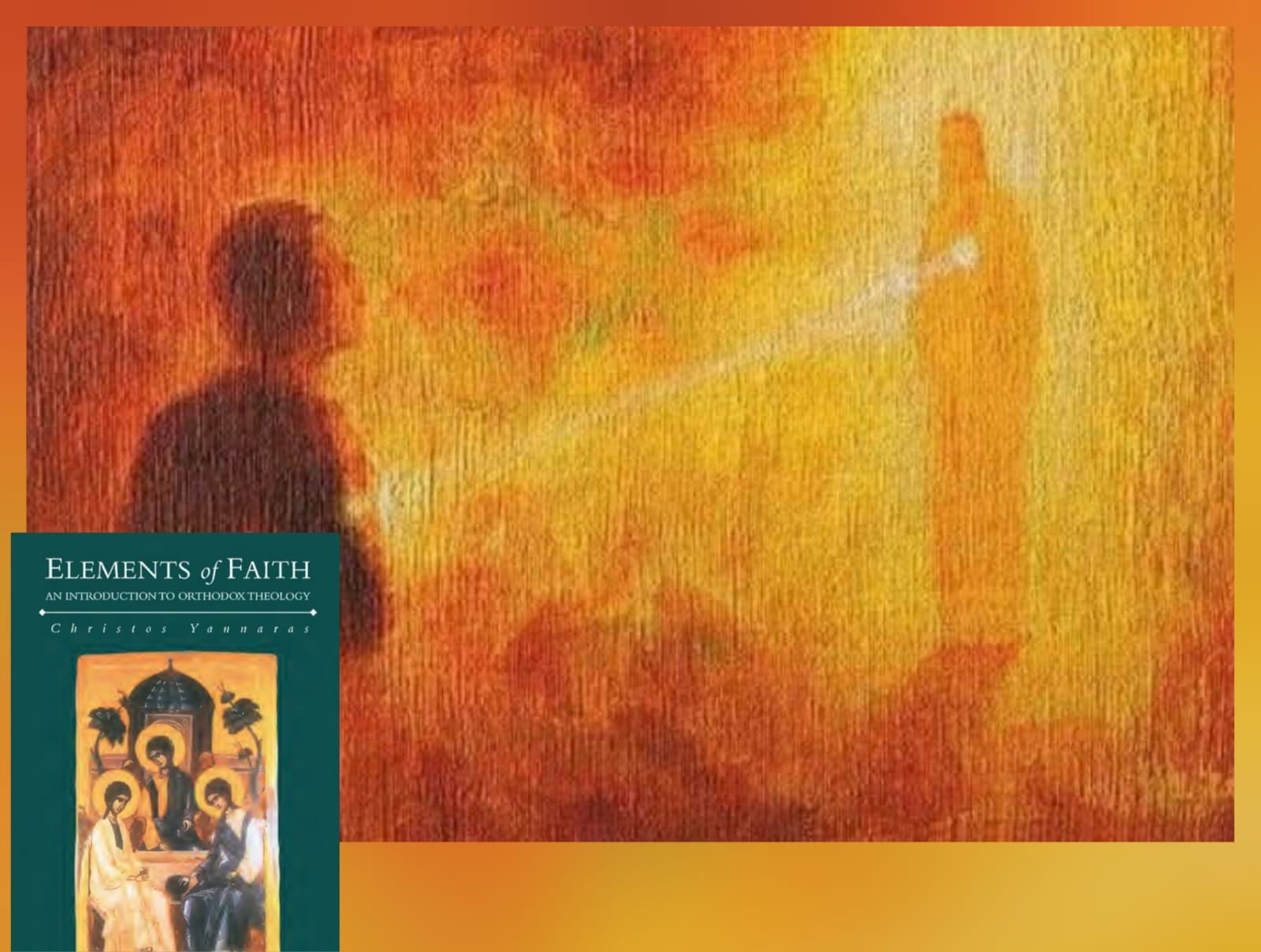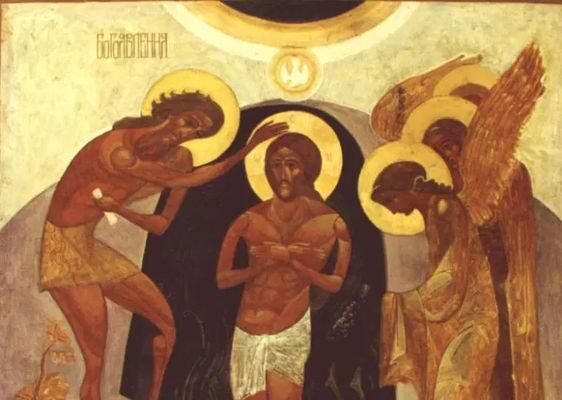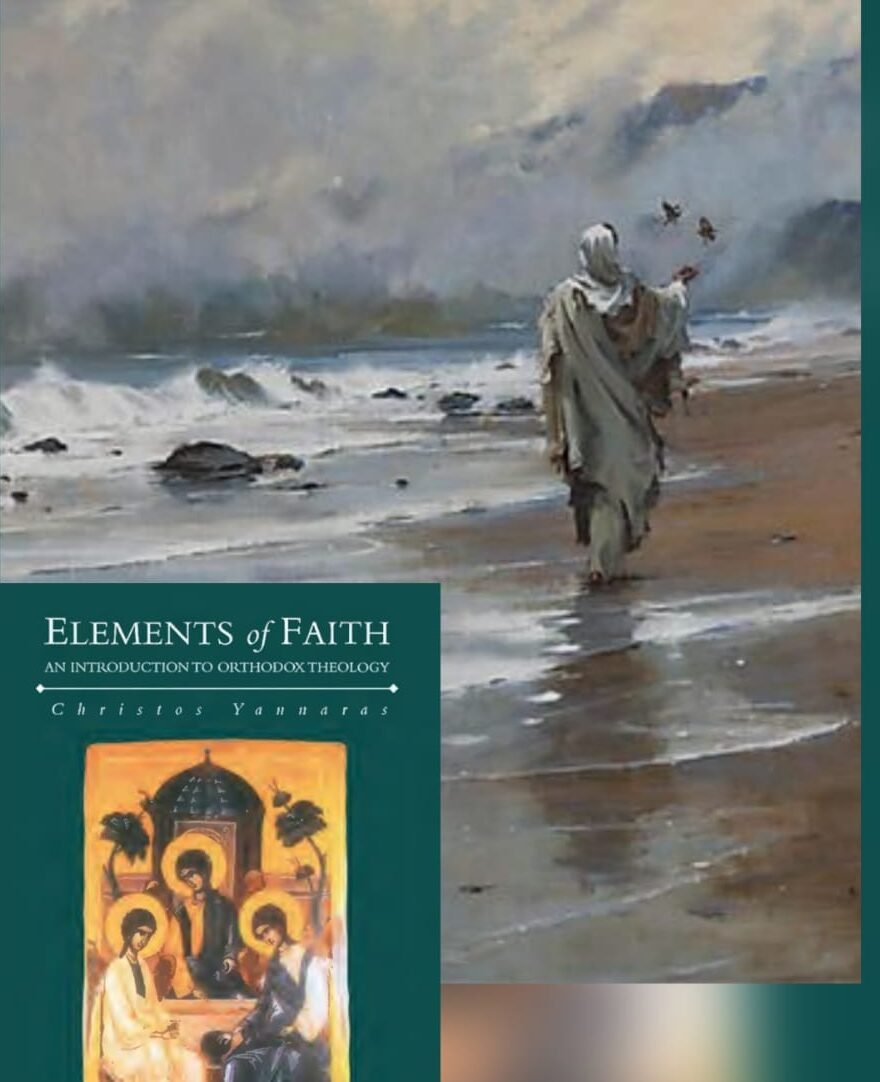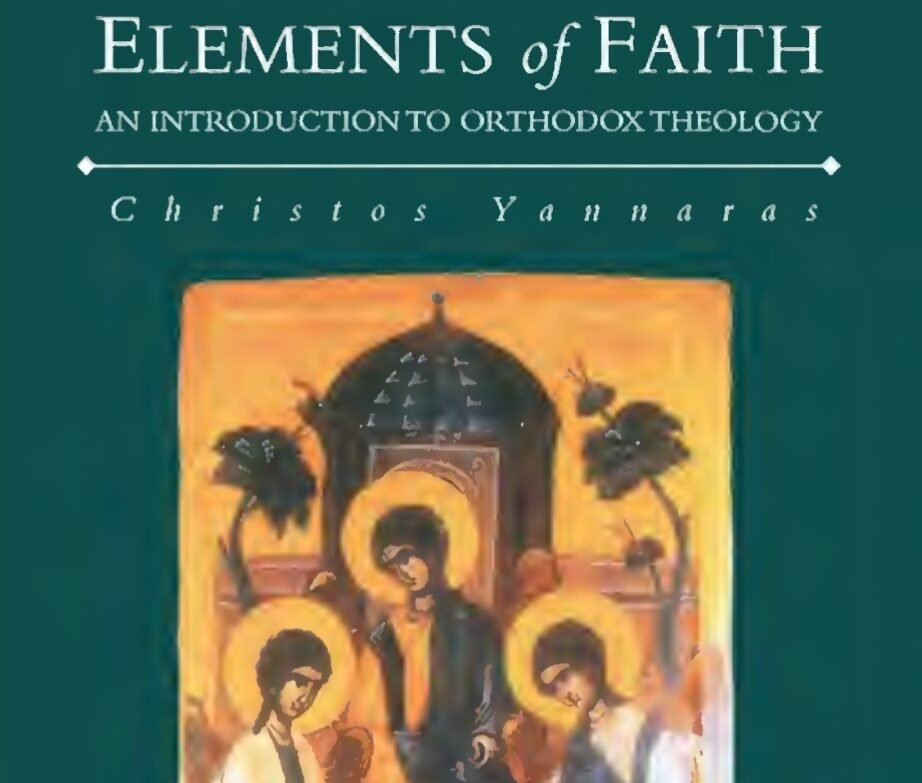يؤكد البروفيسور هستنجس راشدال (لاهوتي بروتستانتي) على تعليم القديس أثناسيوس بعقيدة التجسد غير المشروط من أجل إعطاء الإنسان هبة عدم الفساد وعدم الموت كالتالي:
”يحاول ق. أثناسيوس أن يبين أن القابلية للفساد ليست عقوبة جزائية فرضها الله، بل هي نتيجة طبيعية وحتمية للخطية. لم يكن الإنسان بالطبيعة غير قابل للفساد أو غير قابل للموت، بل كان جسده، وكما يبدو بوضوح حتى نفسه العاقلة، قابلين للموت بالطبيعة. ولكن خُلق الإنسان فقط بين الحيوانات على «صورة الله»، وينبغي القول بأنه هو الوحيد الممنوح هبة العقل، التي تحمل معها فرصة الفوز بعدم الفساد من خلال الفعل الحر بحسب العقل، وكانت هذه الهبة بسبب الشركة مع اللوغوس (تجسد الكلمة ٣: ٣)“. [1]
ويعلق راشدال على الفقرة السابقة في حاشية رقم(3) قائلاً:
”يبدو أن الفقرات التالية تفترض أن أثناسيوس ظن أنه بعد السقوط، توقف الإنسان بالفعل عن أن يكون خالدًا، وأن نفوس البشر ماتت مع أجسادها، وظلت مائتة حتى أعاد عمل المسيح عدم الموت (الخلود) إلى النفس والجسد على حد السواء، بينما لا يدعم أثناسيوس (مثل أوغسطينوس) إنه لن يكون هناك موت جسدي إلا بسبب السقوط (تجسد الكلمة ٣: ٤)“. [2]
يؤكد البروفيسور راشدال في الحاشية السابقة على أن ق. أثناسيوس يختلف في تعليمه عن ق. أوغسطينوس، حيث يعلم الأخير بأنه لا يوجد أي موت سواء جسدي أو روحي قبل السقوط، وأن الموت الجسدي والروحي بسبب السقوط، بينما يعلم ق. أثناسيوس أن الموت الجسدي كان موجود قبل السقوط، طالما أخذ الإنسان جسد متغير طبيعي يأكل ويشرب وينمو ويتكاثر ويثمر، فهو بالتالي قابل للفساد الطبيعي، وبالتالي قابل للموت الطبيعي (البيولوجي الإكلينيكي)، وإلا كان جسد غير طبيعي أو فوق الطبيعي، وهذا لا يتفق مع كونه خاضعًا للاحتياجات البشرية العادية، وقابل للموت البيولوجي الطبيعي، حيث يؤكد أثناسيوس والآباء السابقين واللاحقين له أن الإنسان لم يكن خالد بالطبيعة، بل كان سيُعطى نعمة الخلود وعدم الموت باتحاد الكلمة به لكي يهبه الحياة الأبدية وعدم الموت.
يقول توماس تورانس في نفس السياق عن التجسد غير المشروط عند ق. أثناسيوس التالي:
”وكانت عملية استعادة وتجديد الخليقة هي السبب وراء تجسد كلمة الله وابنه الأزلي، الذي بأخذه طبيعتنا الضعيفة «العرضية الاعتمادية» لنفسه -وهو الأصل والمصدر الواحد لكل الكائنات المخلوقة- فإنه نقل أصلنا إلى ذاته لكي يحفظ وجودنا من الفناء والعدم (قانون الموت)، وفي نفس الوقت أخذ لنفسه طبيعتنا المنحرفة والفاسدة بما في ذلك لعنة الخطية حتى يفدينا من (حكم الموت) ويجدد كياننا في ذاته […] إذًا بصورة ما، يجب اعتبار أن الخليقة من البداية كانت متوقفة و مشروطة بالتجسد“. [3]
يفرق توماس تورانس هنا بين أمرين:
- قانون الموت؛ أي أننا مخلوقون من العدم وإننا نؤول إلى العدم والفناء بحسب طبيعتنا العرضية الاعتمادية؛ التي تعتمد على الحياة المأخوذة من الله، وبدون الله نصير عدمًا كما كنا قبل الخلق، وآدم حتى وهو في الفردوس كان معرضًا لهذا الموت الطبيعي بحسب القانون الطبيعي لطبيعته العدمية.
- حُكم الموت أي ”يوم أن تأكل منها موتًا تموت“؛ وهنا المقصود هو رفض معية الله والإبحار في الله، وأستبدل الإنسان ذلك بالإبحار في ذاته بعيدًا عن معية وشركة الله، فأوقع نفسه بإرادته تحت حكم الموت؛ كما قال ق. غريغوريوس اللاهوتي: ”أنا اجتذبت لي قضية الموت“.
يشرح القديس أثناسيوس هذه المسألة في واحدة من أهم فقرات كتاب ”تجسد الكلمة“، فيقول:
”الله صالح، بل هو بالحري مصدر الصلاح. والصالح لا يمكن أن يبخل بأي شيء وهو لا يحسد أحدًا حتى على الوجود. ولذلك خلق كل الأشياء من العدم بكلمته يسوع المسيح ربنا، وبنوع خاص تحنن على جنس البشر. ولأنه رأى عدم قدرة الإنسان أن يبقى دائمًا على الحالة التي خُلق فيها، أعطاه نعمة إضافية، فلم يكتف بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الأرض، بل خلقهم على صورته، وأعطاهم شركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما -ولهم بعض من (ظل الكلمة) وقد صاروا عقلاء- أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية، حياة القديسين في الفردوس“. [4]
يؤكد ق. أثناسيوس هنا على عدة أمور:
- خلقة الإنسان من العدم بواسطة اللوغوس أي يسوع المسيح ربنا.
- أعطى الله الإنسان نعمة إضافية وليس كما خلق الحيوانات العجماوات، بل خلقه على صورته في البر والقداسة والحكمة وإلخ.
- أعطاه شركة في قوة الكلمة، وأسماها أيضًا ظل الكلمة، وأسماها أيضًا بذرة اللوغوسΣπερματικός λόγος في كتابه ”ضد الوثنيين“، حيث يقول:
”لا أقصد باللوغوس (الأقنوم) تلك القوة الغريزية المودعة في كل الأشياء المخلوقة -التي أعتاد البعض أن يدعوها ببذرة الكلمة- والعديمة النفس والتي لا تملك المنطق والتفكير، لكنها تعمل من الظاهر حسب فطنة مَن يستخدمها“. [5]
٤.لو حفظ هذه النعمة الإضافية سيبقى في سعادة وحياة حقيقية وحياة القديسين في الفردوس، كلها مرادفات لمفهوم الشركة والمعية مع الله في الفردوس.
ثم يكمّل ق. أثناسيوس قائلاً:
”ولكن لعلمه إن إرادة البشر يمكن أن تميل إلى أحد الاتجاهين (الخير أو الشر). سبق فأمّن النعمة المعطاة لهم بوصية ومكان، فأدخلهم في فردوسه وأعطاهم وصية حتى إذا حفظوا النعمة واستمروا صالحين عاشوا في الفردوس بدون حزن أو ألم أو هّم، بالإضافة إلى الوعد بالخلود في السماء“. [6]
ويؤكد ق. أثناسيوس هنا أيضًا على عدة أمور:
- حرية الإرادة الإنسانية في اختيار الخير أي اختيار المعية والشركة الإلهية أو الشر الانفصال عن الله.
- تأمين النعمة السابقة المعطاة لهم (قوة /ظل/بذرة اللوغوس) بوصية ومكان.
- لو حافظوا على النعمة يستمرون صالحين في الفردوس بدون نتائج السقوط والعصيان (الحزن والألم والهم؛ وهي آلام نفسية صعبة أختبرها الإنسان بعد السقوط، لم تكن من قبل في طبيعته).
- ويشير ق. أثناسيوس هنا لنقطة محورية وهي ”الوعد بالخلود في السماء“، هل لو كان الإنسان مخلوق خالد بطبيعته هل يسمي ق. أثناسيوس هذا ”وعدًا“ أم يسميه حقيقة أصيلة في طبيعة الإنسان؟ ولكنه يسميه وعدًا؛ والوعد هو ما سيتحقق في المستقبل وليس في الحاضر، مما يؤكد أن الإنسان لم يكن خالدًا في الفردوس، بل كان مُعرضًا لقانون الموت الطبيعي؛ كما أسماه توماس تورانس في الفقرة أعلاه.
ثم يكمّل ق. أثناسيوس في نفس السياق قائلاً:
”أما إذا تعدوا الوصية وارتدوا (عن الخير) وصاروا أشرارًا فليعلموا أنهم سيجلبون الموت على أنفسهم بحسب طبيعتهم ولن يحيوا بعد في الفردوس، بل يموتون خارجًا عنه ويبقون إلى الأبد في الفساد والموت“. [7]
ويفرق ق. أثناسيوس هنا بين نوعين من الموت وهما:
- أ- الموت الطبيعي الذي اسماه ق. أثناسيوس ”بحسب طبيعتهم“، وأسماه تورانس ”قانون الموت“، بمعنى أن موت الإنسان كان سيحدث حتى لو لم يكن قد أخطأ لأنه بطبيعته مائت وعدمي وعرضي واعتمادي الوجود.
- ب- الموت الأبدي وهو الانفصال التام والنهائي عن الشركة الإلهية، والبقاء الأبدي في ذلك الموت خارج الفردوس؛ أي معية الله وشركته.
يكمل ق. أثناسيوس أيضًا في نفس السياق قائلاً:
”وهذا ما سبق وحذرنا منه الكتاب المقدس بفم الله قائلاً ” من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتًا تموت” و” موتًا تموت” لا تعني بالقطع مجرد الموت فقط، بل البقاء في فساد الموت إلى الأبد“. [8]
ويفرق ق. أثناسيوس هنا أيضًا بين نوعين من الموت هما:
- الأول اسماه ”الموت فقط“ وهو قانون الموت الطبيعي مما يؤكد موت الإنسان الأول في الفردوس بسبب طبيعته العدمية العرضية الاعتمادية.
- الثاني اسماه ”البقاء في الموت إلى الأبد“ وهو حكم الموت الأبدي بالانفصال عن الله بتعدي الإنسان وعصيانه.
أخيرًا، يؤكد ق. أثناسيوس على حتمية التجسد غير المشروط بعصيان وخطية آدم -والذي قال عنه تورانس: ”أن الخليقة من البداية متوقفة على أو مشروطة بالتجسد“- في قوله:
”ولو أن الله قال كلمة واحدة -بسبب قدرته- وأبطل اللعنة، لظهرت قوة الذي أعطى الأمر ولكن الإنسان كان سيظل كما كان قبل العصيان لأنه سيحصل على النعمة من الخارج دون أن تكون متحدة مع الجسد (فهذه كانت الحالة عندما وضِع في الجنة) بل ربما صارت حالته الآن أسوأ مما كان في الجنة بسبب أنه قد تعلم كيف يعصي. فلو كانت حالته هكذا وأغوي مرة أخرى بواسطة الحية لصارت هناك حاجة أخرى أن يأمر الله ويبطل اللعنة وهكذا تستمر الحاجة إلى ما لانهاية. وتظل البشر تحت الذنب بسبب استعبادهم للخطية إذ هم يقترفون الآثم. ولظلوا على الدوام لمَن يعفو عنهم ولما خلصوا قط. ولكونهم أجسادًا بحسب طبيعتهم فإنهم يظلون مقهورين دائمًا بالناموس بسبب ضعف الجسد“. [9]
ويؤكد ق. أثناسيوس هنا على قانون الموت الطبيعي الذي خُلِق الإنسان به في الفردوس، حيث كانت له وهو في الجنة نعمة خارجية (ظل اللوغوس أو بذرة اللوغوس أو قوة اللوغوس)، ولكنه كان محتاجًا للتجسد الإلهي ليعطيه النعمة داخليًا ويتحد بها، وإنه كان سيموت بحسب القانون الطبيعي (قانون الموت) حتى لو لم يخطأ، ولم يأكل من الشجرة، ويتعدى على الوصية (حكم الموت)، وهكذا بتجسد الكلمة أزال كل من قانون الموت، وحكم الموت عن البشرية كلها في جسده، وضفَّر نعمة الحياة الأبدية والخلود والتأله بالنعمة بطبيعة جسدنا؛ وهكذا نلنا الشركة الأبدية مع الله في الكلمة المتجسد.
[1] Rashdal, Hastings, The Idea of Atonement in Christian Theology, (London: MACMILLAN & CO., 1919), Lect 4, p. 296.
[2] Ibid, p.296, n.3.
[3] الإيمان بالثالوث، ص ١٤٦- ١٤٧.
[4] تجسد الكلمة ٣: ٣.
[5] ضد الوثنيين ٤٠: ٤.
[6] تجسد الكلمة ٣: ٤.
[7] المرجع السابق، ٣: ٤.
[8] المرجع السابق، 3: 6.
[9] ضد الآريوسيين ٢: ٦٥.