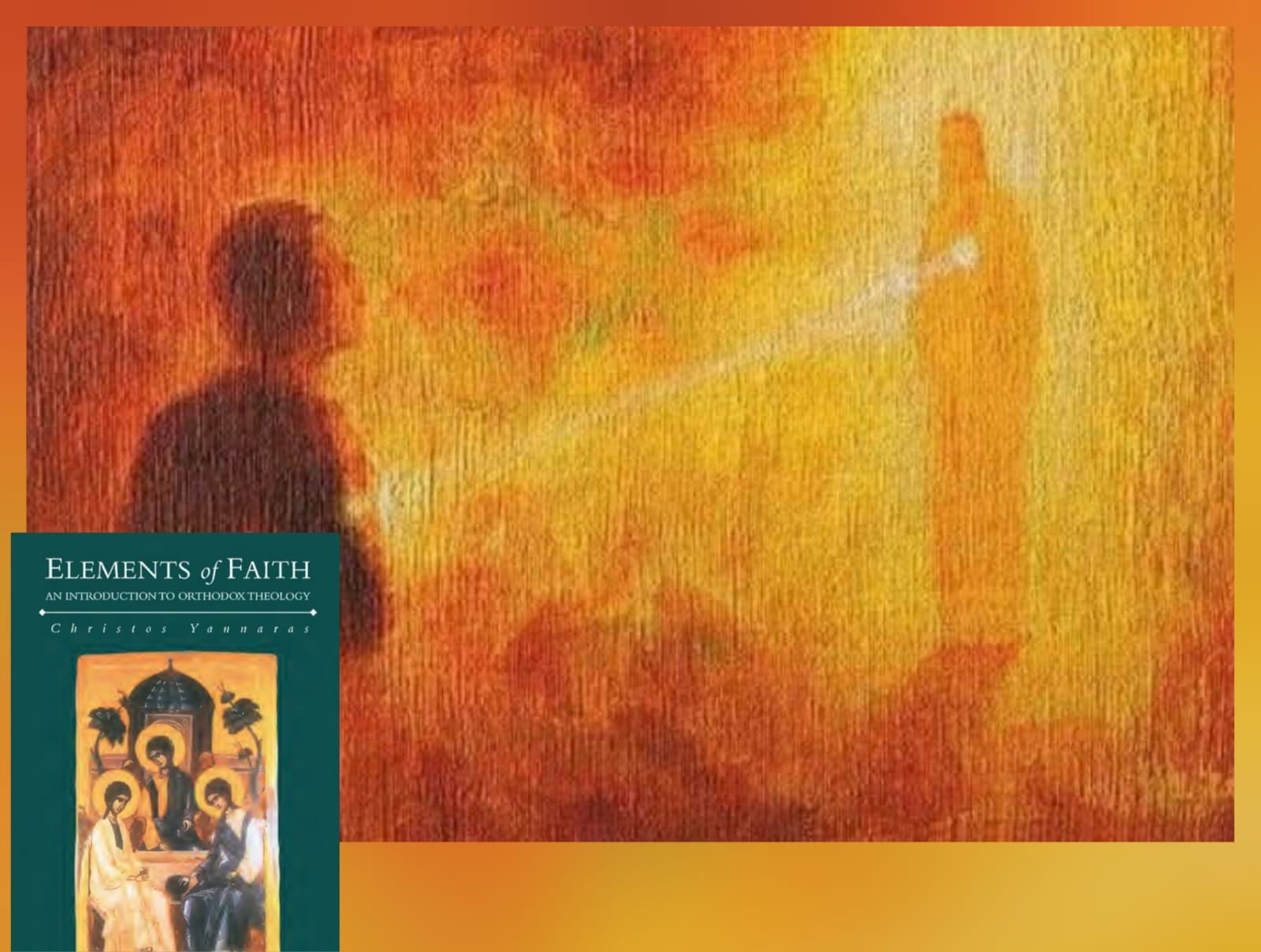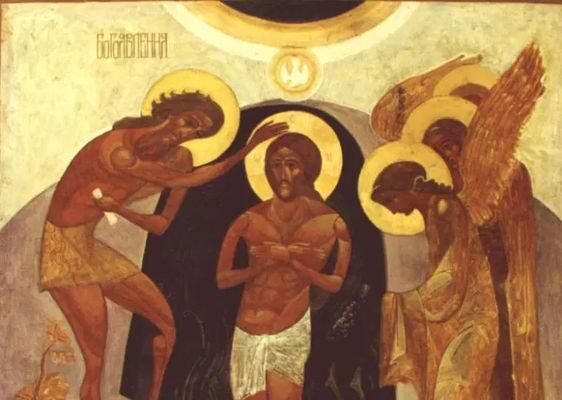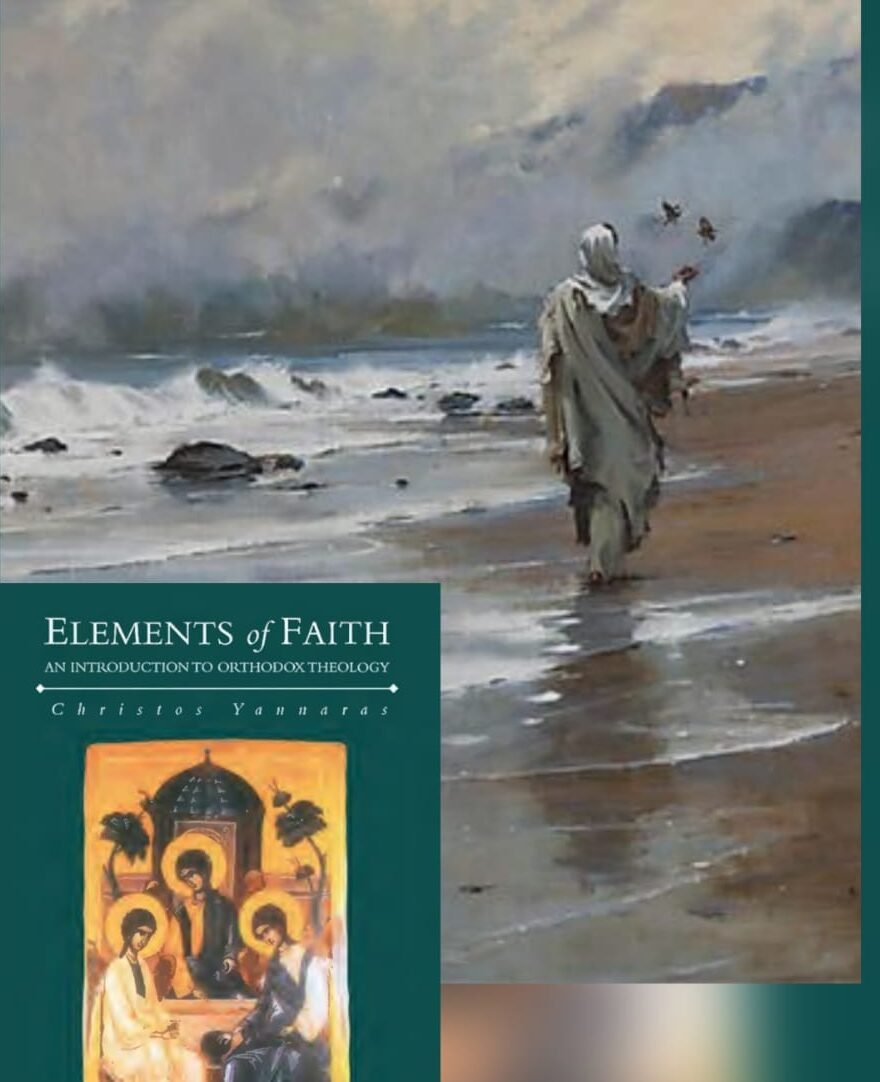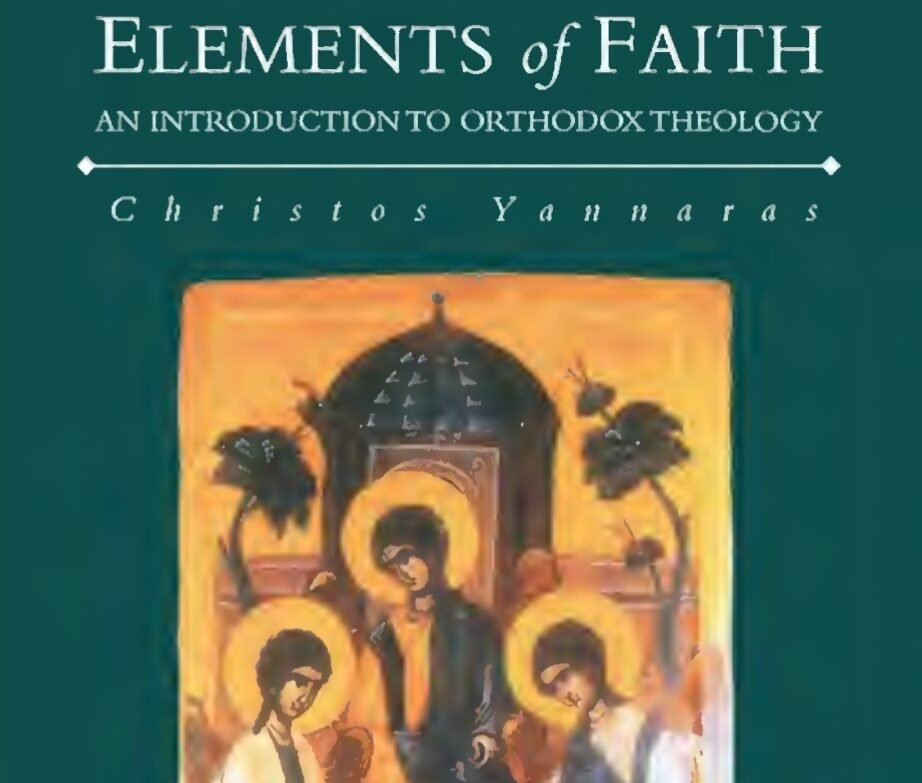في المقال السابق، فتحنا ملف “السقوط الثاني”، وكيف انزلق الفكر الغربي من سرّ الاتحاد بالحياة الإلهية إلى روح أروقة المحاكم وموازين القضاة، تحت تأثير القانون الروماني وصدى ردود أغسطينوس على بيلاجيوس. غير أنّ وحدة الكنيسة كانت قد أصيبت قبل ذلك بجراح عميقة، أولها عقب مجمع خلقيدونية (451م)، حين انفصلت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية – وفي طليعتها الكنيسة القبطية – عن كلٍّ من روما والقسطنطينية، بسبب الخلاف على تعريف طبيعة المسيح. ثم، وبعد ستة قرون، جاء الانشقاق الكبير سنة 1054م، ليقطع ما تبقى من رباط الشركة بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني، ويترك كل طرف يتشكل في عزلة فكرية ولاهوتية عن الآخر.
وفي هذا الغرب المنغلق على ذاته، وبعد أربعة عقود فقط من القطيعة الكبرى، ظهر أنسلم ليصوغ نظريته في الترضية البديلة، لا بوصفها تصحيحًا للمسار، بل تثبيتًا لذهنية قضائية عقابية، ولدت في رحم الثقافة الإقطاعية الأوروبية، وقطعت آخر خيوط العودة إلى لاهوت الحياة والاتحاد. لقد ألقى أنسلم بفكره حجرًا ثقيلًا في مياه اللاهوت الغربي، فتولدت منه دوائر متسعة من التأثير السلبي امتدت عبر قرون طويلة… ولا تزال.
ومع مطلع القرن الثالث عشر، بزغ نجم اللاهوتي والفيلسوف توما الإكويني (1225–1274)، الذي بذل جهده لتعزيز فكرة أنسلم عن الخلاص، مستخدمًا لغة وأسلوبًا أرسطيين، ومنهجًا فلسفيًا لعقلنة تدبير الخلاص، مع بقائه أسيرًا للإطار القانوني الذي وضعه أنسلم. ومن يقرأ الخلاصة اللاهوتية للإكويني، يلحظ عرضًا فلسفيًا منطقيًا على النمط المدرسي-Scholastic لجامعات القرون الوسطى، مبتعدًا عن الخط المستيكي (μυστικός – Mystikos) الشرقي، الذي يشرح تدبير الخلاص بصفته سرّ الاتحاد بالحياة الإلهية.
هكذا مضى الإكويني في تثبيت صياغة أنسلم للترضية البديلة، وترسيخ جدلية العدل والرحمة الإلهيين، مستندًا إلى مفاهيم أغسطينوس وأنسلم:
“إن خلاص الإنسان بآلام المسيح كان متوافقًا مع رحمته وعدله؛ فبعدله، لأن المسيح بآلامه قام بأيفاء الترضية عن خطيئة الجنس البشري، فصار الإنسان متحررًا بعدل المسيح؛ وبرحمته، لأن الإنسان لم يكن قادرًا من تلقاء نفسه أن يفي بترضية عن خطيئة الطبيعة البشرية كلها.”
(الخلاصة اللاهوتية، القسم الثالث، المسألة 46)
ثم يذهب أبعد من ذلك فيقول:
“من يكفّر عن الإهانة هو من يقدّم للمُهان شيئًا يحبه، أو حتى ما هو أعظم قيمة من الإهانة ذاتها. وبالمعاناة بدافع المحبة والطاعة، قدّم المسيح لله أكثر مما كان مطلوبًا للتعويض عن إهانة البشرية جمعاء. فالذبيحة الحقيقية هي ما يُقدّم لشرف الله المستحق، لإرضائه.”
(الخلاصة اللاهوتية، القسم الثالث، المسألة 48)
“بآلام المسيح تحررنا من دين العقاب بطريقتين: أولًا، مباشرةً، لأن آلامه كانت كفّارة كافية ووافرة عن خطايا البشرية جمعاء؛ ولكن عندما تُدفع الترضية الكافية يُلغى الدين (المديونية) وثانيًا، بطريقة غير مباشرة، لأن آلامه كانت سبباً لغفران الخطايا، الذي عليه يستقر دين (مديونية) العقاب.”
(الخلاصة اللاهوتية، القسم الثالث، المسألة 49)
وهكذا تتضخم الخطية في هذا التصور لتُقدَّم كإهانة مروّعة ضد الله، لا تُمحى إلا عبر تسوية قانونية صارمة وترضية باهظة الثمن، فتتحول هذه الفرضية المعيبة إلى محور الخلاص في الغرب. ولم يكن الإكويني إلا امتدادًا لهذا المسار، إذ وقع في الفخ ذاته الذي تعثر فيه أسلافه، غارقًا في التأمل في الخطية ووراثتها، وصياغة بديل عقابي يرضي الآب “الناقم” على خليقته! وبذلك جعل من هذه السردية المشوَّهة بوصلة لفهم التدبير الإلهي، في حين لم يعرف آباؤنا في الشرق الأرثوذكسي هذا المنطق قط؛ إذ كان قلب لاهوتهم يخفق بفرح الغلبة على الموت وهدم سلطانه، ووجدانهم مشتعلاً باستعادة شركة الحياة الإلهية. وشتّان الفارق بين من يرى الخلاص محكمةً، ومن يراه قيامةً!
والأكثر خطورة من ذلك، أن القول بأن الآب يطلب ثمنًا أو ترضية من الابن يفتح الباب أمام تمزيق وحدة جوهر الأقانيم؛ إذ يوحي بأن للآب إرادة منفصلة عن الابن، أو أن الابن يملك ما لا يملكه الآب!
أمّا في الشرق الأرثوذكسي، فميراث الآباء لا يعلّمنا أن السقوط خطيئة أشعلت غضب الله، بل هو انفصال عن شركة الحياة الإلهية، وفساد الطبيعة البشرية وخضوعها للموت. ويشهد تراث أجدادنا – الذي أدرنا له ظهورنا – أن كل ما في الوجود هو من الآب، بالابن، في الروح القدس: نعمة واحدة، وعمل واحد، يقوم به الثالوث القدوس. وتدبير الخلاص، في جوهره، هو نعمة وعمل وإرادة الثالوث لإعادة آدم إلى رتبته ومجده الأول.
ويتمادى الإكويني في أحد أكثر مساراته إثارة للجدل حين يعيد إطلاق ثنائية-Dualism أخرى: عبودية الإنسان لله وللشيطان بعد السقوط:
“كان الإنسان أسيرًا بسبب الخطيئة بطريقتين: أولًا، عبودية الخطيئة… وبما أن الشيطان قد غلب الإنسان بتحريضه على الخطيئة، فقد أصبح الإنسان خاضعًا لعبودية الشيطان. ثانيًا، فيما يتعلق بدين(مديونية) العقاب، الذي كان الإنسان ملزمًا بسداده بعدالة الله… آلام المسيح كانت كفارة كافية ووافرة… فقد كان الإنسان مرتبطًا أساسًا بالله كقاضيه المطلق، وللشيطان كمعذبه.”
(الخلاصة اللاهوتية، القسم الثالث، المسألة 48)
ثم يستدرك:
“كان لا بد من دفع الثمن لا للشيطان، بل لله. ولذلك يُقال إن المسيح دفع ثمن فداءنا – دمه الثمين – لا للشيطان، بل لله.”
إزاء هذا الفكر المشوَه تتوهج أمامي كلمات القديس غريغوريوس النزينزي (٣٢٩ م- ٣٩٠م) صارخاً بالحق الأرثوذكسي:
“لمن قُدّم الدم الذي سفك عنا ولما سُفك؟ … لقد كنّا أسرى وعبيداً للشيطان مباعين بسبب خطايانا وحصلنا على الشرور في مقابل اللذات.
ولكن حيث أن الفدية تدفع لمن هو في الأسر, وأنا أسأل لمن دفعت ولأي سبب؟
إذا كانت قد دفعت للشيطان … فما أفظع هذا التجديف!! إذا كان اللص يطلب فدية ليس فقط من الله, ولكن الفدية هي الله نفسه ويأخذ هذا الثمن الغالي أجره لاستبداده!!
وإذا كانت الفدية دُفعت للآب, وأنا أسأل قبل أي شيء آخر كيف حدث هذا؟ لأنّنا لم نكن أسرى عنده (الآب). وأخيراً على أي أساس سُرّ الآب بدم ابنه الوحيد وهو الذي لم يقبل أن يأخذ حتى دم إسحق عندما قدّمه أباه؟ … أليس من الواضح أن الآب قبله (الإبن) دون أن يسأله أو يطلب منه (فدية), ولكن تدبير العناية (الإلهية) كانت تقتضي تقديس الإنسانية بتقديس ناسوت الله, لكي ما يفتدينا هو بنفسه ويقهر العدو ويجمعنا إليه ببواسطة ابنه”.
المقالة ٤٥ : ٢٢
شتّان الفارق بين غرب تحجّر فكره عند دار بيلاطس وصليب الجلجثة، يحاول قراءة تدبير الخلاص وظهره مضروباً بسياط عبودية الإقطاع الأوروبي، غارق في لجّة ظلمات العصور الوسطى… وبين شرق نابض بالحياة والقيامة، متّحد أقنوميًا بابن الله الذي بموته داس الموت ، حيث الكنيسة تهلّل عند القبر الفارغ:
” أدم بينما هو حزين: سر الرب أن يرده إلى رئاسته
يسوع المسيح الكلمة، الذي تجسد، وحلَّ فينا، ورأينا مجده مثل مجد، إبن وحيد لأبيه، قد سُرَّ، أن يخلصنا
لأنه غُلِب، من رأفته، وأرسل لنا، ذراعه العالية.
الكائن، الذي كان، الذي أتى، وأيضاً يأتي
يسوع المسيح الكلمة، الذي تجسد، بغير تغيير، وصار إنساناً كاملاً.
أشرق جسدياً، من العذراء، بغير زرع بشرٍ، حتى خلصنا.
السلام لبيت لحم، مدينة الأنبياء، التي وُلِدَ فيها المسيح، آدم الثاني.
لكي يرد آدم، الإنسان الأول، الترابي، إلى الفردوس
ويحل قضية الموت.”
(ثيئوطوكية الاثنين)
وللحديث بقية…