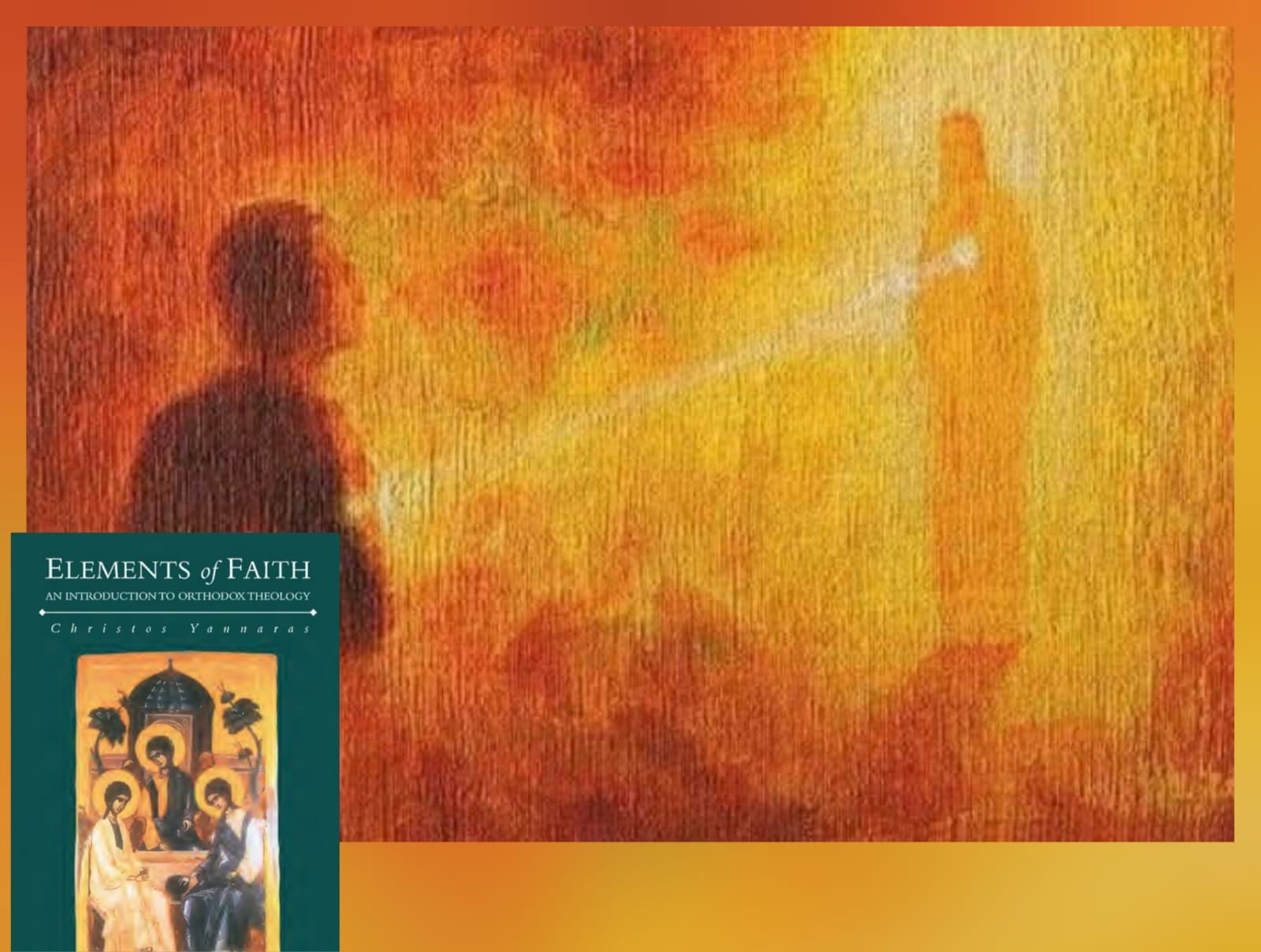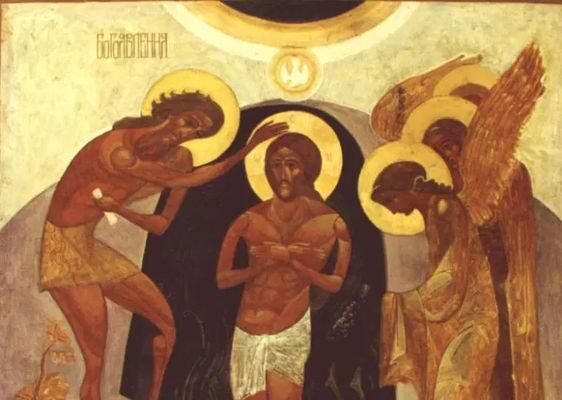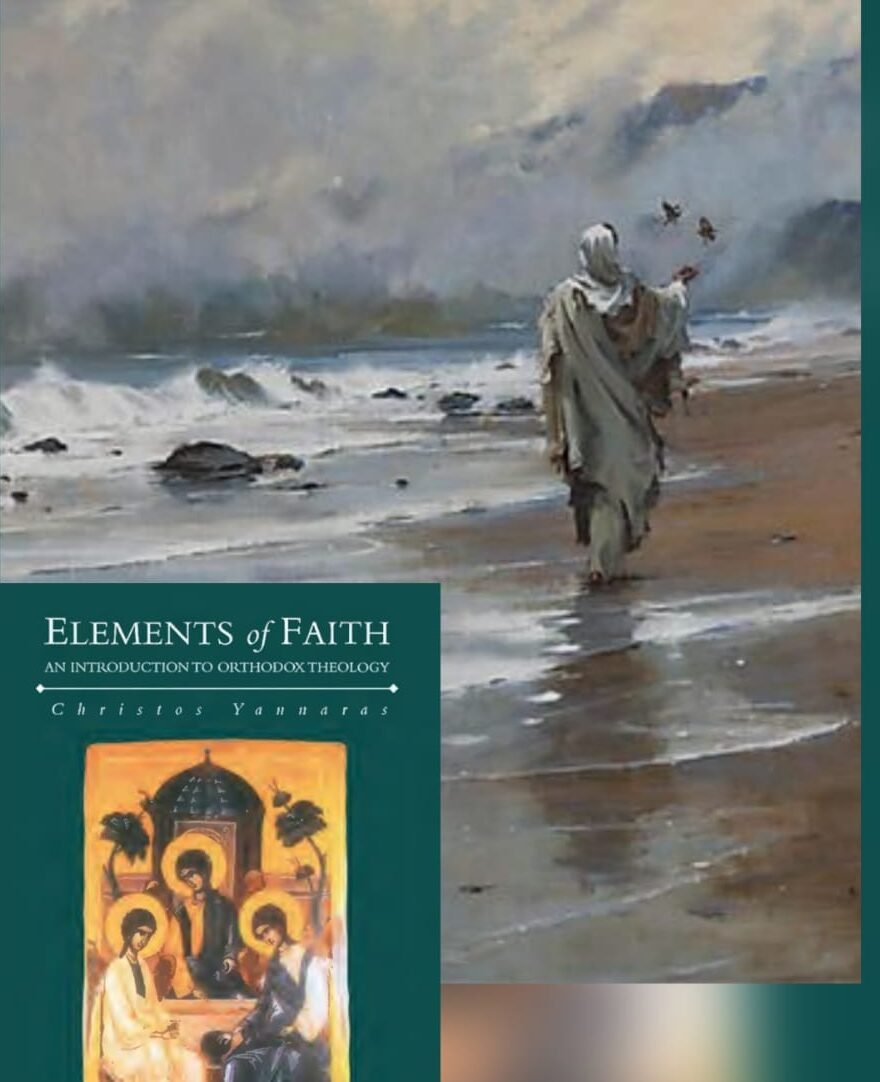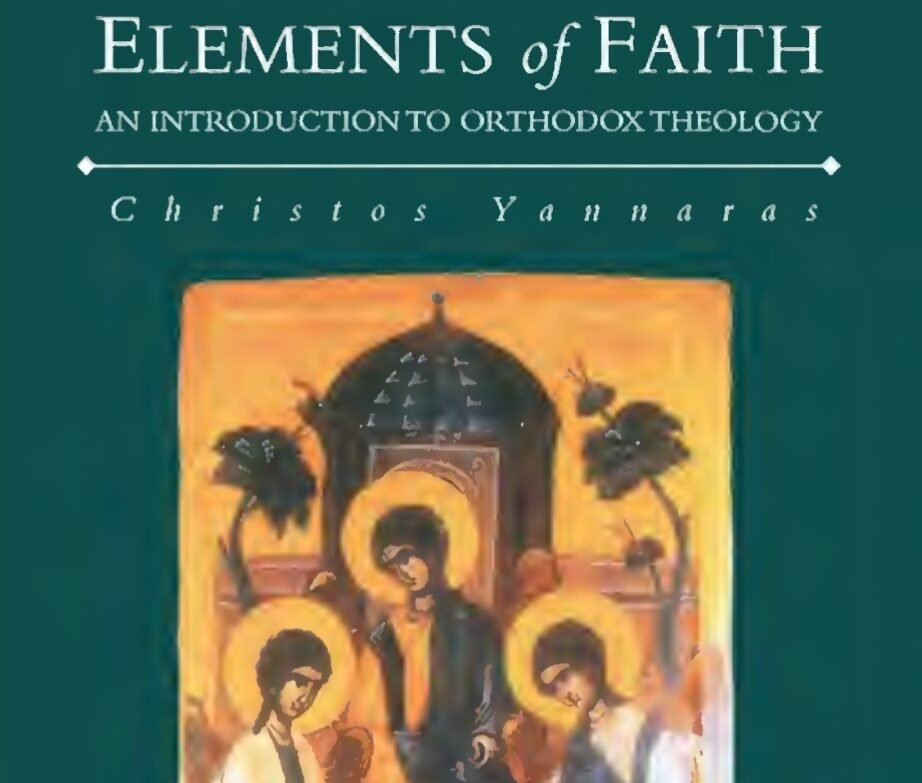في اللاهوت الأرثوذكسي، تُفهم وحدة الكنيسة لا كمجرّد مسألة مؤسسية أو تنظيمية، بل باعتبارها سِرًّا (μυστήριον, mysterion) عميقًا ومتجذّرًا في حياة الثالوث القدوس (Ἁγία Τριάς, Hagia Trias) ذاته. فالكنيسة، في وعيها الذاتي، ليست مجرد جماعة إيمانية رمزية أو تنظيم ديني، بل هي جسد المسيح (Σῶμα Χριστοῦ, Sōma Christou) الحي، وهيكل الروح القدس (Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Naos tou Hagiou Pneumatos)، حيث تتجلّى الشركة (κοινωνία, koinonia) الأزلية القائمة بين الآب والابن والروح القدس في حياة بشرية ملموسة. ومن ثمّ فإن أي تفكير لاهوتي حول وحدة الكنيسة لا بدّ أن يُبنى على أساس كتابي، مُستنيرٍ بشهادة الآباء، ومتمحور حول البُعد السرائري (sacramental – سرائري).
منذ فجر المسيحية، لم تُدرك الكنيسة كجماعة روحية مجرّدة فحسب، بل كـ كيان حيّ يعبّر عن نفسه في صور كتابية ورمزية متعدّدة: فهي جسد المسيح، وهي عروسه، وهي أيضًا مدينة الله (πόλις Θεοῦ, polis Theou)، حيث يتّحد المؤمنون في مواطنة سماوية (πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς, politeuma en ouranois) واحدة. إن هذا التصوّر الكنسي – المتجذّر في الكتاب المقدّس والمحفوظ في تقليد الآباء – يكشف أن وحدة الكنيسة ليست هدفًا لاهوتيًا نظريًا، ولا شعارًا مسكونيًا معاصرًا، بل هي شرط جوهري لوجود الكنيسة نفسها، ولحياتها وازدهارها.
فالمدينة لا تقوم بلا وحدة بين أبنائها، والكنيسة – بما أنها مدينة الله – لا يمكن أن تحيا إن لم تحفظ نسيجها الموحَّد المبني على الإيمان الواحد (μία πίστις, mia pistis)، والمحبّة الواحدة (ἀγάπη, agapē)، والمجمعية (συνοδικότης, synodikotēs) التي تحفظ انسجامها وتوازنها. ومن هنا، فالوحدة الكنسية ليست مجرّد فكرة سياسية بالمعنى الدنيوي، لكنها تحمل في جوهرها ملامح الوحدة السياسية – من حيث المجلس (σύνοδος, synodos)، والدستور، والإجماع، والإرادة الجماعية – لأن الكنيسة هي شعب الله (λαὸς Θεοῦ, laos Theou) الذي يسير معًا نحو الملكوت.
وحدة الكنيسة، إذن، ليست مجرّد مفهوم تنظيري أو شعار وجداني، بل هي قضية أنطولوجية (ontological – كينونية) ولاهوتية (theological) تمسّ الكيان الكنسي في صميمه. وهي متجذّرة في الوحي الإلهي كما أُعلن في الكتاب المقدّس، وموثّقة في تعليم الآباء وتقليد الكنيسة الحيّ. فالكنيسة، بحسب الرؤية الأرثوذكسية، ليست مؤسسة بشرية وحسب، بل هي الملء (πλήρωμα, plērōma)، أي “ملء الذي يملأ الكل في الكل” (أفسس 1:23)، وهي جسد المسيح الحي ومدينة الله، المتجلية في التاريخ من خلال الشركة الحقيقية في الأسرار (μυστήρια, mystēria)، والحياة المشتركة في الإيمان والمحبة.
لقد شبّه المسيح وحدة شعبه بوحدة الثالوث نفسه، حين صلّى قائلاً:
«ليكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد» (يوحنا 17:22).
فالوحدة هنا ليست اختيارية أو ثانوية، بل هي شرط جوهري للحياة في المسيح. فكما قال الرب أيضًا: «كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت» (متى 12:25). وهكذا، فإن وحدة الكنيسة هي صورة حيّة لوحدة الثالوث القدوس، وعلامة حقيقية لحضور ملكوت الله في العالم.
▫️الأبعاد اللاهوتية للوحدة الكنسية
1. الوحدة الأنطولوجية
ليست وحدة الكنيسة مجرد تطابق خارجي، بل مشاركة أنطولوجية في إنسانية المسيح الممجّدة بواسطة الروح القدس. ولذلك تُسمّى الكنيسة الملء (πλήρωμα, pleroma) للمسيح (أفسس 1:23).
2. الوحدة السرائرية
إن «معمودية واحدة لمغفرة الخطايا» و**«إفخارستيا واحدة»** هما عماد الوحدة الكنسية. فالأسَرار (μυστήρια, mysteria) ليست خبرات فردية، بل أعمال جماعية توحّد المؤمنين في الجسد الواحد.
3. الوحدة الإسكاتولوجية
الوحدة الكنسية حاضرة وراجية في آن. ففي الإفخارستيا يشترك المؤمنون في «عشاء عرس الحمل» (رؤيا 19:9)، لكن كمال هذه الوحدة لن يُكشف إلا في المجيء الثاني حين يسلّم المسيح الملكوت إلى الآب (1 كورنثوس 15:24–28).
▫️الكنيسة كـ «Πόλις» (بوليس) – مدينة الله
في الفكر اليوناني القديم، ولا سيّما عند أرسطو في كتابه السياسة (Πολιτικά, Politika)، نجد تعريفًا واضحًا لمفهوم المواطن (πολίτης, politēs): إنّه الشخص الذي يمتلك الحق والقدرة على المشاركة الفعلية في الحياة العامة، سواء في صنع القرارات (المجلس التشريعي) أو في القضاء (السلطة الحاكمة). وعليه، فالمدينة (πόλις, polis) في التصوّر الهيليني ليست مجرّد مكان جغرافي، بل هي شركة بشرية متماسكة، منظّمة وفق قوانين وأعراف، تجمع أبناءها في رابطة حياة ومصير واحد.
إن هذا التصوّر، عندما يُنقل إلى الكنيسة، يكتسب أبعادًا لاهوتية عميقة: فالكنيسة ليست مجرد جماعة دينية عابرة، بل هي مدينة سماوية (πόλις ἐπουράνιος, polis epouranios)، كما يصفها الرسول بولس قائلاً: «فإن سيرتنا (πολίτευμα, politeuma) نحن هي في السماوات» (فيليبي 3: 20). هذه المدينة لها نظام روحي، ومواطنة سماوية، وقوانين إلهية هي القوانين الكنسية (κανόνες, kanones)، التي تنظّم حياتها وتحفظ وحدتها، بحيث يظهر الشعب المسيحي كـ شعب الله (λαὸς Θεοῦ, laos Theou) السائر معًا نحو الملكوت.
▫️الكنيسة كـ «Πόλις» في كتابات الآباء
لم يكن استعمال صورة الكنيسة كـ «Πόλις» – مدينة الله محصورًا في الفكر الفلسفي، بل وجده الآباء القديسون أداة لاهوتية لتوضيح طبيعة الكنيسة كجماعة حيّة منظَّمة إلهيًا:
1. القديس كيرلس الإسكندري، مستندًا إلى الرسالة إلى العبرانيين (عب 12: 22–23)، يصف الكنيسة بأنها أورشليم السماوية:
«ومجد الكنيسة لن ينتهي أو يتوقف، لأنّ نفوس الأبرار تترك الأمور الأرضية وتبحر نحو المدينة العلوية، أورشليم السماوية، كنيسة الأبكار ‹التي هي أمّنا› كما يقول بولس.»
هنا تُفهم الكنيسة على أنها انتقال أنطولوجي من الأرضي إلى السماوي، من الزمن إلى الأبدية، من المدينة الفانية إلى المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله (عب 11:10).
2. القديس باسيليوس الكبير يتناول المفهوم ذاته بصورة لاهوتية أعمق. ففي تفسيره للمزمور 59 (العظة 20)، يصرّح صراحة أن الكنيسة هي «مدينة»، لأنّها جماعة منظَّمة بالشرائع الإلهية. ويقول أيضًا في العظة 18 على المزمور 45:
«الله في وسط المدينة، يمنحها الثبات، ويعينها عند طلوع الفجر. لذلك فإنّ كلمة ‹المدينة› يمكن أن تنطبق إمّا على أورشليم العلوية أو على الكنيسة الأرضية.»
هذا التعليم اللاهوتي يوضّح أن الكنيسة – الحاضرة على الأرض – هي أيقونة (εἰκών, eikōn) للكنيسة السماوية، وأنها تشترك منذ الآن في ثبات المدينة الأبدية حيث حضور الله في وسطها.
3. الطوباوي أوغسطينوس قدّم أوسع معالجة لهذا الموضوع في عمله اللاهوتي الضخم مدينة الله (De Civitate Dei)، حيث يرى أن الكنيسة هي Civitas Dei، أي المدينة التي يقيمها الله مقابل مدينة البشر (Civitas Terrena). ويستند في ذلك إلى نصوص مثل (مز 87: 3) و(مز 48: 1، 8)، حيث يُعلن أن الكنيسة، بكونها مدينة الله، تحمل مصيرًا إسكاتولوجيًا يتجاوز التاريخ، وتبقى صامدة في مواجهة قوى هذا الدهر.
البعد اللاهوتي لصورة الكنيسة كـ «Πόλις»
إن وصف الكنيسة بالمدينة لا يُقصد به مجرد استعارة شعرية، بل يعبّر عن حقيقة أنطولوجية (ontological reality):
فهي جماعة حيّة لها قوانين سماوية (νόμοι θεῖοι, nomoi theioi) تحكمها.
ولها مواطنة (πολίτευμα, politeuma) في السماوات، يشارك فيها المؤمنون منذ الآن عبر الأسرار المقدسة.
ولها مجمعية (συνοδικότης, synodikotēs) هي بمثابة النظام السياسي الروحي، حيث تتجلّى الشركة الكنسية عبر المجامع والأساقفة في وحدة الإيمان والمحبة.
وعليه، فإن الكنيسة كـ «Πόλις» تكشف عن هويتها الحقيقية: هي مدينة الله الحيّ، أيقونة الملكوت على الأرض، حيث يعيش المؤمنون كمواطنين سماويين، متحدين في المسيح، حاملين شهادة للعالم بأن ملكوت الله قد بدأ بالفعل في تاريخ البشر، وهو آتٍ بكماله في الدهر الآتي.
وهي هذا بهذه السياق، تتحوّل فكرة الكنيسة كـ «Πόλις» من مجرّد استعارة فلسفية إلى رؤية لاهوتية كاملة: إكليسيولوجية (ecclesiological)، أنطولوجية، إسكاتولوجية، وسرائرية (sacramental)، تُظهر الكنيسة كمدينة سماوية منظّمة، تعيش بين الأرض والسماء.
▫️مفهوم “τιμή” (تيمِي) و”ἀτιμία” (أتيميا) في الرؤية الأرثوذكسية
في الفكر اليوناني القديم، ولا سيّما في الأدب السياسي والفلسفي، كانت كلمة “τιμή” (تيمِي) تشير إلى الكرامة، المقام، والمنصب، المرتبط بحقوق المواطنة الكاملة داخل المدينة (πόλις, بوليس). فالمواطن الذي يحيا وفق القوانين ويشارك في الحياة العامة يُمنح “تيمِي”، أي كرامة وحق المشاركة في المجلس والقضاء. في المقابل، كان لفظ “ἀτιμία” (أتيميا) يعني فقدان الكرامة، أو الحرمان من المنصب والحقوق، ويُستخدم كعقوبة مدنية/سياسية تُفرض على من يرتكب جرائم خطيرة كخيانة المدينة، أو القتل العمد، أو محاولة قلب النظام. فالشخص الذي يقع في حالة “أتيميا” لم يكن مجرّد مذنب قانونيًا، بل مُستبعَد أنطولوجيًا من حياة المدينة.
وعندما ننقل هذا التصوّر إلى اللاهوت الأرثوذكسي، يكتسب معنى أعمق وأخطر. فالكنيسة هي Πόλις Θεοῦ (مدينة الله)، مواطنتها سماوية وقوانينها إلهية، وبذلك تصبح “τιμή” (الكرامة) في الكنيسة مرتبطة بالانتماء إلى جسد المسيح (Σῶμα Χριστοῦ, Soma Christou)، أي الشركة (κοινωνία, koinonia) في الأسرار المقدسة.
إن المؤمن الذي يعيش في الطاعة للإيمان المستقيم (ὀρθοδοξία, Orthodoksia) ويحيا ضمن الشركة الكنسية، يتمتع بكرامة روحية حقيقية: كرامة البنوة لله (υἱοθεσία, huiothesia)، وكرامة المواطنة السماوية (πολίτευμα ἐπουράνιον, politeuma epouranion).
أما الذي يرفض الإيمان القويم، أو يتمرد على قوانين الكنيسة (κανόνες, kanones), أو يحتقر الأساقفة الشرعيين (ἐπίσκοποι, episkopoi)، فإنه يفقد هذه الكرامة، فيسقط في حالة ἀτιμία (أتيميا روحية)، أي العار الروحي والحرمان من الشركة في الجسد الواحد.
وهذه الحالة الكنسية ليست مجرّد إجراء تأديبي، بل هي حقيقة أنطولوجية: فالذي ينفصل عن الشركة الكنسية يقطع نفسه عن حياة الجسد، ويُقصي ذاته عن نعمة الأسرار، وبالتالي يفقد كرامة المشاركة في الحياة الإلهية.
والكنيسة الأرثوذكسية، بوحي من الكتاب المقدس، لا ترى الحرمان أو القطع (ἀφορισμός, aforismos) كإجراء إداري بارد، بل كـ دواء روحي يهدف إلى تنبيه الخاطئ إلى خطورة وضعه ودعوته للتوبة. فالرسول بولس نفسه يقول عن الخاطئ: «أسلّم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب» (1 كورنثوس 5: 5).
إذن، الحرمان (أتيميا روحية) ليس إعدامًا للعضو، بل إعلان عن جرح خطير أصاب الجسد الكنسي. والشفاء ممكن فقط بالعودة إلى الطاعة والتوبة، حيث يُستعاد الكرامة (τιμή) وتُجدّد الشركة.
القوانين الكنسية (κανόνες, kanones) تجسّد هذا التعليم بوضوح. على سبيل المثال، القانون السادس من المجمع المسكوني الثاني (القسطنطينية 381م) يحرّم على من يسيء إلى الأساقفة أو يتجاوز القوانين أن تكون له أي كلمة مسموعة أو حق في التقديم، أي أن يُعتبر ساقطًا في ἀτιμία. هذا يعني أن الكنيسة تفهم الاعتداء على الشرعية الكنسية أو الانحراف عن التعليم القويم ليس مجرد خطأ تنظيمي، بل جريمة ضد “مدينة الله” تستوجب العزل من الكرامة الكنسية حتى التوبة.
وفي خلال البعد الأنطولوجي ، تتجاوز مفاهيم “τιμή” و”ἀτιμία” البُعد القانوني لتكشف البُعد الأنطولوجي في الكنيسة:
“τιμή” (تيمِي) ●
ليست مجرد لقب أو منصب، بل هي حالة وجودية: أن يحيا الإنسان متحدًا بالمسيح في جسده، مشتركًا في الأسرار، عضوًا حيًا في المدينة السماوية.
“ἀτιμία” (أتيميا) ●
ليست مجرد حرمان إداري، بل فقدان لهذا الوجود الكنسي، أي خروج من دائرة النعمة، وانكشاف للعار الروحي نتيجة الانفصال عن الشركة.
وعليه، فالكنيسة إذ تمارس قوانينها، لا تفعل ذلك بدافع العقاب القانوني البحت، بل لتكشف الحقيقة: أن من يتمرد على الكنيسة يفقد كرامته الأنطولوجية في جسد المسيح، وأن الطريق الوحيد لاستعادة هذه الكرامة هو التوبة والعودة إلى “الكينونيا” (κοινωνία) – الشركة التي هي سرّ الحياة المسيحية.
▫️من هم مواطنو “مدينة الله”؟
في اللاهوت الأرثوذكسي، لا يُفهم الانتماء إلى مدينة الله (Πόλις τοῦ Θεοῦ – Polis tou Theou) كهوية رمزية أو صفة خارجية، بل كواقع سريّ (μυστήριον – mysterion) يتجسد في الكنيسة. فالمواطنة الكاملة في هذه المدينة لا تُمنح إلا للذين وُلدوا من فوق (يو 3: 5) بالمعمودية المقدسة (βάπτισμα – Baptisma) وخُتموا بمسحة الروح القدس في سرّ الميرون (χρίσμα – Chrismation)، ودخلوا في الشركة التامة بالأسرار الإلهية، وحفظوا الإيمان القويم (ὀρθοδοξία – Orthodoxia) بلا انحراف. هؤلاء وحدهم يُحسبون “مواطنين” حقيقيين، بحسب قول الرسول: «فلستم بعد غرباء ونزلاء، بل أنتم مواطنون مع القديسين وأهل بيت الله» (أف 2: 19).
أما الذين هم خارج الكنيسة الأرثوذكسية، فيمكن النظر إليهم بلغة لاهوتية – من خلال استعارة المفهوم اليوناني القديم – بوصفهم أشبه بـ المتيكوي (μέτοικοι – Metoikoi) أي “المقيمين” أو “السكان غير المواطنين”: لهم صلة ما بالمدينة، يحيون قريبًا من أسوارها، لكنهم لا يتمتعون بالحقوق الكاملة ولا بالدخول الحرّ إلى شركة الأسرار. وهنا يظهر التمييز بين المواطنة الفاعلة التي تتحقق في حياة الشركة الكاملة، و”المجاورة” التي لا تضمن كمال العضوية في الجسد الواحد.
هذه الرؤية تقودنا إلى جدل لاهوتي عميق حول المعموديات غير الأرثوذكسية: فبعض الآباء واللاهوتيين يقبلون – بحسب مبدأ الاقتصاد الكنسي (οἰκονομία – Oikonomia) – الاعتراف بمعمودية الكاثوليك أو بعض الطوائف الأخرى كـ “بذرة نعمة” قابلة للاكتمال بالدخول في ملء الكنيسة. بينما يرى آخرون أن المعمودية لا يمكن أن تُفهم منفصلة عن سرّ الميرون وسرّ الإفخارستيا، وأن اكتمالها يفترض اندماجًا في الشركة الكاملة. وفي كلا الموقفين، تظل الكنيسة الأرثوذكسية هي المرجع الوحيد الذي يوزن به كل انتماء.
الكتاب المقدس يرسم أمامنا صورتين متكاملتين للكنيسة:
● مدينة مضاءة على جبل: يقول الرب في عظة الجبل: «أنتم نور العالم. لا يمكن أن تُخفى مدينة قائمة على جبل» (مت 5: 14). هنا الكنيسة ليست جماعة مشتتة، بل كيان قائم بهوية واضحة ووجود ملموس، ظاهر كشهادة حيّة أمام العالم.
● مواطنة سماوية: الرسول بولس يعلن: «فإن سيرتنا (πολίτευμα – Politeuma) هي في السماوات» (في 3: 20)، مؤكدًا أن المؤمنين قد دخلوا بالفعل في واقع سماوي حاضر، لا مجرد رجاء مستقبلي. ويضيف: «قد أتيتم إلى جبل صهيون، وإلى مدينة الله الحي، أورشليم السماوية، وإلى ربوات هم محفل ملائكة، وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات» (عب 12: 22–23).
إذًا، الكنيسة ليست وعدًا مؤجلًا بل حقيقة حاضرة: هي أورشليم الجديدة الظاهرة في العالم، حيث يختبر المؤمنون مواطنتهم السماوية هنا والآن، ويعيشون تحت ناموس المسيح، في جسد واحد غير منقسم. هذه المواطنة الكنسية هي عربون الملكوت، وهي أيضًا دينونة على كل انقسام أو هرطقة، لأن المسيح نفسه قد أعلن: «كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب» (مت 12: 25).
▫️أهمية تجنّب “الأتيميا” في الحياة الكنسية
وإذا كانت الكنيسة “مدينة الله” (Πόλις τοῦ Θεοῦ)، فإن حفظ الكرامة الروحية (τιμή – timē) هو شرط أساسي لحياة هذه المدينة ووحدتها. فالأتيميا (ἀτιμία – atimia) – أي فقدان الكرامة – لا تُفهم هنا بوصفها مجرد حرمان إداري أو إجراء عقابي، بل كجُرح عميق في جسد الكنيسة، يهدد وحدة المدينة ووجودها.
تحدث الأتيميا الروحية عندما يرفض الإنسان الانضباط الكنسي أو يهاجم السلطة الروحية الشرعية (الأسقف والمجمع)، أو عندما ينشر الهرطقة ويرفض الإيمان الجامع الرسولي (καθολική πίστις – katholikē pistis)، أو عندما يثير الانقسام والشقاق (σχίσμα – schisma) ويدعو إلى الانفصال عن الشركة. هذه ليست أخطاء عرضية، بل خطايا ضد سرّ الوحدة نفسه، أي ضد الروح القدس الذي يجمع المؤمنين في جسد المسيح. لذلك تؤكد القوانين المسكونية أن من يسقط في هذه الحالة يُعزل عن الجماعة، لأنه بعصيانه فقد كرامة المواطنة الروحية في مدينة الله.
من منظور الدبلوماسية الروحية يمكننا إدراك معنى الوحدة الكنسية عبر تشبيه الكنيسة بمدينة، إذ يتيح هذا التصوّر فهم طبيعة علاقتها بالجماعات المسيحية الأخرى التي ليست في شركة كاملة معها. فكما تنسج المدن فيما بينها علاقات قائمة على أشكال متنوّعة من الدبلوماسية، كذلك تسعى الكنيسة الأرثوذكسية، بحكمة وتمييز، إلى مدّ جسور التواصل مع الآخرين، دون أن تمسّ بجوهر دعوتها ورسالتها.
● الضيافة الروحية: استقبال الوفود وتبادل الزيارات، بما يعكس شهادة المحبة المسيحية.
● التبادل الروحي: مشاركة الكتب، الأيقونات، والخبرات الليتورجية والنسكية، كعلامات حضور النعمة العاملة حتى خارج الحدود المنظورة.
● الحوار اللاهوتي: عقد اللقاءات والمسكونيات بهدف توضيح الإيمان الأرثوذكسي وفهم الآخر بعمق، في رجاء أن يقود الروح القدس إلى الوحدة الحقيقية.
ولكن، كما في السياسة، تبقى هذه “العلاقات الدبلوماسية” مجرد وسائل، لا غايات نهائية. الهدف الأسمى ليس مجرّد تواصل خارجي أو حسن جوار، بل استعادة الشركة الكاملة في الأسرار، لأن الكنيسة لا تُدعى إلى عقد تحالفات، بل إلى أن تكون جسد المسيح الواحد غير المنقسم، عربون أورشليم السماوية.
▫️وحدة الكنيسة كأمر وجودي
في النهاية، ومن خلال اللاهوت الأرثوذكسي، تُفهم وحدة الكنيسة باعتبارها أمرًا وجوديًا وجوهريًا، لا مجرد قضية تنظيمية أو هيكلية. فالوحدة ليست خيارًا إداريًا، بل شرط للخلاص نفسه، إذ إنّ الكنيسة هي جسد المسيح الحيّ (Σῶμα Χριστοῦ)، والانقسام عنها يعني الانفصال عن مصدر الحياة. وكما أن العضو المقطوع من الجسد يفقد حيويته ويموت، كذلك كل مَن يقطع نفسه عن الكنيسة الجامعة ينحدر نحو الموت الروحي، أي الأتيميا (ἀτιμία) – فقدان الكرامة والشركة.
من هنا، يصبح الدفاع عن الوحدة الكنسية واجبًا روحيًا على كل عضو في الجسد الواحد، لا باعتباره مجرد ولاء مؤسسي، بل طاعة عميقة للروح القدس، وحفظًا للإيمان المستقيم (ὀρθοδοξία – Orthodoxia)، وخضوعًا للقوانين الكنسية التي صاغتها المجامع المسكونية بروح إلهي. فالطاعة هنا ليست طاعة شكلية، بل اشتراك في حياة الشركة (κοινωνία – Koinonia)، وابتعاد عن كل ما يهدد وحدة الجسد، سواء بالهرطقة، أو العصيان، أو التمرد على النظام الكنسي.
هذا ما عبّر عنه الرسول بولس بوضوح حين قال:
«اجتهدوا أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» (أفسس 4: 3).
فالكنيسة، بصفتها مدينة الله (Πόλις Θεοῦ)، مدعوّة إلى أن تكون واحدة في الإيمان، واحدة في الأسرار، وواحدة في المحبة، لأن وحدتها هي أيقونة الوحدة الثالوثية عينها. وهكذا فقط يتحقق سرّ الصلاة التي رفعها الرب يسوع إلى الآب: «ليكونوا واحدًا كما نحن واحد» (يوحنا 17: 22). إنّها ليست وحدة شكلية أو سياسية، بل وحدة في الحقيقة والقداسة، وحدة خلاصية، تكشف أن الكنيسة الحقيقية لا يمكن أن تُفهم إلا كـ شركة حياة إلهية بين الله وشعبه، متجسّدة في تاريخ العالم، ومستمرة إلى الأبد.