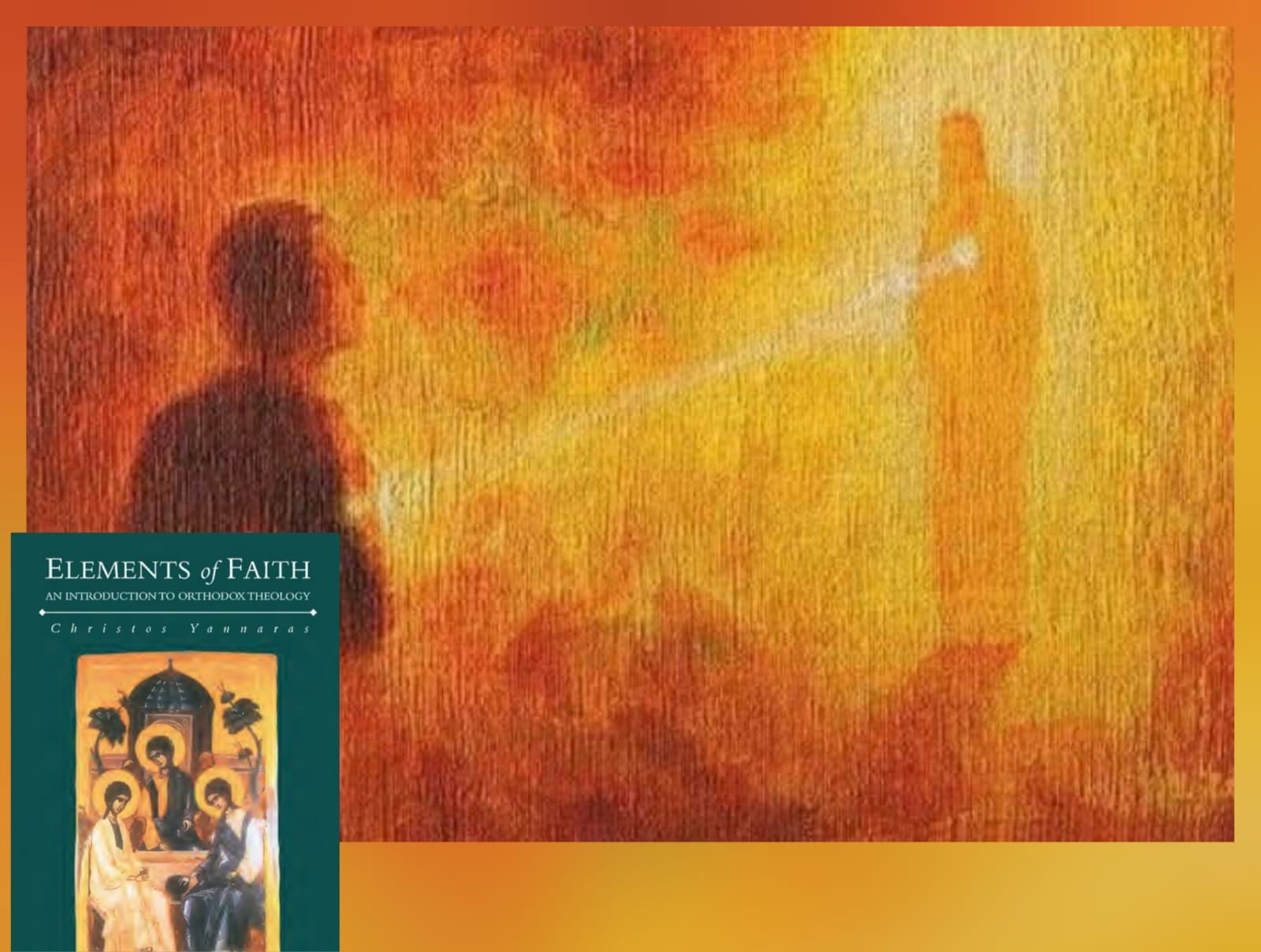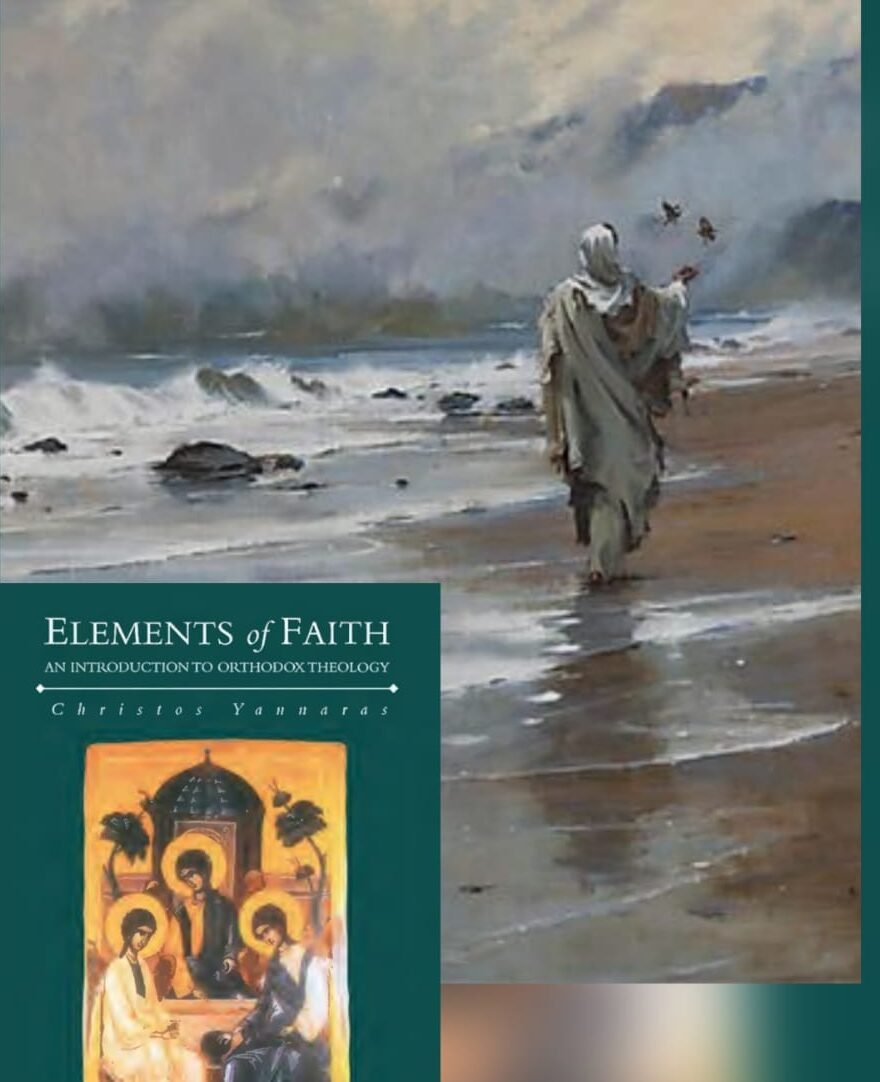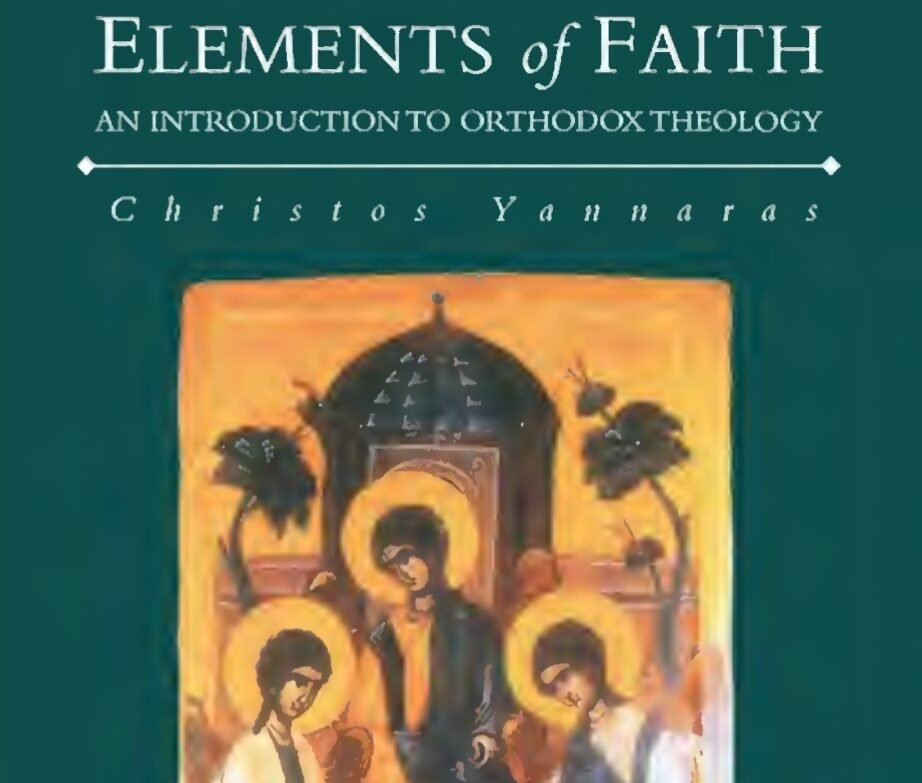” بدون تجسد الله وموته ، لم نكن لنحيا مرة أخرى”، كما يكتب القديس غريغوريوس النزينزي. ويقول القديس أثناسيوس: “إذا وُلد الله وإذا مات، فليس لأنه وُلد فهو يموت، بل لكي يموت هو وُلد”. إن [حتمية] الموت لم تكن، في الواقع، متجذرة في الطبيعة البشرية للمسيح؛ لكن ولادته البشرية نفسها كانت قد أدخلت بالفعل في شخصه الإلهي عنصرًا يمكن أن يصبح قابلاً للفناء . التجسد يخلق كما لو كان “مساحة فارغة ” بين الآب والابن، [ الهوة التي عبرها الإبن من اجلنا ] تتجلي في الخضوع الحر للكلمة المتجسد . من خلال الترك ، من خلال اللعنة، يتحمل شخص بريء كل خطيئة، “يبدل” نفسه بأولئك الذين هم مُدانون بحق ويعاني الموت من أجلهم. “هوذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم”، كما يقول القديس يوحنا المعمدان، مرددًا صدى إشعياء. كل التقليد الذبائحي لإسرائيل، بدءًا من ذبيحة إسحق التي استُبدلت بكبش، يبلغ ذروته هنا. وكل النماذج الرمزية المتعلقة بالأسر ، كل رجاء انتظار للتحرير ، يتحقق أيضًا. هنا يمكن للقديس بولس أن يكتب: “المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا”.
اللحظة المركزية لتدبير الابن ، الفداء ، لا يجب فصلها عن التدبير الإلهي ككل . هدف التدبير الأساسي لم يتغير أبدًا. هو الاتحاد بالله بكامل الحرية، لكائنات شخصية. المحبة الإلهية تطلب دائمًا نفس الهدف: تأله البشر، وبواسطتهم، الكون كله. لكن السقوط يُحدث تغييرًا، ليس في هدف الله، بل في وسائله ، في “التربية” الإلهية. لقد دمرت الخطيئة المخطط الأوَلِي ، ذلك المتمثل في الصعود المباشر للإنسان إلى الله. لقد فتح إنشقاق كارثي في الكون ؛ يجب التئام هذا الجرح ويجب إفتداء التاريخ التخريبي للإنسان، الي بداية جديدة : هذه هي غايات الفداء.
يظهر الفداء إذن ، كوجه او عنصر سلبي [مُضاف] للمخطط الإلهي . إنه يفترض واقعًا، مأساويًا، “مضادًا للطبيعة” [ اي الموت والإنفصال عن الله ] . سيكون من العبث طيّه حول نفسه، وجعله هدفًا بذاته . لأن الكفارة التي جعلتها خطايانا ضرورية ليست “غاية” بل وسيلة، الوسيلة للهدف الحقيقي الوحيد: التأله. الخلاص نفسه هو مجرد عملية سلبية [ اي الخلاص من شئ ، يقصد الموت او الإنفصال] : الحقيقة الجوهرية الوحيدة تبقى الاتحاد بالله. ما الفائدة من أن نُخلّص من الموت، من الجحيم، إذا لم يكن ذلك لكي نفقد أنفسنا في الله؟
وهكذا، عندما نراه في ضوء المخطط الإلهي، يتضمن الفداء عدة لحظات، تنفتح أكثر فأكثر على ملء الحضور الإلهي [ الشركة مع الله ] . إنه أولاً إلغاء العقبات الجذرية التي تفصل الإنسان عن الله، خاصة الخطيئة التي تخضع البشرية لإبليس وتسمح بهيمنة الملائكة الساقطين على العالم الأرضي . يُصاحب تحرير المخلوق الأسير لاحقًا استعادة طبيعته، التي أصبحت قادرة على قبول النعمة والانتقال من “مجد إلى مجد”، حتى إلى تلك المشابهة التي تأخذها إليها الطبيعة الإلهية، وتسمح لها بتجلي وشفاء الكون كله .
لا يمكن إذن حصر عظمة عمل المسيح ، في تفسير واحد ولا في استعارة واحدة . هذا عمل لا يمكن للملائكة إدراكه ، كما يخبرنا القديس بولس. فكرة الفداء نفسها تفترض جانبًا قانونيًا بوضوح: إنها كفارة العبد ، الدين المدفوع لأولئك الذين بقوا في السجن لأنهم لم يستطيعوا سداده. موضوع الوسيط الذي جمع الإنسان إلى الله عبر الصليب هو استعارة قانونية ايضاً . لكن هاتين الصورتين البولسيتين [ نسبةً الي القديس بولس ] ، اللتين أكد عليهما الآباء مرة أخرى، لا يجب أن يُسمح لهما بالتصلب او الإنغلاق الحرفي فيهما ، لأن ذلك سيكون بناءً لعلاقة حقوقية وقانونية غير قابلة للدفاع بين الله والإنسانية. بل يجب علينا إعادة توطينهما بين العدد اللاّمتناهي من الصور الأخرى، كل منها مثل وجه لحدث لا يُوصف في ذاته. تبرز في الإنجيل بشكل كبير صورة الراعي الصالح الذي يبحث عن الخروف الضال، والطبيب الذي يأتي ليشفي المرضى، والفدية المدفوعة للعدو (الشيطان) لتحرير الأسرى. لكن هذه الصورة الأخيرة، التي طورها بعض الآباء (مثل القديس غريغوريوس النيسي)، يجب فهمها بحذر: فالشيطان ليس له حقوق على الله؛ إنه غاصب. “الفدية” المدفوعة له هي في الحقيقة فخ إلهي: فبإخفاء لاهوته تحت ستار الإنسانية، يقدم المسيح نفسه كفدية، لكن قيامته تهزم الموت والشيطان الذي حاول ان يقبِض عليه دون حق. وهكذا، فإن الفداء هو في نفس الوقت انتصار على قوى الشر وتحرير الإنسان من خطيئته.
“الراعي الصالح الحقيقي ” عندما ينتصر على اللص، يربطه ويأخذ غنائمه منه . الموضوع الرئيسي للنصوص الليتورجية، خاصة خلال أسبوع الآلام، هو المسيح كَمَلِك ، كمحارب منتصر يهزم الأعداء، ويُكسَرُ أبواب الجحيم ، كما كتب دانتي “تدخل راياتهم منتصرة”. تنتشر أيضًا في كتابات الآباء صور ذات طبيعة مادية للجحيم : صورة النار المُطهرة، وخاصة صورة الطبيب الذي يشفي جراح شعبه. المسيح هو السامري الصالح الذي يعتني بالطبيعة البشرية ويشفيها بعدما جرحها اللصوص، أي الشياطين. أخيرًا، موضوع الذبيحة هو أكثر من مجرد استعارة. إنه تتويج لنموذج رمزي / نبوي إشترَكَ في الواقع نفسه الذي اُعلن ، في “دم المسيح” المقدم “بروح ازلي”، كما هو مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين، حيث تُكمِل هذه الصورة بعمق الرمزية القانونية.
بأخذ مكاننا بإرادته ، المسيح “صار لعنة”، كما كتب القديس بولس إلى أهل غلاطية. إختبر المسيح التَرك على الصليب ، اختبر نتيجة الخطيئة شعور المتهم، الغريب ، والمهجور من الجميع بغياب الله وإبتعاده . “إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟” هذا العري الكلي للكرب له أيضًا قيمة رمزية: لأن الصرخة الأخيرة للمصلوب ليست سوى بداية المزمور 21، صلاة الرجل البار الطويل الألم. بداية هذا المزمور تعلن اليأس البشري: “أنا كالماء إنسكبت ، وانفصلت كل عظامي”. ثم يأتي المقطع النبوي الشهير : ” ثقبوا يديَّ ورجليَّ ، اقتسموا ثيابي بينهم وعلي لُباسي اقترعوا ” وهكذا، من خلال النموذج النبوي، تتقابل آلام المسيح وتستجيب لمعاناة الطبيعة البشرية المدمرة بسقوطها. ونهاية المزمور، كمن يعلن القيامة، يترنم بانتصار البر والقوة الخلاصية لله.
إذا كرر المسيح هذا المزمور، فذلك لأنه يتبني حالتنا بالكامل، حتى إلى حدود ذلك الشعور، المعروف للمحتضرين عندما يموتون ، ذلك الشعور بأن الله قد تخلى عنهم: “لا تبتعد عني لأن الشدة قريبة ولا معين لي”. ومع ذلك، لا يوجد تمزق ولا مأساة في “الكلمة المتجسد ” ، المساوي للآب في الجوهر منذ الأبد. ولهذا السبب، بالإتحاد بالمسيح، ينتهي التمزق والمأساة. كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم في عظة الفصح “عندما بقي المسيح سجينًا طوعًا وبإرادته ، يختبر الموت و آلام المُخاض ، لم يستطع المقاومة، انفجر، حررنا”. وواصل مكسيموس المعترف موضوع الفداء بقوله: “موت المسيح على الصليب كان دينونة الدينونة”! [ يقصد إن كان الموت يُديننا بحسب خطايانا فالمسيح نقض دينونته وحكمه ] . الموت ليس له عمل في شخص ابن الله، تصبح اللعنة بركة ؛ بالصليب، تصبح كل شروط الخطيئة شروط خلاص. من الآن فصاعدًا لا تفصلنا الخطيئة ولا الموت بعد الآن عن الله. لأن المعمودية تكفننا في موت المسيح ليُقيمنا معه؛ لأن التوبة يمكن أن تعيدنا دائمًا إلى الله، والموت، المُتخذ يوميًا بالتوبة، يمكن أن يفتح لنا باب الحياة الإلهية.
لم تكن لعنة الموت أبدًا حُكمًا قانونياً من الله [ بإعدام ] البشرية . لقد كانت عقاب تربوي لأب مُحب، وليس غضبًا اعمي من طاغية. كان طابعها تربويًا للإستعادة . لقد منعت استمرار حياة منفصلة عن الله / مائتة . لم تضع حدًا فقط لفناء طبيعتنا وموتها ، ولكن، من خلال مآساة المحدودية [ مأساة القلق او الكرب الوجودي ] ، ساعدت الإنسان على أن يصبح واعيًا بحالته ويلتفت إلى الله. وبالمثل، لا يمكن لإرادة الشيطان الظالمة أن تعمل مطلقاً إلا من خلال الإذن العادل لله. لم يكن اختيار الشيطان محدودًا فقط بالإرادة الإلهية، ولكن أيضًا تم استخدامه بها، كما نرى في حالة أيوب.
لم يكن الموت ولا هيمنة الشيطان سلبيين بشكل بحت . لقد انكشفا لنا بالفعل كعلامات ووسائل للمحبة الإلهية المؤدِبة والشافية . لكن في لحظة الفداء ، تُجرد القوى الشيطانية، ويحدث تغيير في علاقات الإنسان والله. يمكننا القول إن الله يُعدل اسلوب تربيته. فهو ينتزع من الشيطان الحق في السيطرة على البشرية. تُطرح الخطيئة، وهيمنة الشرير تتهاوى. كلمة “كفارة” تكتسب هنا معنى آخر: معنى دين تم سداده للشيطان، كما جاء في الأدب الآبائي في القرون الأولى. لقد منح الله سلطة للشيطان، ثم انتزعها منه، لأنه تجاوز حقوقه بمهاجمة إنسان متحد باللاهوت . يُظهر إيريناوس وأوريجانوس و النيسي الشيطان، راغبًا في السيطرة على الكائن الوحيد الذي لا سلطة له عليه ” الكلمة المتجسد “، فيُجرد من سلطته. يقترح بعض الآباء ، رمزًا لمكيدة إلهية: إنسانية المسيح هي الطعم ولاهوته هو الخُطاف ؛ يندفع الشيطان على الطُعم ، لكن الخطاف يخزه — لا يستطيع ابتلاع الله ، [ فيتقيأه ، ويخرج جميع المأسورين معه ] .
يُقال ان الصليب (دين مسدد لله ) او (دين مسدد للشيطان) : صورتان، لتطويق وتحديد الفعل في عمقه غير المدرك الذي أعاده لنا المسيح من خلاله كرامة أبناء الله. لاهوت أفقرته العقلانية التي تتراجع أمام هذه اللاهوت الآبائية الكنسي ، ويُفقدنا بالضرورة المنظور الكوني لعمل المسيح. لكن بدلاً من ذلك، يجب علينا توسيع منظورنا للفداء. لأنه ليس فقط الشياطين ولكن أيضًا الملائكة قد جُرّدوا . في آدم الثاني، الله نفسه يتحد مباشرة بالبشرية، مسببًا إياها أن تشارك في إنتصاره غير المحدود على الملائكة. الفداء هو واقع بديع، يشمل ويمتد عبر الكون كله، المرئي وغير المرئي. “دينونة الدينونة” تصالح الكون الساقط مع الله. الله على الصليب يبسط ذراعيه للبشرية. كما كتب غريغوريوس النزينزي: “بضع قطرات من الدم تعيد الحياة الي الكون كله “.
سُحق الشيطان، ولكن دون أن تُنتهك حقوقه، إذا جاز التعبير. أُلغي قانون الطبيعة الفانية، ولكن مرة أخرى دون أن يُنتهك شيء من عدالة الله. بعبارة أخرى، لا ينبغي لنا أن نصور الله إما كملك دستوري يخضع لعدالة تفوقه، أو كطاغية تكون نزواته خلقًا لقانون بلا نظام أو موضوعية. العدالة ليست واقعًا مجردًا متفوقًا على الله بل هي تعبير عن طبيعته. كما أنه يخلق بحرية ويتجلى في نظام وجمال الخليقة، هكذا يتجلى في عدالته: المسيح الذي هو نفسه العدل، يؤكد بكماله عدالة الله. ليس أن الابن يحقق عدالة غريبة من خلال تحمل عقوبة وألم كترضية لا نهائية من أجل انتقام لانهائي تطلبه الآب. “لماذا”، يتساءل غريغوريوس النزينزي، “لماذا يجب أن يكون دم الابن مَسَرّة للآب الذي لم يشأ حتى قبول إسحاق الذي قدمه إبراهيم محرقة، بل استبدل هذه الذبيحة البشرية بذبيحة كبش؟”
المسيح لا ينفذ العدالة ؛ بل يظهرها: فهو يُظهر ما ينتظره الله من الخليقة، أي ملء الإنسانية “آدم الآخير “. إنه يفي ويحقق دعوة الإنسان التي خانها آدم الأول : أن يحيا، ويغذي الكون ، من الله وحده. هذه هي عدالة الله. الابن، المساوي لله في طبيعته الإلهية، يكتسب من خلال التجسد إمكانية تحقيق هذه العدالة اللي فقدها الإنسان . لأنه يستطيع إذن أن يخضع للآب كما لو كان بعيدًا عنه، ويتخلى عن هذه الإرادة الخاصة التي منحته إياها إنسانيته ، ويسلم نفسه طوعًا، حتى الموت، لكي يتمجد الآب. عدالة الله هي ألا ينفصل الإنسان بعد عن الله. إنها استعادة الإنسانية في المسيح، آدم الحقيقي. يجيب غريغوريوس النزينزي علي السؤال السابق “أليس من الواضح أن الآب يقبل الذبيحة، ليس لأنه طالب بها أو كان يحتاجها ، بل بتدبير إلهي . كان على الإنسان أن يتقدس بواسطة إنسانية الله؛ كان على الله نفسه أن يحررنا، منتصرًا على الطاغية بقوته الخاصة، كان عليه أن يعيدنا إليه بابنه الذي هو الوسيط، مكملًا كل شيء لأجل كرامة الآب، الذي يطيعه في كل شيء… فليُوقر الباقي بصمت.”