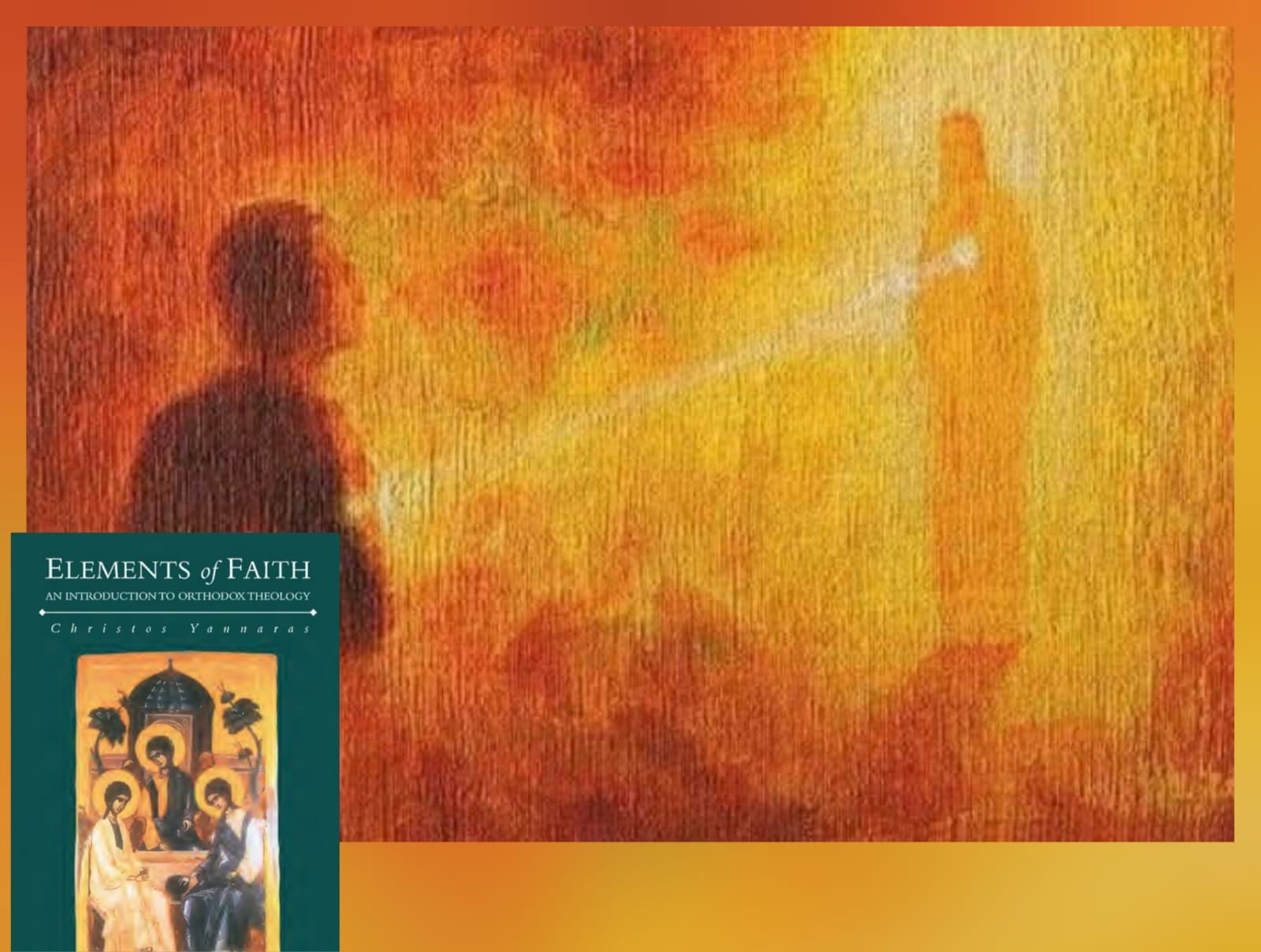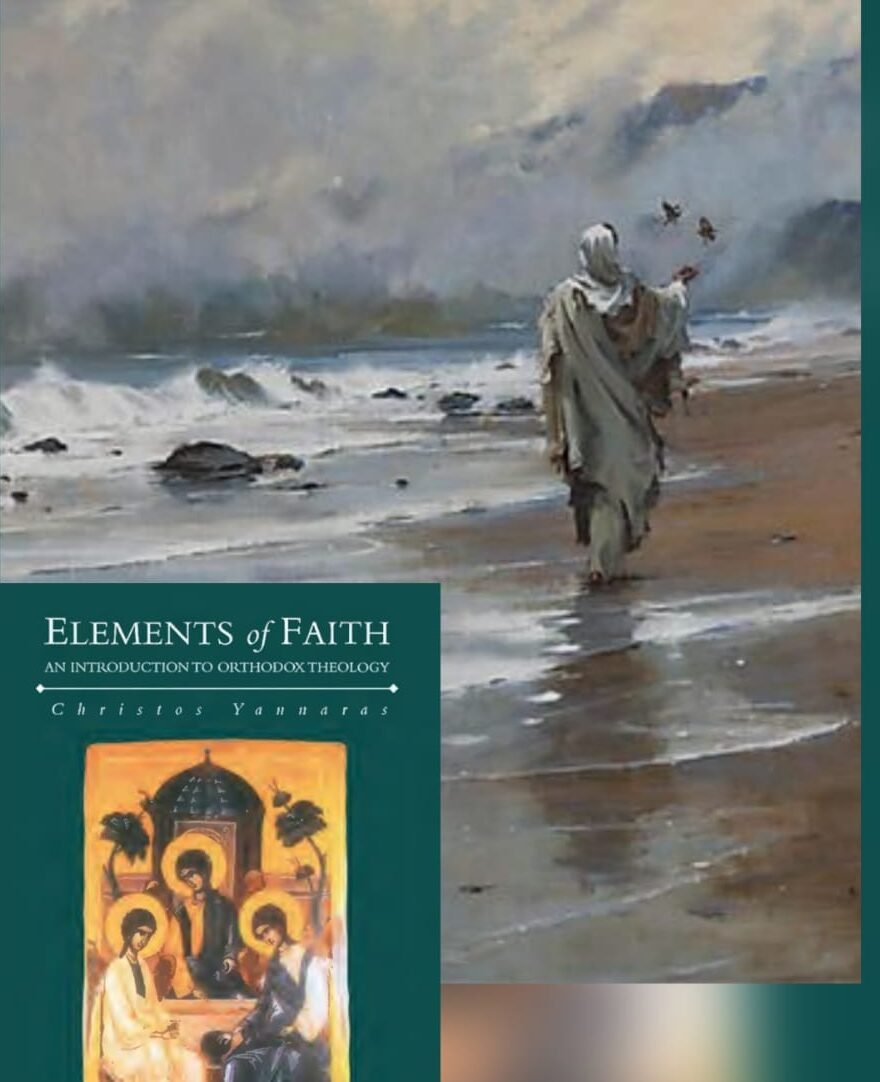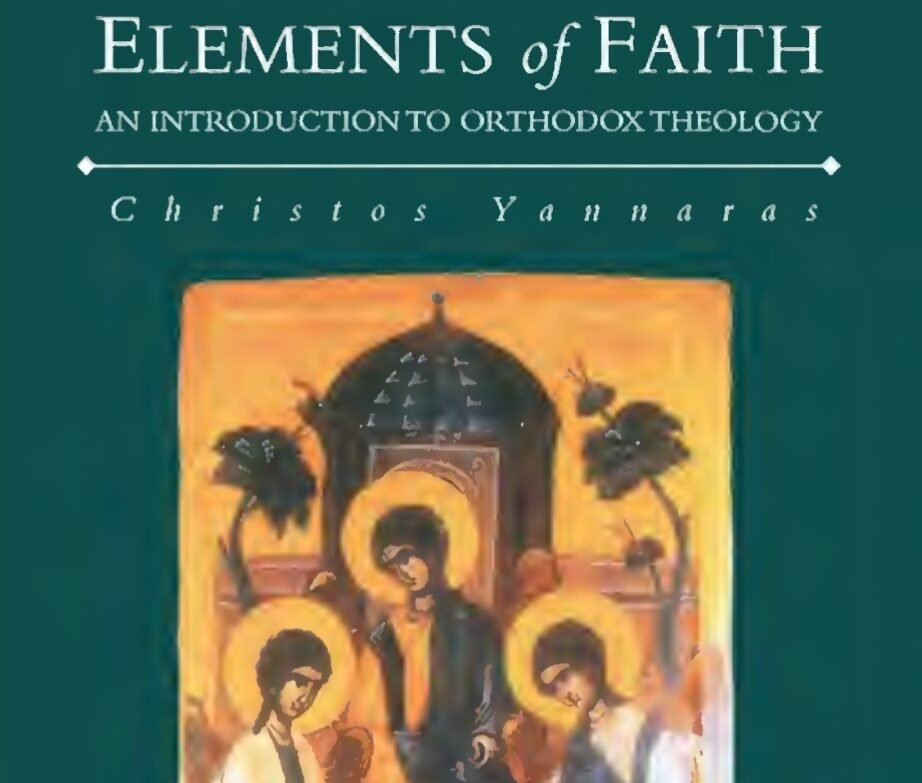إن الوعي بحالة السقوط الذي احدَّر الإنسان الي درجة ادني من مستوي دعوتِه ليس هو إدراك لحالة او سردية حصرية في التقليد اليهودي – المسيحي وحده ، انما هو شعور بشري عام ، عُبر عنه في اساطير تنوعت اشكالها ، وفي رموز الأديان المعروفة كلها تقريباً ؛ فبفضله وعليه شكلت أغلبية النظم الفلسفية نواة مُعضلتها الأساسية ، وعلي كل حال ، مما لا شك فيها ان التصور المتعلق بالسقوط في المسيحية ليس مجرد منحي من مناحي الأنثروبولوجيا، لكنه مفتاحها الأساسي ، اللازم لفهم الإنسان و العالم و التاريخ .
إن الحقيقة المتعلقة بالسقوط من جهة وبالتأله من جهة اخري تحدد كينونة الكنيسة وتُضفي معني علي وجودها ومهمتها التاريخية .
تبني الكنيسة تعليمها في المسألة المُتعلقة بالسقوط علي تفسير بعض من نصوص العهد القديم المحددة بشكل رئيسي ، إن رواية خلق الإنسان المُثبتة في الفصول الأولي من سفر التكوين تُستكمل بخبر السقوط ، يتم تصويره بشكل مذهل ، وغِني معنوي ورمزي ودِقة نماذجية .
نقرأ انه بعد خلقِ الإنسان ، غرس الرب الإله جنة ، حديقة بديعة الجمال هي عدن ، إن صورة الجنة حاضرة في جميع اديان الشرق الأوسط بصفتها رمزاً للسعادة ، ربما كان هذا تبايناً منها مع الصحاري القاحلة وافتقارها الي الماء ، الصحراء التي لا ماء فيها هي رمز للموت بلا شك ، بينما تظهر الأنهار المُروية لعدن كصورة للحياة .
هناك اسكَنَ الله الإنسان حتي يكون بإمكانه ان يحرُثَها ويحفظَها ، لم تكن الحراثة في المرحلة الأولي من وجود الإنسان تعني تعباً او واجباً اضطرارياً لازماً للبقاء علي قيد الحياة ، إنما تُعتبر استمرارية عضوية للفعل الإلهي الخلاق ، كشفاً عن النزعة الإبداعية المتأصلة في بصفته صورة الله وبالتالي بصفته شخصاً .
وبالتزامن ، وهب الله الإنسان ثمار جميع اشجار الجنة طعاماً له ( تك١:٢٩) ، لم تكن حياة الإنسانين الأولين في الجنة روحانيةً ساميةً “مثالية” كما ظن الأخلاقيون في الغالب ، فمنذ لحظاتها الأولي الحياة الإنسانية مشروطة بتناول الغذاء ، بالطعام ، وهذا يعتبر شَرِكَة مباشرة مع مادة العالم ، فالإنسان يمكنه ان يوجد فقط في علاقة مباشرة وعضوية بالعالم ، لا يأتي طلامي علي علاقة فكرية تأملية. فليس الإنسان مجرد مُشاهد او مُراقب ومُفسر للعالم ، انما هو كائن يعرف العالم من خلال تناوله والعمل فيه ، يستوعب ويُحول مادة العالم في لحم جسدهِ . ضمن إطار هذه الشَرِكَة العضوية مع العالم وحدها فقط تتحقق الحياة الإنسانية.
إن قبول الغذاء المؤمن لإستمرارية الحياة قد خلق ليس فقط علاقة وشركة واقعية مع العالم ، بل ايضاً علاقة حية ومباشرة مع الله ، فهو واهب أثمار الأرض ونباتاتها للإنسان ، كشرط مُسبق للحياة ، فكُل تذوق للغذاء هو هبة من الله ، هبة الحياة والبركة ، كشف لموقف الله وعطاياه للإنسان ، تحقيقاً للحياة كعلاقة ، هذه العلاقة التي نشأت بين الله والإنسان في عدن لا تحمل طابعاً اخلاقياً او دينياً ، ليست كطابع للعبادة وتقديم الذبائح والصلوات بل الحياة الإنسانية ذاتها في مُسلمتها المباشرة ، تذوق الغذاء كهبة وعطية ، هو تحقيق للعلاقة مع الله .
انت نجد هذا المفهوم مُجدداً في إفخارستيا الكنيسة ، حيثما يتحقق تواصل الإنسان مع الله ، في جسد المسيح بواسطة اقتبال الغذاء ، الإنسان يتذوق الطعام المُقدم له بواسطة اكثر عناصر جوهرية ( الخبز والخمر ) ، فيتحول هذا التناول الي شرِكَة إلهية – إنسانية، انه يتذوق جسد ودم المسيح الحامل للحياة ، فالإنسان موجود ليس بفضل المواد ذاتها لكن بفضل المواد دُعمت علاقة الإنسان مع الله الي علاقة عضوية ، الغذاء هو هِبة محبة الله ، هو إقتناء لهبة عدم الفساد في حياتنا عربونياً ، لهذا السبب غالياً ما يُشَبَه ملكوت الله في العهد الجديد بمائدة مُعدة من الله نفسه ، [ ان تأكلوا وتشربوا من مائدتي في ملكوتي ] لوقا ٢٢:٣٠
هكذا وهب الله الإنسانَين الأولين فرصة للحياة الحقيقية ، حياة عدم الفساد وعدم الموت ، من خلال إمكانية الشَرِكَة معه ، لكن الحياة بصِفتها عِلاقة و شرِكَة هي في كل الأحوال ثمرة حُرِيِة ، لانه ليست لوحدة المحبة ان تكون مفروضة من الخارج ، هذا يعني انه في حالة الإنسان الأول كانت إمكانية الحُريَة موجودة ، ان يقطعا علاقتهما بالله وان ينتقلا لوجود تَبَعيةًُ ما ، هذه الإمكانية قد عُبر عنها في النص الكتابي بواسطة ” شجرة معرفة الخير والشر “، هي شجرة من ضمن شجر الجنة ، لكنها فُصِلَت عن بركة الله المُوجهة للإنسان ، فبتناول ثِمارها لا يمكنك الإشتراك مع الله ، هي بإختصار إمكانية الإنسان أان يُحقق حياته بإستقرار عن الله ، اي ان يتغذي فقط من اجل حفاظه علي ذاته ، من اجل بقائه البيولوجي ، وفي هذه الحالة لا يوجد الإنسان بعدُ بصفتِهِ شخصاً ، حياته مُتأصلة في الكينونة بواسة رباطات محبة الله المُقدمة له ، لكن بصفتِهِ فرداً طبيعياً ، ” وحدة ” وجودية تعيش علي حِساب قواها وطاقاتها الخاصة وحدها .
حَذَر الله الإنسانَين الأوَلَين من تذوق ثِمار تلك الشجرة ، هل يعني هذا اراد ان يقيهم من الإصطدام بالمُعضِلات الأخلاقية للخير والشر ، ويُبقي عليهما في حيزّ اخلاقيًّ اُحادي الأبعاد ؟
علاما يُعبران مصطلحَي الخير والشر هنا ؟ ليس إلي قواعد الأخلاق او المعايير القانونية للعصر ، التي تُفرق بين ماهو نافع إجتماعياً وما هو ضار ، ينبغي أن نعي الخير والشر في الكتاب المقدس هكذا ، إنهما إمكانية الحياة من جهة او الإبتعاد عن الحياة ( الموت ) من جهة أخري ، لأنه يوم تأكل من الشجرة موتاً تموت (تكوين٢:١٧)
في أقوال الله الواردة لا يوجد وعيد بالعقاب ، لكن تحذير وتوجيه ، فإن ذاق الإنسانان من الثمرة ، فإنما لن ينحرفا عن الطريق المستقيم او يعصيا الله وحسب ، المسألة تتجاوز هذا بكثير ، حينها سيخرجان من الشروط المُسبقة للحياة ، مما يجلب عليهُما الموت ، ستكون محاولاتهما لتحقيق الحياة لا بحسب الإتفاق مع مشيئة الثالوث الواهب الحياة في الأصل لكن بمنهج أخر ، مُناقض تماماً ، ولكنه يندرج تحت إمكانية الحياة بقواهم المخلوقة الزائلة ، بحسب طبيعتهم ، هذا المنهج يُبني علي تَصَوُر الإنسان بأن يضمن ذاته ويضمن عِلتها وغايتها الخاصة .
هذان هم المنهجان في تحقيق الحياة ، فالمنهج الشرير يغوي بإمكانية الإستقلالية ، يغوي الإنسان انه قادر علي تأليه ذاته بمعزل عن الله ، ولكن هذا رجاء كاذب ، خِداع ذاتي ، هذه المعرفة المُرة الذي اراد الله ان يقي الإنسانية منها هي تقودهم للموت ، وعلي اي حال فإنهم قد فَضَّلا طريق الموت عامين عواقبه المآساوية من قِبَل الله ، ولكنها في هذا الظرف قد خُدعا ايضاً بغواية الحية – رمز الشر .فالتأويل الكنسي يري في صورة الحية إبليس نفسه ، الذي يُمثل كائنا روحياً مشابهاً لملائكة الرب ، لكنه تنكَّرَ للحياة واختار الموت .