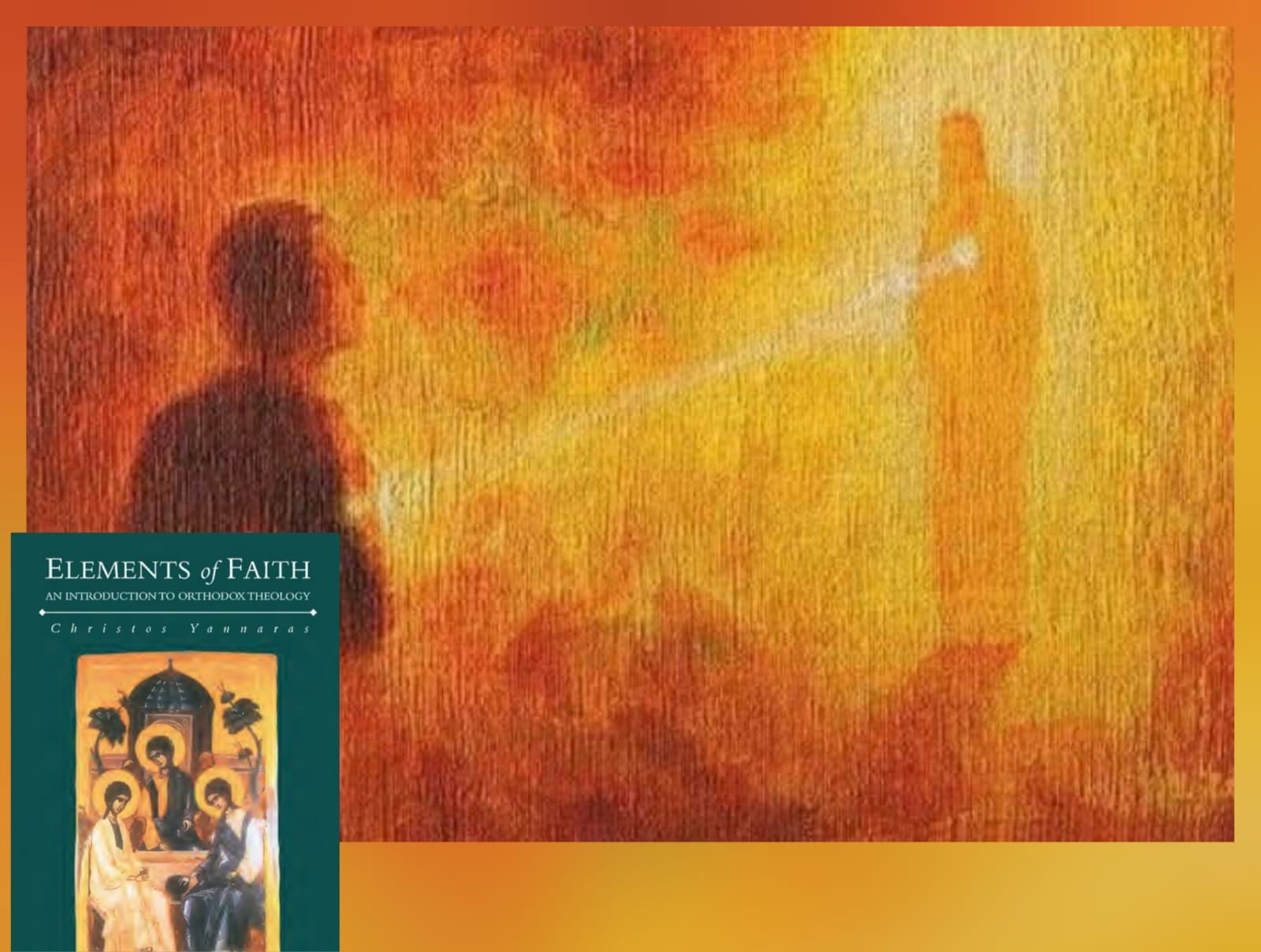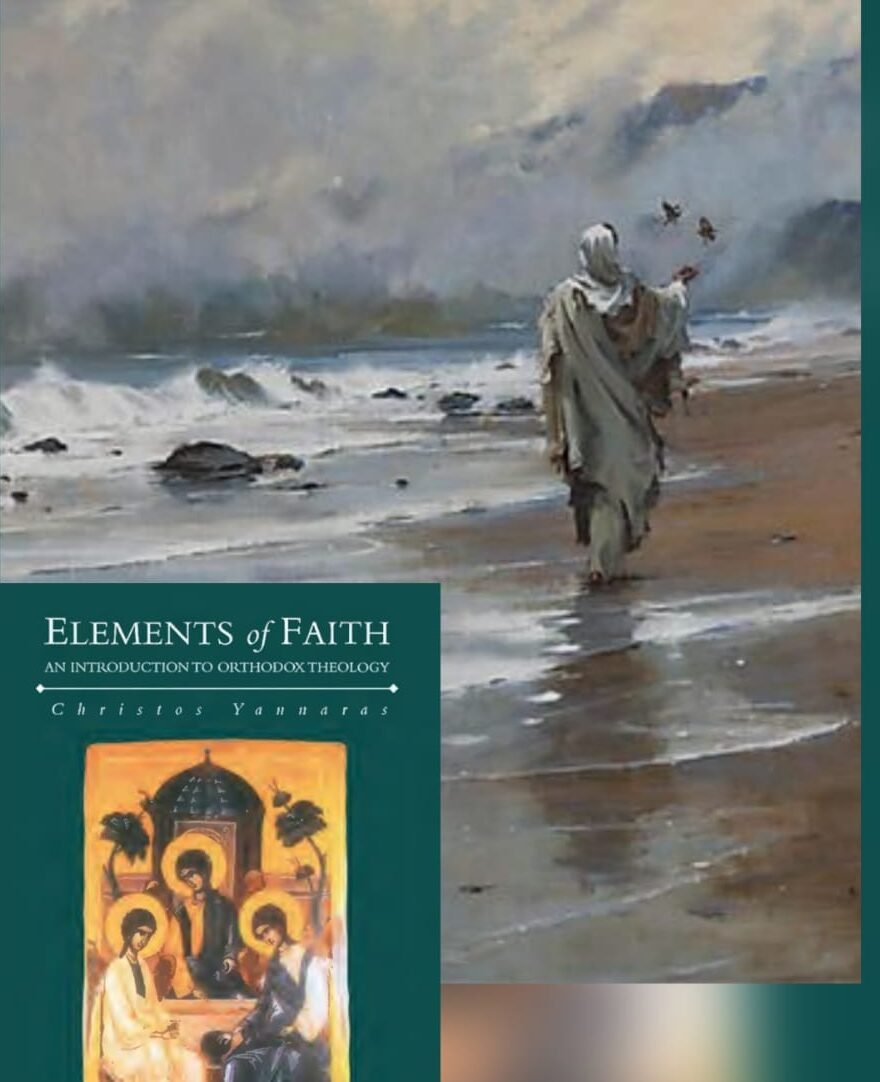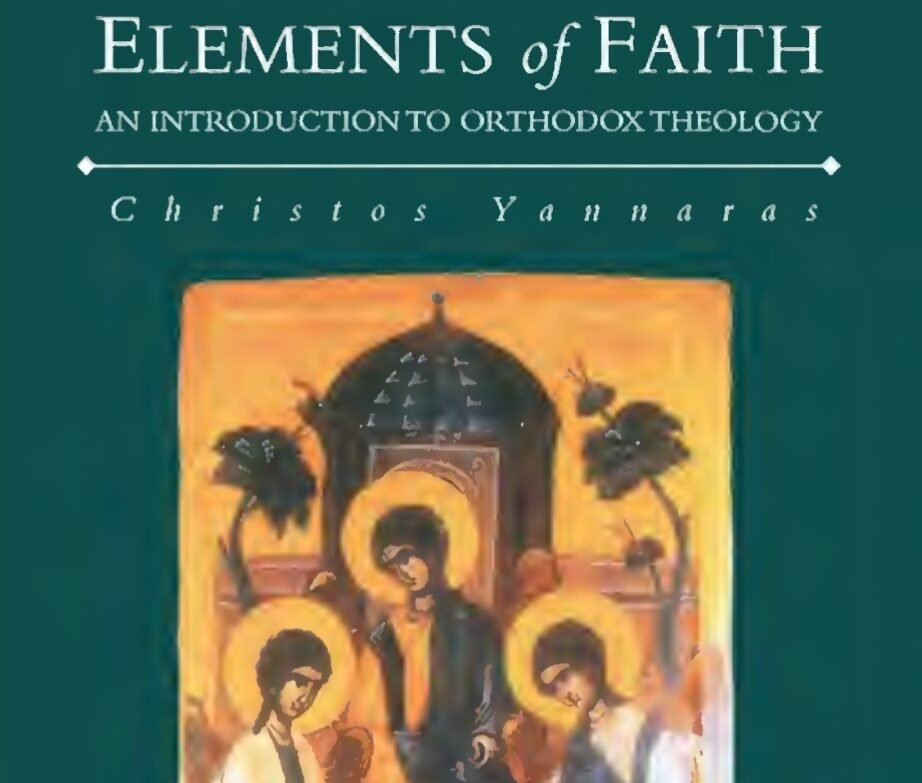– العَريُّ
هكذا حدث سقوط الإنسان ، و بقولنا السقوط لا نعني انحداراً في قيمة الإنسان ، لكن تغيراً في منهج وجوده ، منهج الكينونة ، إنحرافاً كُلياً في الحياة ، يرسم النص الكتابي هذا الإنحراف وعواقبه بصورٍ دقيقةٍ ..
يظهر الشعور بالعُريَّ عاقبة اولي للخطيئة : وللوقت انفتحت اعينهما وعلما بأنهما عريانان فخاطا اوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر (تكوين ٣:٧)
اما قبل لحظة السقوط فكانا كِلاهما عُريانان وهما لا يخجلان ( تكوين ٢:٢٥)
ما الذي يعني الإحساس بالعَريِّ والخجل منه المرافق للخطيئة ؟
يجري التعبير به عن الوعي بحقيقة ان النظرة “المُركزة” عليَّ ليست نظرة الكائن المُحب او المحبوب ، الذي آامن له وآثق به ، بل إلي كائنٍ غريبٍ ، ليس في هذه النظرة حُب ، فالغريب يراني موضوع رغباته وشهواته فقط ، وكأنه يجعلني” موضوعاً لتسديدها “، بنظرته يحولني لأداة غير مُشخصنة ، حارِماً إياي من فُرادتي الأعمق التي لا تتكرر، الإحساس بالعري يعني إختلالاً في الموقف الشَّخصاني ، نُكراناً للمحبة ، وحاجةً إلي الحماية من الخطرِ الذي يتجسد منذ هذه اللحظة في الآخر .
فأُدافعُ انا عن نفسي بواسطة خجلي ، إنني اُغطي عُريِّي حتي اُحافظ علي شخصيَّتي ، حتي أتخفَّي عن نظرة الغريب ، حتي لا اُختزل الي شئ او موضوع ، يخدم إرضاء شهوته الأنانية .
من قبل السقوط كان الجسد الكُلي للإنسان يُعبر بواسطته عن الفرادة الشخصية ؛ ففيه قد تجسدت الدعوة الديناميكية نحو الإتحاد بالآخر ، نحو البذل الذاتي في المحبة ، علي العكس ، فإن الإحساس بالعُريِّ والخجل منه ، يَبرُزان في اللحظة التي تتوقف فيها الحياة عن التحقُق في المحبة ، فتُصبحُ غايتها الإكتفاء الذاتي الفردي – إرضاء حاجات الفرد وشهواته ، ولهذا السبب فإنه من بعد السقوط ، وحده الإيروس الحقيقي [ يعني الحب او التوق الي الأخر ] ، بإمكانه ان يُحول العَريَّ الي تعبير عن الثِقة والبذل الذاتي الأسمي ، مُنقذاً إياه من نيرِ الخجل . قال نيتشه الذي مع إلحاده لم يفقد إحساسه بالحقيقة أبداً : في الحب الحقيقي ، النفس تُغطِّي الجسد ” وفي المقابل ، يُكمل مار إسحق السُرياني هذه الفكرة قائلاً : “المحبة بطبيعتها لا تعرف الخجل ، وتنسي كُل حدودِ ”
إن الإحساس بالعرِّي والخجل منه هما الشهادة الأصدق علي ذلك الإنحراف ، الذي اختبرته الطبيعة البشرية نتيجة السقوط، وقد استبانت صورة الله في الإنسان مُذِلة ومشوَّهةً ولكن جزئياً ، تتجسد هذه الصورة الحقيقية في المنهج الشخصاني الثالوثي للوجود ، في المحبة الشخصانية ، التي وحدها بإمكانها ان تُعيد توحيد حياة وإرادة وطاقة الطبيعة ، أما إذا كانت محبة الشخص خاضعة ، ولو جزئياً ، للحاجة الفردية إلي الوجود الطبيعي المستقل فإنها تتحول إلي غريزةٍ ، إلي ميل أعمي ، وشهوة غير عاقلة ، نتيجة لذلك تنقسم الطبيعة إلي أفراد ، يعيش كل واحدٍ منهم لنفسِهِ فقط ، أفراد غدارين في علاقاتهم مع بعضهم البعض ، ومتنازعين فيما بينهم علي حقهم في الحياة والوجود .
٢- الشعور بالذنب ومحاولة التبرير الذاتي
سمعَ الإنسانان الأوَّلان خطوات وصوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوبِ ريحِ النهارِ ، فاعتراهما خوف شديد حتي انهما اسرعا للإختباء من وجهه ، حينئذ دعا الله آدم سائلاً إياه ، عن سبب هذا التَّخوُفِ ، فنسب آدم ذلكَ إلي عَريِهِ ، حتي امام وجه الله يري نفسه عرياناً ، حتي نظرة الله قد بدت له وكأنها تهديداً ، وإنتهاكاً لفرديتهِ . لقد كفَّ الربُ عن ان يكون قريبه او محبوبه ، فالعلاقة معه فقدت تِلكَ السِمة ، صار الله ذاته في عينِ آدم هو “الغريبُ” ” الآخر ” الذي بحضوره يُضيق الإستقلالية الفردية للإنسان .
سأل الله: هل أكلت من الشجرة ؟
فأسرع آدم بإلقاء المسؤولية علي المرأة : “المراة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت”
حينئذ اتجه الله إلي حواء : “ما هذا الذي فعلتِ؟”
اما هي فبدورها بررت ذاتها : ” الحية اغوتني فأكلتُ ”
لقد برزت الخطيئة المُقترفة في محاولات الدفاع عن الذات المستميتة ، ومسعاهم لإلقاء المسؤلية علي الآخر وان يبررا انفسهما.
إن كان الإحساس بالعري والخجل يكشفان عن فُقدان المنهج الشخصاني والعلاقاتي للوجود ، فإن الهروب من المسؤولية وتبرير الذات المقترنين بالخوف هما تعبير عن القلق والحزن الذين اُثيرا من خسارة الحياة الأبدية ، هذا هو الخوف من الموت .. هذا الإستنتاج ليس إعتباطياً بل مُستنداً علي التفسير الكنسي للنصوص الكتابية ، دعونا نتسائل : مِمَّا خاف آدم وهو مختبئاً من وجه الله ؟ مِمَّا يريد ان يحمي ذاته طارحاً بمسؤولية خطيئته علي إمرأته ؟ هل هو ذا يشعر بخطر خارجي او تهديد عام ؟
أليست تجربة الخطر الخارجي كانت ما تزال غائبة عنه بعد ، وإذا ألقيما نظرة منطقية ، فالخوف نفسه يجب ان يكون شعوراً غريباً عنه بنفس الدرجة التي يكون فيه غريباً عن الطفل الذي يمد يديه إلي النار . عادةً ما يُجيب الأخلاقيون هكذا : لقد عصي آدم وصية ألله وانه الآن خائف من العقاب .
ولكن مصطلحَي المعصية والعِقاب متولدان عن خبرة الحياة الإنسانية في العالم بعد السقوط ، قبل السقوط لم يكونا في مُفردات الحياة الإنسانية ، اما ان تجاهلنا ذلك وجعلنا منهما قيماً مُطلقة وقبلنا بهما كتفسير وحيد لخوف آدم فنصطدم بأسئلة جديد تقودنا إلي طريق مسدودة ، كيف أمكن لأدم ان يختبر الخوف أمام الله الذي هو يعرفه بصفتِهِ مُحباً بعُمق وواهباً للحياة .. فإنه لو كان للمُحبينَ حباً حقيقياً ، يتسمون بهبة الغُفران ونِسيان اخطاء المحبوب ، فستكون محبة الله حسب التصور الخاص بالمعصية والعقوبة فاقدة القوة امام المحبة البشرية ، حاشا ، الِعل محبة الله اضعف من محبة الآب الحنون والأم الشفوقة والعاشِق المُلتهب حباً ؟ الِعل الله الذي طالبنا ان نغفر ” سبعين مرة سبع مرات ” لا يقدر ان يغفر مرة واحدة ؟ [حاشا ان يستقيم هذا التصور عن الله ] .
يسأل الأخلاقيون : ولكن آليس الله عادلا بعد ؟ انه يجب عليه ان يتمم قضاء ان يُعاقب الجُرم الذي اقتُرفَ !
ولكن من المهم ان نسألهم : من أين اتوا ب ” يجب ” هذه التي يُخضعون الله ذاته لها ؟ ما هي الضرورة التي يفرضونها علي الله التي تحد من المحبة الإلهية وبالتالي من الحرية الإلهية ؟. لو وُجدت ضرورة كهذه فحينها يكفُ اللهوعن ان يكون إلهاً ، واقلَّهُ ، فإن هذا ليس هو إله الكنيسة ، فالإله العادل بهذا المنطق ، المُراقب الصارم لحفظ المعايير والقواعد الواجبة عليه هو نفسه ، ليس هو اكثر من ثمرة فاسدة للمُخيلة البشرية الساقطة في الخطيئة . مهما تمكََر الأخلاقيون في محاولاتهم بأن يوفقوا بين محبة الله وعدله ” بحسب تصورهم ” فإن تركيباتهم القياسية المنطقية مُهددة بالتحطُم في لحظةِ واحدة .
يقول مار إسحق السُرياني:” كما لا يُمكن لحبة رملٍ ان تُقاس من حيث حجمها مع كتلة ذهب كبيرة ، هكذا ايضاً فالحاجة إلي جزاء عادل ، لا تُقاس بالرحمة الإلهية ، إن إله الإعلان الكتابي والخبرة الكنسية ليس إله العدل ، لأن عدلِه ليس بّيناً مقارنةً بخطايانا ، أين [ يتحقق ] إذن عدل الله ؟ فقد قيل أنه مترحم علي الخُطاة الأشرار ”
٣- مأساة الخليقة :
إن هذه الحقيقة الأساسية والمُعاشة والمُثبتة من الخبرة الكنسية ، تتناقض ظاهرياً مع النصوص الكتابية العديدة التي يجري فيها الكلام عن عِقاب إلهي او تهديد بالعقاب :
فلنتذكر الطوفان الذي اهلك كل حيٍّ علي الأرض بإستثناء سُكان فلك نوح ، او النار والكبريت الذين اخربا سدوم وعمورة ، الضربات علي فرعون ، العقاب الذي عوقِبَ به داود علي خطيئته بموت ابنه إبشالوم ، وكذلك في العهد الجديد ، الصورة الغالبة للدينونة والجزاء الآتيَّينِ ، إفراز الأبرار عن الخُطاة ، التهديدات بالعذابات الجحيمية المترافقة ، ب ” البكاء وصرير الأسنان ” . ويمكن ان تُضاف إلي هذه الأمثلة الكتابية أيضاً الكوارث الطبيعية ، التي يميل الناس الي اعتبارها عقاباً إلهياً ، شهادةً علي غضبه : الزلازل والفيضانات والأوبئة ..الي آخره .
وعلي أي حال ، فالكنيسة لا تخلِط بين الصُور الكِتابيَّة والحقيقة المُعبر عنها من خلال هذه الصور ، الحقيقة هي واقع السقوط في الخطيئة ، الذي تفسيره قانونياً لا يتبين سليماً كما أشرنا سابقاً، إن السقوط في الخطيئة هو إنحراف لمجري الحياة ، هذا الإنحراف لا يمس حرية الإنسان وحسب ، بل ويجرُ ورائه العالم المخلوق كلَّه أيضاً ، بقدر ما يمكن لغاية هذا العالم وجوهريته ان تتحقق من خلال الحرية الإنسانية وحدها .
تالياً فإن إنحراف الحياة يعني إختلالاً وتخريباً للمنهج الطبيعي الكُلي للعملية الحيوية ، ففي كل الأمثلة الكتابية المُتعلقة بالعِقاب الإلهي تقريباً وفي كل الكوارث الطبيعيَّة الواقع ثِقلها علي الإنسان ، تري الطنيسة عاقبة ناجمة عن إنحراف مجري الحياة والغاية ، مجري النواميس المُنظمة لحياة الخليقة ، عاقبة ناجمة عن ابتعاد خليقة الله عن “الحياة الحقيقية”
نتيجةً لثورة الإنسان انفتحت هوة فاصلة بين المخلوق وغير المخلوق ، إن هذه العواقب المأساوية الناتجة عن السقوط في الخطيئة قد عُبِّر عنها في اللغة التَّربوية للكتاب ( وفي اللغة التربوية للعهد القديم قبل كل شئ ، التي وُجهت الي الشعب ” المتقسِّي القلب ، غليظ الرقبة ) بالصورة المُتاحة وحدها لإستيعاب إنسان الخطيئة : صورة الإله الغاضب المُعاقب للمعصية .
وعلي أي حالٍ فإن الله ليس قاضياً مؤدباً ، إنه ببساطة يتعاملُ بجدِّيَّة قُصوي مع حُريَّة الإنسان ومع نتائج اختياراته الحُرة ، مهما كانت مُرة ، إنه لا يتدخل ليزيل ثِمار الحرية الشخصية للإنسان ، لأنه حينها سيزيل الحق نفسه من الشخصية الإنسانية علي إمتداد نطاقها الكوني ، الأمر الوحيد الذي يَبرُز تَدَخُل الله فيه وتتجلي فيه محبته ، هو انه يُحول العِقاب او النتيجة المُرة المُلقاة من الإنسان علي ذاته بإرادته واختياره ، إلي فعل تربوي خلاصي ، نري ذروة هذا التدخل كان في تجسد الله نفسه.
إن الجسد الإلهي – الإنساني قد قَبِلَ في ذاته كل العواقب الآتية من تمرٌُد الإنسان ، “حتي موت الصَّليب ” ليحولها الي وسيلة للشَّرِكة مع الآب وبالتالي إلي إمكانية حياة أبدية .
ينفتح امام الإنسان منذ هذه اللحظة مجدداً الخيار بين الحياة والموت ، بين تحويل الموت إلي حياة علي مِثال آدم الثاني ” المسيح ” او الإصرار علي الموت ، علي البقاء في عذاب اللا محبة وحينها ، لايأتي كلامنا عن إلغاء بسيط لقواعد الخطية ، ما يكون هنا له وقعٌ تدميري علي الطبيعة الإنسانية .
الكنيسة تري في خطيئة آدم ( بمعناه الكوني او اللاتزامني المُقترن بكُل إنسان ) انها المأساة الأعمق ، التي تكشف في الوقت ذاته عن الحدود اللا متناهية للحُرية الشخصية وعن البُعد الكوني لحقيقة الشخص الإنساني . وأخيرًا، تكشف “مجد” الله، وعظمة صورته المختومة على الطبيعة البشرية. هذه الرؤية تميزها الكنيسة في مأساة السقوط، رؤية تعطي معنى للخليقة كلها. “فإن الخليقة تتوق بلهفة إلى استعلان أبناء الله. … نحن نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معًا إلى الآن” (رومية 8: 19، 22). المغامرة الكونية التي بدأت في جنة عدن ليست فشلًا لعمل الله. هذا العالم من الكوارث الطبيعية، والحروب، والأوبئة، والظلم، والجرائم، العالم المليء بأنين الضحايا الأبرياء، وصيحات الأطفال المضطهدين، الذي يُسكر حرفيًا بالدماء والدموع، هذا العالم مع ذلك ليس انتصارًا للعدالة، بل هو في عيون المؤمنين انتصارًا للحرية التي تكتسب شيئًا فشيئًا وخطوة بخطوة الرحلة نحو التألّه، تقودها يد محبة الله. “إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا … لأن الخليقة نفسها أيضًا ستُعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله” (رومية 8: 18، 21). تألّه الإنسان والعالم الذي لن يكون حدثًا للحرية، هذا هو ما سيكون فشل عمل الله. التألّه غير الحر هو بحد ذاته شيء متناقض وسخيف .