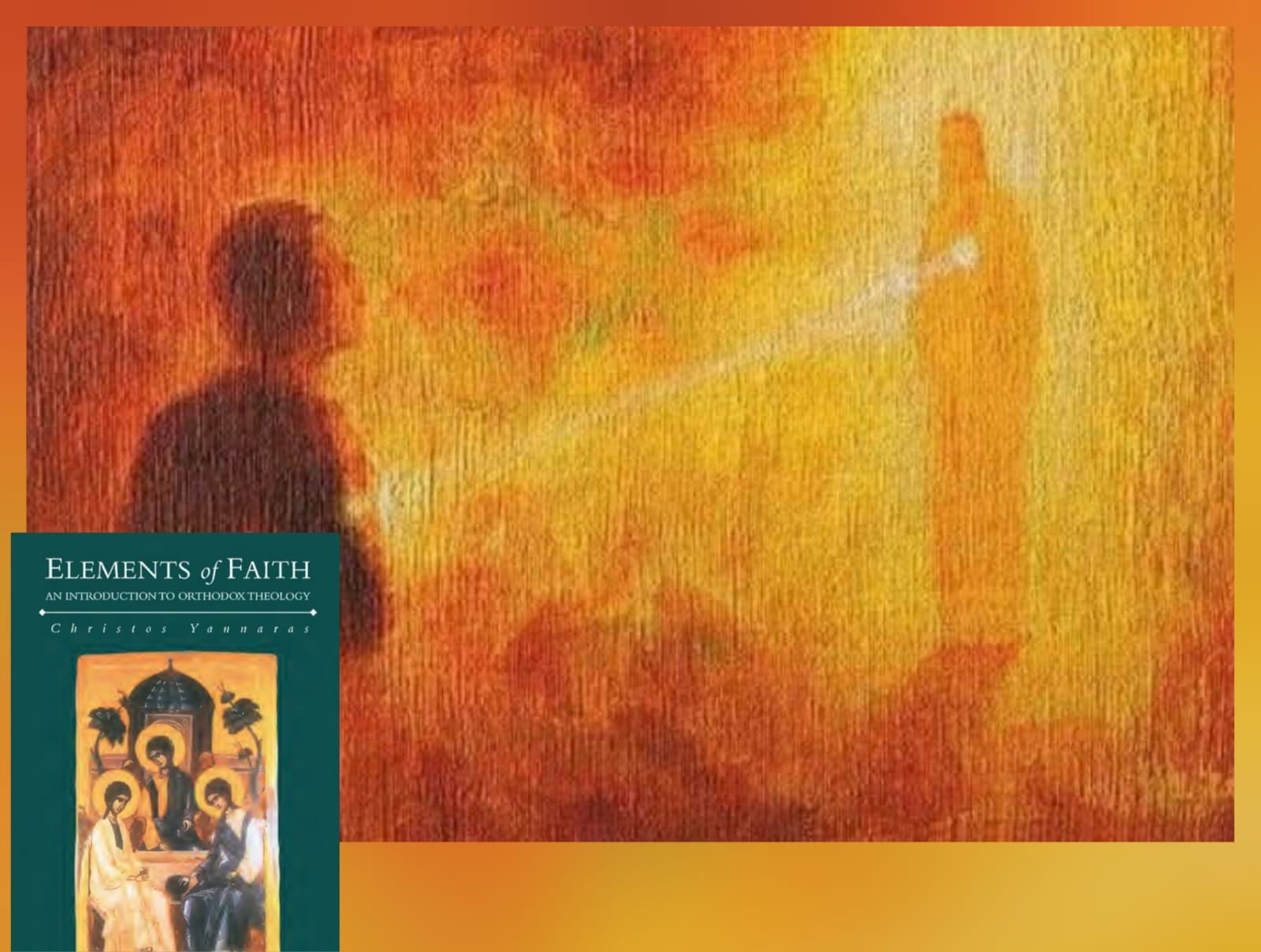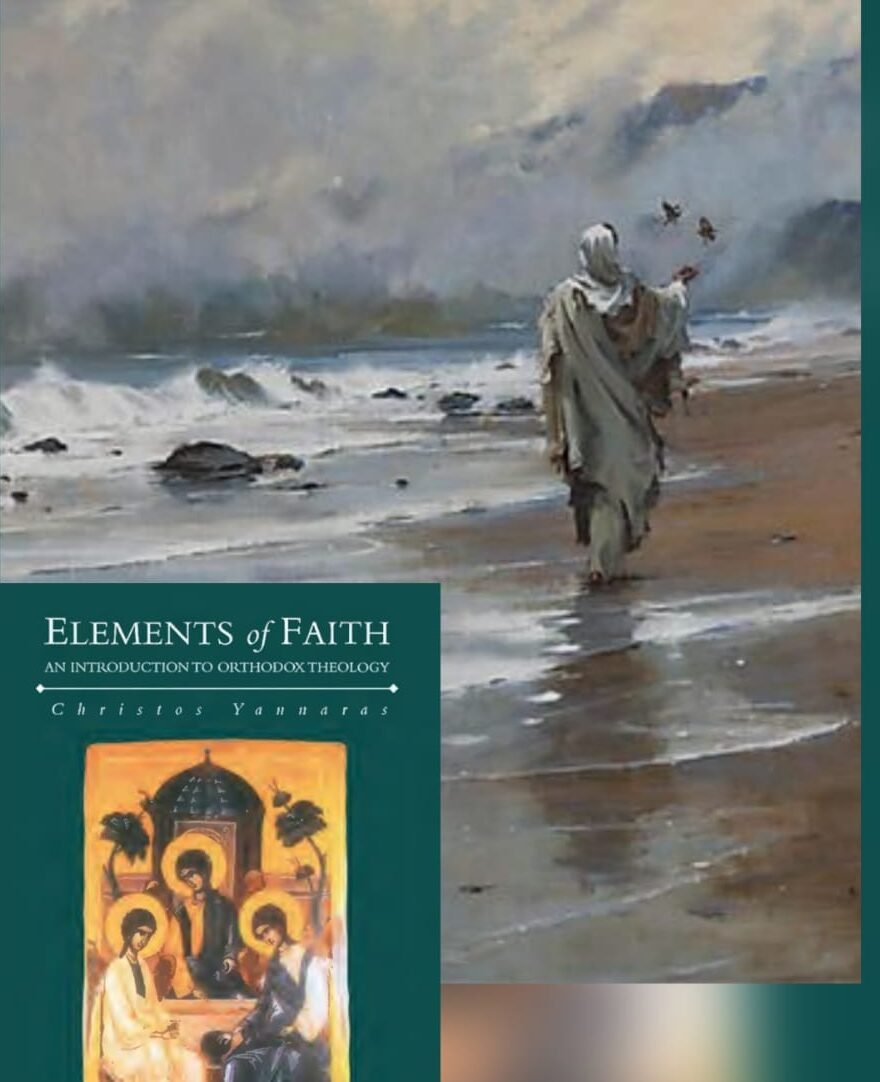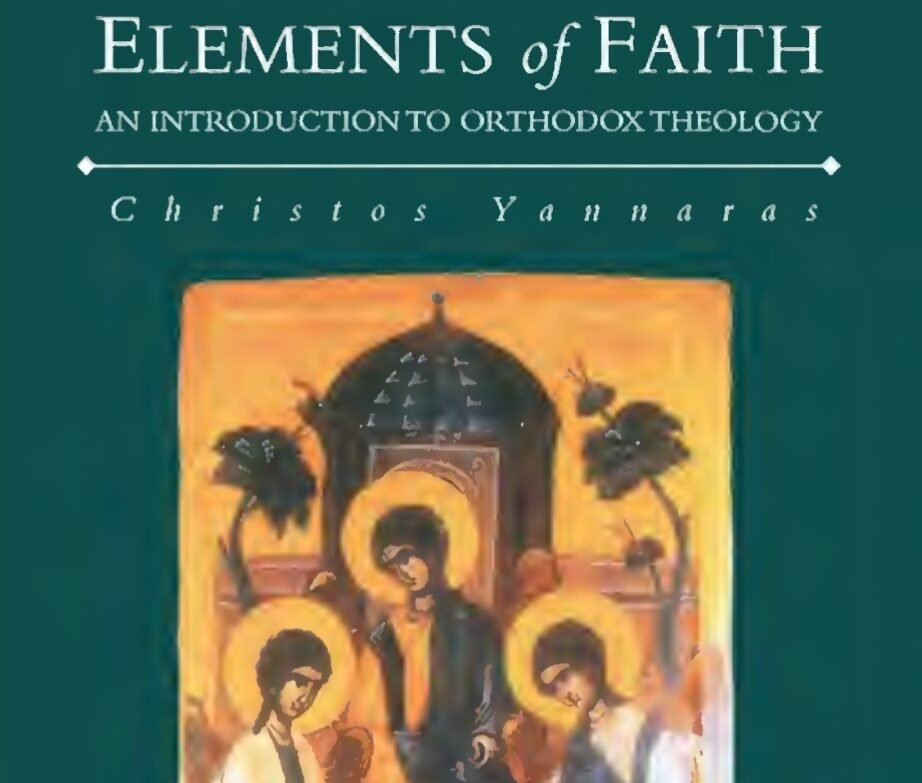لم يعد موضوع البيئة مجرّد قضية علمية أو سياسية، بل غدا اليوم سؤالًا لاهوتيًا وجوديًا بامتياز.” فالإنسان المعاصر، الذي يواجه التهديدات الكونية من تغيّر مناخي واحتباس حراري وانقراض أنواع حية وتلوّث شامل، يجد نفسه مدفوعًا إلى إعادة التفكير في علاقته بالعالم المخلوق. لم يعد ممكنًا النظر إلى الطبيعة كـ «مخزون موارد» يُستغل من أجل رفاهية البشر فحسب، بل كبيت مشترك، بلغة البابا فرنسيس، وكأيقونة حيّة لله، بحسب تقليد الكنيسة الأرثوذكسية.
إنّ اللاهوت الأرثوذكسي، بما يحمله من غنى في التعليم الآبائي، يقدّم أفقًا مغايرًا لفهم البيئة والطبيعة. في قلب هذا اللاهوت يقف مفهوم اللوغوس، الكلمة الأزلي، ابن الله، الذي «به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان» (يو 1: 3). ومنه تتفرّع اللوغوي، أي الكلمات أو المبادئ أو المقاصد الإلهية الكامنة في كل كائن، والتي تمنح الخليقة معناها وغايَتها. بهذا، لا تُفهم الطبيعة بوصفها مادة عمياء أو نظامًا آليًا مغلقًا، بل كواقع محمول بكلمة الله، ومرسوم في قصد إلهي أزلي.
لقد شدّد الآباء منذ أوريجانوس وآباء الإسكندرية، مرورًا بالآباء الكبادوكيين، وصولًا إلى ديونيسيوس الأريوباغي ومكسيموس المعترف، على أنّ الطبيعة ليست شرًا ينبغي الفرار منه، ولا إلهًا يُعبد بذاته، بل مجال لقاء مع الله. فالخليقة «حسنة جدًا» (تك 1: 31) لأنها تحمل اللوغوي الخاصة بها، أي مقاصد الله التي بها وُجدت، والتي بها يمكن أن تعود إلى ملئها في اللوغوس. وهنا يتكشّف البعد البيئي في اللاهوت الأرثوذكسي: الخليقة ليست مجال هيمنة مطلقة للإنسان، بل مجال كهنوتي، والإنسان مدعو لأن يكون «كاهن الخليقة»، رافعًا الكون في الشكر والتسبيح إلى الله.
ومن هنا جاء وصف البطريرك برثلماوس، المعروف بلقب «البطريرك الأخضر»، حين قال: «تدمير البيئة هو خطيئة» (Bartholomew I, 1997). وهو ما فسّره اللاهوتي الأرثوذكسي جون كريسافجيس بأنّ البطريرك «لم يقدّم مجرد نقد أخلاقي، بل إعلانًا لاهوتيًا: أن الاعتداء على الخليقة هو في جوهره اعتداء على الله نفسه الذي تجسّد من أجلها» (John Chryssavgis, Cosmic Grace, Humble Prayer).
إذاً، فإنّ موضوع البيئة في المنظور الأرثوذكسي ليس ملحقًا باللاهوت أو قضية ثانوية، بل هو جزء لا يتجزأ من العقيدة المسيحية: من فهم الخلق، التجسد، الليتورجيا، الخلاص، وحتى التألّه (theosis). إنّه لاهوت بيئي متكامل، يجد جذوره في فكر أوريجانوس وآباء الإسكندرية، وينمو في اللاهوت الكبادوكي، ويتبلور بعمق عند ديونيسيوس ومكسيموس، ثم يُستعاد اليوم في خطاب البطريرك برثلماوس ولاهوتيي عصره.
بهذا المعنى، يشكّل لاهوت البيئة الأرثوذكسي ليس مجرد دعوة لحماية الأرض من التلوّث، بل دعوة لتجديد علاقتنا بالله والعالم معًا، عبر استعادة الرؤية الليتورجية–النسكية التي ترى في الطبيعة مجالًا للشكر والقداسة. إنّه نداء إلى التوبة الكونية، حيث يُفهم الخلاص لا كمصير فردي للإنسان وحده، بل كتجدّد الخليقة بأسرها في المسيح.
◽️التراث السكندري وفكر أوريجانوس
في تاريخ اللاهوت المسيحي، يمثّل التراث السكندري أحد المنابع الأساسية لفهم علاقة الله بالخليقة. فمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، منذ بداياتها مع بانتينوس وكليمندس وأوريجانوس، قدّمت قراءة روحية وفلسفية للنصوص الكتابية، حيث رأت أن العالم ليس مجرد مادة عابرة، بل له معنى عميق يتجلى في اللوغوس.
● أوريجانوس والخليقة كمدرسة لاهوتية
يُعتبر أوريجانوس (185–254م) أحد أبرز مفكري هذه المدرسة. ورغم الجدل الذي أحاط بأفكاره، إلا أن رؤيته للخليقة ظلت علامة فارقة في اللاهوت المسيحي المبكر. فقد رأى أن الخليقة تحمل في داخلها “كلمات” أو “أسباب” متجذّرة في اللوغوس الإلهي. هذه الكلمات، أو اللوغوي (λόγοι)، هي مبادئ روحية تفسّر وجود الكائنات وتوجّهها نحو غايتها النهائية، أي نحو الله.
كتب أوريجانوس في مؤلفاته التفسيرية أن كل كائن في الكون، من أصغر ذرّة إلى أعظم نجم، إنما يحمل في داخله بذرة من الحكمة الإلهية، وأن معرفة الله لا تنفصل عن التأمل في الخليقة. فالطبيعة، بحسب تعبيره، هي “كتاب آخر” إلى جانب الكتاب المقدس، كلاهما يشهد للّه ويقود إلى معرفته.
● الخلق كعملية مستمرة
أحد أبعاد فكر أوريجانوس المهم هو أن الخلق ليس حدثًا تاريخيًا وقع في الماضي فقط، بل هو فعل مستمر. الله يخلق العالم دومًا بكلمته ويحفظه في الوجود. هذا المفهوم يجعل الخليقة واقعًا ديناميكيًا متجددًا، لا مجرد مسرحٍ ثابت لحياة الإنسان. ومن هنا، تصبح الإساءة إلى الطبيعة ليست فقط خطيئة أخلاقية، بل هي تحدٍّ مباشر لإرادة الله الخالقة المستمرة.
● البعد الروحي والمعرفي
لقد شدّد أوريجانوس أيضًا على البعد الروحي للمعرفة الطبيعية. فمعرفة العالم، بالنسبة له، ليست مجرّد اكتساب معلومات علمية، بل هي مسيرة صعود روحي نحو الله. وبما أن كل كائن يشارك في اللوغوس بطريقة ما، فإن فهم الخليقة هو نوع من المشاركة في الحكمة الإلهية. وهكذا، تتحوّل دراسة الطبيعة إلى ممارسة نسكية، وإلى نوع من “التأمل الصوفي”، حيث يقودنا كل كائن إلى كلمة الله.
● أهمية التراث السكندري اليوم
ما يميّز هذا التراث هو قدرته على دمج الفلسفة مع اللاهوت، والعقل مع الروح، والطبيعة مع الوحي. فبدلًا من النظر إلى البيئة كواقع خارجي محايد، يرى الفكر السكندري أن الخليقة شريك في مسيرة الخلاص. هذه الرؤية هي ما تحتاجه إنسانية اليوم التي فصلت بين العلم والإيمان، وبين الطبيعة والروح، ففقدت المعنى الأعمق للوجود.
إن استعادة فكر أوريجانوس في السياق البيئي المعاصر لا يعني تبني كل أطروحاته، بل يعني استلهام رؤيته الأساسية: أن الخليقة تحمل في داخلها اللوغوي، وأن الإنسان مدعو لاكتشافها وتقديسها عبر مسيرة روحية وعملية في آن واحد.
◽️الكبادوكيون والرؤية الإيجابية للخليقة
يمثّل الآباء الكبادوكيون – باسيليوس الكبير (†379م)، غريغوريوس النزينزي (†390م)، وغريغوريوس النيسي (†394م) – مرحلة أساسية في تطوّر اللاهوت المسيحي، خصوصًا فيما يتعلّق بعلاقتهم بالخليقة. هؤلاء اللاهوتيون لم يقدّموا فقط دفاعًا لاهوتيًا عن الثالوث، بل طوّروا أيضًا نظرة متكاملة للطبيعة والإنسان والعالم.
باسيليوس الكبير والخليقة كأيقونة لله
في عظاته الشهيرة “الستة أيام” (Hexaemeron)، يتأمل باسيليوس الكبير في رواية التكوين، ليكشف أن الطبيعة ليست مجرد “مواد” بل هي إعلان إلهي. الطبيعة في نظره كتاب مفتوح يكشف عن عظمة الخالق. كتب باسيليوس:
“من يتأمل في جمال الخليقة، يترقى من خلال هذا الجمال إلى الله ذاته، كما يتعرف على الرسام من خلال لوحته” (Hexaemeron, Hom. 1).
هذه الرؤية تجعل كل عنصر في الطبيعة – من النجم في السماء إلى قطرة الماء – أيقونة حيّة لله. ومن هنا، تنبع دعوة باسيليوس إلى احترام الخليقة كأمانة مقدّسة، وعدم التعامل معها كشيء قابل للاستغلال المفرط.
غريغوريوس النزينزي والخليقة كفضاء للشكر
أمّا غريغوريوس النزينزي، المعروف بلقب “اللاهوتي”، فقد رأى أن علاقة الإنسان بالطبيعة يجب أن تُفهم في إطار الشكر والعبادة. فالإنسان، بحسبه، ليس سيّدًا متعجرفًا على العالم، بل هو “كاهن الخليقة”، الذي يقدّمها إلى الله في فعل تسبيح وشكر. كتب قائلاً:
“الإنسان هو المخلوق الذي يوحّد ما هو منظور وما هو غير منظور، ويجعل من العالم مادةً للتسبيح” (Orat. 45).
في هذا المنظور، تتحوّل علاقة الإنسان بالطبيعة إلى علاقة ليتورجية: كل عمل بشري حقيقي هو جزء من إفخارستيا كونية، حيث تُقدَّم ثمار الأرض وحياة البشر في سرّ الشكر.
● غريغوريوس النيسي والخليقة كحركة نحو الكمال
أما غريغوريوس النيسي، فقد ركّز على البعد الديناميكي للخليقة. رأى أن العالم في حالة حركة دائمة نحو الكمال، وأن كل الكائنات تشترك في مسيرة صعود نحو الله. الخليقة، بحسبه، ليست ثابتة أو مكتملة، بل هي في رحلة مستمرة من النمو والتحول. هذا البعد يجعل الطبيعة شريكًا للإنسان في السير نحو الله، ويكشف أن الاعتداء على البيئة يعني تعطيل هذا المسار الكوني نحو الكمال.
● وحدة الرؤية الكبادوكية
إذا جمعنا هذه الرؤى الثلاث، نكتشف أن اللاهوت الكبادوكي يقدّم تصورًا إيجابيًا عميقًا للخليقة:
• الخليقة أيقونة لله (باسيليوس).
• الخليقة مادة شكر ولها طابع ليتورجي (غريغوريوس النزينزي).
• الخليقة ديناميكية متحركة نحو الله (غريغوريوس النيسي).
بهذا، لا يعود الإنسان سيّدًا مستبدًا على الطبيعة، بل يصبح خادمًا وكاهنًا لها، شريكًا معها في المسيرة نحو الكمال الإلهي. هذه النظرة هي الأساس الذي استند إليه لاحقًا لاهوتيون مثل مكسيموس المعترف، وصولاً إلى البطريرك برثلماوس في العصر الحديث.
◽️ديونيسيوس الأريوباغي ومكسيموس المعترف — تأمل مفصّل في اللوغوس، الليتورجيا، والتألّه
يُشكّل كلٌّ من ديونيسيوس الأريوباغي (Pseudo-Dionysius the Areopagite) والقديس مكسيموس المعترف (Maximus the Confessor) نقطتين محوريتين في مسيرة اللاهوت الأرثوذكسي. فالأول رسم ملامح الرؤية الأپوفاتيكية والهرمية والليتورجية للعالم، والثاني أخذ هذه البنية وأدخلها في قلب الأنثروبولوجيا الروحية، ليقدّم خريطةً تربط بين الحواس البشرية والفضائل واللوغوي (λόγοι) الكامنة في الخليقة، في مسيرة تنتهي بالتألّه (θέωσις). قراءة الاثنين معًا تُظهر كيف أنّ معرفة الطبيعة لا تُختزل في بعدٍ عقلي أو فلسفي بارد، بل تتحوّل إلى خبرة روحية ليتورجية تقود إلى الاتحاد بالله.
١. لماذا نقرأ ديونيسيوس ومكسيموس معًا؟
ديونيسيوس قدّم البنية الكونية–الليتورجية، حيث الخليقة كلّها تسير في ترتيب هرمي يعكس حضور الله عبر الأسماء الإلهية والوسائط. أما مكسيموس فأخذ هذه الرؤية وربطها بالإنسان: حواسه، أهواؤه، وفضائله. فديونيسيوس بيّن كيف تُكشف الإرادة الإلهية في نظام الوجود، ومكسيموس أوضح كيف يتلقّى الإنسان هذه الحقيقة عبر مسيرة نسكية–ليتورجية تُحوّل الحواس إلى أدوات معرفة. لذلك، جمعهما معًا يعني إدراك التوازن بين الكوني والأنثروبولوجي، بين الليتورجيا الكبرى والليتورجيا الداخلية.
▫️ديونيسيوس الأريوباغي: اللوغوس كأفعال إرادة إلهية
● المؤلفات والهوية
المؤلفات المنسوبة لاسم «ديونيسيوس الأريوباغي» — الأسماء الإلهية (On the Divine Names)، التراتبية السماوية (The Celestial Hierarchy)، والتراتبية الكنسية (The Ecclesiastical Hierarchy) — تمثّل نقلة في الفكر المسيحي: فهي تصوغ خطابًا لاهوتيًا يجمع بين التراتبية والليتورجيا والمنهج الأپوفاتيكي. (Pseudo-Dionysius, On the Divine Names).
● المنهج الأپوفاتيكي
يعتمد ديونيسيوس على الطريق السلبي (via negativa)، حيث يُعرف الله عبر النفي: الله ليس شيئًا من الموجودات، ولا ينحصر في أي صفة محدودة. يبدأ المؤمن بممارسة «الجهل المقدّس» (unknowing) ليصعد نحو اختبار الله بلا صورة (Pseudo-Dionysius, Mystical Theology). هذا النهج لا يلغي المعرفة، بل يُطهّرها من الصور الضيقة.
● الأسماء الإلهية واللوغوي
في الأسماء الإلهية، يشرح ديونيسيوس أنّ أسماء الله (مثل الخير، النور، الحياة) ليست مجرد ألفاظ بشرية، بل وسائط لحضور الله في العالم. وهنا يمكن فهم اللوغوي (λόγοι) على أنّها أفعال إرادة إلهية: قرارات أزلية صادرة من الله تنظّم الخليقة وتوجّهها. فهي ليست ماهية الله ولا أقنوم الابن (اللوغوس)، بل تعبيرات ديناميكية عن إرادته الخالقة (Pseudo-Dionysius, On the Divine Names).
٢.٤. التراتبية والليتورجيا
أحد ابتكارات ديونيسيوس الكبرى هو الربط بين التراتبية السماوية (الملائكة ومراتب السماء) والتراتبية الكنسية (الطقوس والمراتب الكهنوتية). فالليتورجيا الأرضية مرآة للنظام السماوي، وهي المكان الذي تلتقي فيه السماء بالأرض. هنا يظهر البعد البيئي: العالم الحسي ليس خامة محايدة، بل مجال لعبادة كونية حيث اللوغوي تُكشف في الطقوس (Pseudo-Dionysius, Celestial Hierarchy).
● المادة كأيقونة
ديونيسيوس يرفض الثنائية التي تحتقر المادة. الأشياء الحسية، في منظوره، هي أيقونات تقود إلى غير المنظور. المواد في الطقس ليست رموزًا فارغة، بل وسائط تُشرك المؤمن في النعمة. بهذا المعنى، الطبيعة ليست مجرد موارد، بل شريكة في التسبيح الكوني (Pseudo-Dionysius, Ecclesiastical Hierarchy).
٣. مكسيموس المعترف: اللوغوي، الحواس، والتألّه
● شخصية وسياق
مكسيموس المعترف (580–662م) هو من أعظم مفكري بيزنطة. عاش زمنًا مشحونًا بالصراعات العقيدية (المونوثيلية)، لكنه ترك أيضًا تراثًا روحيًا–لاهوتيًا غنيًا، خصوصًا في كتابه Ambigua حيث أعاد صياغة تراث أوريجانوس وديونيسيوس ضمن رؤية متكاملة تجمع بين الكونيات والروحيات.
● اللوغوي عند مكسيموس
اللوغوي عنده هي مبادئ وجودية أو أفعال إلهية أزلية مودَعة في اللوغوس منذ الأزل، لكنّها تتجلّى في الخليقة كأهداف ومعانٍ. فهي شروط وجود الأشياء ومقاصدها، وفي النهاية تعيدها إلى المسيح، اللوغوس الواحد. وكما قال:
«العالم المعقول مطبوع سرًّا في العالم المحسوس، والعالم المحسوس قائم في العالم المعقول بحسب اللوغوي» (Maximus, Ambigua).
إذن، الخليقة كلها مليئة باللوغوي التي تردّ إلى اللوغوس.
● الحواس كوسائط روحية
في Ambigua 21، يعرض مكسيموس خريطة تربط الحواس بالقوى النفسية:
• البصر ↔️ nous (العقل الباطن)
• السمع ↔️ logos (التأمل العقلي)
• الشم ↔️ thumos (القوة الروحية)
• الذوق ↔️ epithymia (الرغبة)
• اللمس ↔️ zoē (مبدأ الحياة)
إذا رُشدت الحواس بالفضائل، صارت قنوات لمعرفة اللوغوي. يقول:
«هكذا تدرك النفس الأشياء المحسوسة إدراكًا نافعًا عبر الحواس، بعدما تكون قد استوعبت اللوغوي الروحية الكامنة فيها، وتستعمل الحواس نفسها، التي صارت الآن مترشَّدة (logistheisas) بفضل وفرة اللوغوس الذي تحتويه، كوسائط عاقلة لقواها الخاصة… ويحتضن الله النفس كلها مع الجسد الطبيعي المقرون بها، ويجعلهما شبيهين به على النحو الملائم» (Maximus, Ambigua 21).
هذا النص يكشف أنّ الحواس ليست عائقًا بل أداة، شرط أن تُطهّر وتُقاد بالفضائل.
● مسار الفضائل نحو التألّه
المسيرة الروحية عند مكسيموس تبدأ بالفضائل الأساسية، تنتقل إلى اللامبالاة (apatheia)، ثم تبلغ المحبة (agapē)، وهي ثمرة التألّه. التألّه ليس فكرة نظرية بل مسار وجودي: تطهير، ثم تنوير، ثم اتحاد بالله.
● مكسيموس كجسر
يجمع مكسيموس بين عقلية أوريجانوس التأويلية، ولاهوت ديونيسيوس الليتورجي. والنتيجة: رؤية لا تلغي المادة بل تؤلّفها في المسار الروحي، حيث اللوغوي تتجلّى في الخليقة وتردّ إلى اللوغوس.
٤. قراءة نقدية
نقاط القوة
• دمج المعرفة بالممارسة: المعرفة اللاهوتية تتحقق عبر النسك والليتورجيا.
• ليتورجية الكون: الطبيعة كلها تُرى كجزء من العبادة.
• توازن الروح والمادة: المادة وسيط نعمة لا عائق.
التحديات
• خطر النخبوية الروحية إذا حُصر الأمر بالنسّاك.
• غموض الأپوفاتية قد يُساء فهمه كإهمال للعمل البيئي العملي.
• إسقاطات تاريخية قد تستغل لتبرير الانغلاق الطقسي.
•
٥. الأبعاد البيئية والعملية
التقاء ديونيسيوس ومكسيموس يعطينا أساسًا عمليًا:
• الليتورجيا تصبح تربية بيئية، حيث الصلوات تذكّر المؤمن بأن الطبيعة عطية.
• النسك يعلّم المؤمن الاعتدال في الاستهلاك.
• العمل اليومي (كالزراعة أو التنظيف) يُفهم كخدمة ليتورجية للعالم (Schmemann, For the Life of the World).
• الكنيسة مدعوة لدور اجتماعي–سياسي في حماية البيئة.
وهنا يجمع ديونيسيوس ومكسيموس بين رؤية ليتورجية كونية ورؤية نسكية أنثروبولوجية. في الأولى، العالم كله تراتبية تُظهر الله. في الثانية، الحواس تُحوَّل إلى أدوات إدراك للوغوي. وفي النتيجة، الطبيعة تُرى ككلمة من كلمات الله، والإنسان مدعو لأن يجيب عليها بحياة شكر ومحبة.
اللوغوس (المسيح) هو الواحد الذي يحوي الكثرة، واللوغوي هي المعاني المتعددة التي تتجلّى في الخليقة. بهذا المعنى، حماية البيئة ليست سياسة عابرة، بل مشاركة في مسيرة التألّه، حيث يُستعاد للعالم وجهه كأيقونة لله.
◽️البطريرك برثلماوس، جون كريسافجيس، واللاهوت الأرثوذكسي المعاصر حول اللوغوس واللوغوي
يُشكِّل الفكر اللاهوتي المعاصر للبطريرك المسكوني برثلماوس، والمعبَّر عنه بعمق في كتابات اللاهوتي الأرثوذكسي جون كريسافجيس، امتدادًا حيًّا للتقليد الآبائي الذي رأى في الخليقة انعكاسًا للـ اللوغوس الإلهي وميدانًا تُكشف فيه اللوغوي (λόγοι) – أي الكلمات الإلهية المتعددة أو المعاني الداخلية التي تحملها الكائنات. هذا الامتداد ليس تكرارًا آليًا لما قاله الآباء، بل تجديدًا مُبدعًا ينطلق من الأزمة البيئية الراهنة ويعيد قراءة التراث في ضوء التحديات الكونية الجديدة.
١. خلفية لاهوتية: من الرؤية الآبائية إلى الوعي البيئي
لقد علّم القديس مكسيموس المعترف أنّ كل خليقة تحمل في داخلها لوغوسها الخاص، أي معناها الداخلي أو دعوتها التي تردّ إلى اللوغوس الواحد، يسوع المسيح (انظر: Ambigua، PG 91). وهذا التعليم شكّل جسرًا لقراءة الخليقة لا كشيء صامت أو جامد، بل ككلمة إلهية متجسدة في المادة. برثلماوس يلتقط هذه الرؤية ويُسقطها على الواقع البيئي المعاصر، مؤكدًا أنّ تدنيس الطبيعة ليس مجرد خطأ أخلاقي، بل خطيئة روحية، لأنّه اعتداء على حضور الله المتجلّي في الخليقة.
وقد صرّح البطريرك قائلاً:
“ارتكاب جريمة ضد العالم الطبيعي هو خطيئة ضد أنفسنا وضد الله” (Bartholomew, Encountering the Mystery, 2008, p. 100).
هنا يتجلّى الوعي اللاهوتي بأن أزمة البيئة ليست قضية تقنية أو اقتصادية وحسب، بل قضية روحية عميقة تمسّ علاقة الإنسان بالله والعالم.
٢. كريسافجيس: إعادة صياغة التقليد بلغة معاصرة
اللاهوتي جون كريسافجيس، المستشار اللاهوتي للبطريرك برثلماوس، لعب دورًا محوريًا في بلورة ما يُسمى بـ “اللاهوت البيئي الأرثوذكسي”. في كتابه Creation as Sacrament (2019)، يوضح أنّ الخليقة ليست مجرد إطار خارجي لحياة الإنسان، بل هي أيقونة لحضور الله، يُدعى المؤمن إلى النظر إليها والعيش فيها بروح ليتورجية.
يكتب كريسافجيس:
“الكون هو سرّ يُعاش، لا معادلة تُحلّ. والطبيعة تُدرك كعطية، لا كأداة. اللوغوس حاضر في كل ذرة من المادة، واللوغوي هي أنغامه المتناثرة التي تدعونا إلى تسبيح واحد في المسيح.” (Chryssavgis, Creation as Sacrament, 2019, p. 45).
إذن، هو يترجم لغة الآباء عن اللوغوس واللوغوي إلى خطاب معاصر يفهمه الإنسان الحديث، ويجعله قاعدة للاهوت بيئي شامل.
٣. مفهوم “اللوغوس” و”اللوغوي” بلغة أبسط
اللوغوس: هو كلمة الله الأزلي، المسيح، الذي به وُجد كل شيء.
اللوغوي: هي الكلمات أو المعاني المتعددة التي تحملها الكائنات، أي الدعوات الإلهية الكامنة في الخليقة، والتي تعكس اللوغوس الواحد.
يمكن أن نقول ببساطة:
اللوغوس هو “الموسيقي العظيم”، واللوغوي هي “النغمات” التي يعزفها في الخليقة. كل مخلوق يحمل نغمة خاصة، لكنها جميعًا تتناغم في سيمفونية واحدة تعود إلى المسيح.
٤. البعد الروحي والليتورجي
برثلماوس يؤكد أنّ حماية البيئة هي عمل ليتورجي بامتياز، لأنّ العالم نفسه مدعو لأن يصبح “ذبيحة شكر” لله. يقول في إحدى عظاته:
“العالم ليس ملكنا لنتصرّف فيه كما نشاء؛ إنّه عطية لنقدّمها مجددًا لله كافرينسيس (Εὐχαριστία) – أي شكرًا.” (Bartholomew, Cosmic Grace, Humble Prayer, 2003, p. 15).
إذن، الالتزام البيئي ليس نشاطًا سياسيًا أو اجتماعيًا فحسب، بل هو أيضًا سلوك إفخارستي، يعكس روح الصلاة والعبادة.
٥. صدى هذا اللاهوت في العالم المعاصر
بفضل هذه الرؤية، لُقِّب البطريرك برثلماوس بـ “البطريرك الأخضر”، وصار لاهوته البيئي يُدرّس في جامعات غربية كبرى كمدخل لفهم كيف يمكن للإيمان المسيحي أن يواجه التحدي البيئي العالمي. بينما اعتُبر جون كريسافجيس “المفسّر المعاصر للتراث الأرثوذكسي البيئي”، إذ جمع بين العمق الآبائي واللغة المفهومة في سياق النقاشات العالمية.
بهذا، يظهر أنّ لاهوت اللوغوس واللوغوي كما أعاد طرحه برثلماوس وكريسافجيس، هو دعوة إلى إعادة اكتشاف العالم كمكان للحضور الإلهي، وإلى عيش علاقة جديدة مع الطبيعة تُبنى على الشكر، والاحترام، والمسؤولية. فالخليقة ليست ملكًا للإنسان، بل هي كلمة من كلمات الله تنتظر أن تُقرأ وتُحيا في المسيح.
◽️المقارنة بين اللاهوت الأرثوذكسي البيئي والتيارات الغربية المعاصرة
مع تطوّر الفكر البيئي في القرنين العشرين والحادي والعشرين، برزت مدارس غربية عديدة حاولت صياغة رؤية بديلة للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، أهمها الإيكولوجيا العميقة (Deep Ecology) والحركات الخضراء (Green Movements). وفي المقابل، قدّم اللاهوت الأرثوذكسي، خصوصًا من خلال فكر البطريرك برثلماوس وشرّاحه مثل جون كريسافجيس، رؤية روحية لاهوتية تنبع من تراث الآباء والليتورجيا.
1. الإيكولوجيا العميقة: الطبيعة كقيمة في ذاتها
نشأت الإيكولوجيا العميقة مع المفكر النرويجي آرني نايس Arne Næss (†2009م)، الذي أكّد أن للطبيعة “قيمة جوهرية مستقلة” عن المنفعة البشرية. فهي ليست مجرد وسيلة لخدمة الإنسان، بل لها حق في الوجود والحياة. يقول نايس:
“الرفاه الحقيقي للبشر لا ينفصل عن رفاه الطبيعة بأسرها” (Naess, 1989).
تتميّز هذه المدرسة برفض “المركزية البشرية” (Anthropocentrism)، والانتقال إلى ما يُسمى بـ “المركزية البيئية” (Ecocentrism)، حيث يُنظر إلى جميع الكائنات بوصفها شركاء متساوين في شبكة الحياة.
2. الحركات الخضراء: البعد السياسي والاجتماعي
أما الحركات الخضراء، التي ظهرت خصوصًا في أوروبا في سبعينيات القرن العشرين، فقد ركّزت على البعد السياسي والاجتماعي للأزمة البيئية. فهي تربط بين حماية البيئة ومفاهيم مثل العدالة الاجتماعية، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، ومقاومة الرأسمالية المفرطة. ومن أبرز شعاراتها:
“فكّر عالميًا، واعمَل محليًا” (Green Movement Manifesto, 1972).
هذه الحركات تحاول تغيير السياسات والأنظمة الاقتصادية عبر الضغط المدني والتشريعي، مركّزة على البعد العملي والمجتمعي أكثر من البعد الروحي.
3. اللاهوت الأرثوذكسي البيئي: الطبيعة كأيقونة وسرّ
في المقابل، يؤسّس اللاهوت الأرثوذكسي نظرته البيئية على مفهوم اللوغوس واللوغوي. فكل كائن خُلق في المسيح الكلمة (اللوغوس)، ويحمل داخله “لوغوسًا” خاصًا به، أي معنى وهدفًا إلهيًا يوجّهه نحو الله (مكسيموس المعترف، Ambigua 7). وبالتالي، الطبيعة ليست “مادة عمياء” ولا مجرد “مورد سياسي”، بل هي أيقونة إلهية وسرّ مقدّس.
يقول البطريرك برثلماوس:
“الاعتداء على الطبيعة هو خطيئة، لأنه انتهاك لسرّ الحياة الذي أودعه الله في الكون” (Bartholomew, 1997).
ويعلّق جون كريسافجيس موضحًا:
“الخليقة ليست ملكية نستهلكها، بل عطيّة نشاركها؛ وهي مكان لقاء بين الإنسان والله” (Chryssavgis, 2003).
4. نقاط الالتقاء
رغم الاختلاف، يمكن رصد نقاط التقاء بين هذه التيارات واللاهوت الأرثوذكسي:
• تشترك جميعها في رفض الاستغلال المفرط للطبيعة.
• تؤكد على الترابط العميق بين مصير الإنسان ومصير الخليقة.
• تدعو إلى تغيير جذري في نمط الحياة والاستهلاك.
5. نقاط التمايز
لكن الفوارق جوهرية:
• الإيكولوجيا العميقة ترى الطبيعة ذات قيمة مطلقة مستقلة عن الله، بينما الأرثوذكسية تراها ذات قيمة لأنها خُلقت في المسيح وتحيا به.
• الحركات الخضراء تركز على الإصلاح السياسي والاجتماعي، في حين أن الأرثوذكسية تضيف بعدًا روحيًا وليتورجيًا، معتبرة أن حماية البيئة هي أيضًا فعل عبادة وتوبة.
• اللاهوت الأرثوذكسي يدمج الخليقة والإنسان والليتورجيا في وحدة واحدة، بينما تميل التيارات الغربية إلى مقاربات جزئية (إما فلسفية أو سياسية).
إن الإيكولوجيا العميقة والحركات الخضراء تمثلان محاولات جادّة لإعادة الاعتبار للطبيعة في الفكر الغربي الحديث، لكنهما تفتقران إلى الأساس الروحي العميق الذي يقدّمه اللاهوت الأرثوذكسي. ففي حين ينطلق الغرب من قلق فلسفي وسياسي، ينطلق الأرثوذكس من سرّ التجسد واللوغوس، حيث تتجلّى الطبيعة كأيقونة مقدسة وفضاء لليتورجيا الكونية.
وكما يقول البطريرك برثلماوس:
“لا يمكننا أن نحمي البيئة حقًا إلا إذا أدركناها كجزء من سرّ الله، لأن العالم ليس فقط بيتنا، بل بيت الله أيضًا” (Bartholomew, 2009).
هل ترغب أن أتابع مباشرة بكتابة الفصل
◽️آراء لاهوتية عن البيئة من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية
أولًا: مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث والطبيعة – رؤية روحية ولاهوتية للخلق والبيئة
حين نتأمل فكر مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نجد أنفسنا أمام رؤية شاملة لا تختزل في حدود الوعظ أو المقالات الروحية القصيرة، بل تتجاوز ذلك لتصير منظومة لاهوتية متكاملة، تمتد من سرّ الله الخالق إلى سرّ الطبيعة والكون، ومن موقع الإنسان في الخليقة إلى مسؤوليته الأخلاقية والروحية تجاه البيئة والوجود. ورغم أنّ البابا شنودة لم يستخدم في تعاليمه مصطلحات حديثة مثل “التغير المناخي” أو “الاحتباس الحراري”، إلا أن كلماته تنطوي على لاهوت بيئي وروحي عميق، فيه يلتقي البُعد الكتابي بالبعد العقائدي، وتتشابك عناصر الجمال والأمانة والحدود، لتقدّم لنا فلسفة متكاملة عن الخليقة كعطية إلهية ومجال للعِشرة مع الله.
لقد شدّد البابا شنودة مرارًا على أنّ الخلق فعل فوق العقل، فعل يتجاوز مدارك الإنسان المحدودة، ولا يمكن النفاذ إليه إلا بالإيمان والوحي. يقول قداسته:
«ما أعجب عملية الخلق! إنها في مستوى فوق العقل. نقترب إليه عن طريق الإيمان والوحي. فالخالق غير الصانع. الصانع يصنع أشياء من مادة موجودة. أما الخالق فيخلق من العدم، ينشئ شيئًا من لا شيء!!» (شنودة الثالث، البابا. الله الخالق. مقالات متفرقة، جريدة أخبار اليوم، السبت 17 يونيو 2006. نُشر على موقع الأنبا تكلا هيمانوت: https://st-takla.org).
إن هذا التمييز بين “الخالق” و”الصانع” ليس مجرّد تفريق لغوي، بل هو جوهر الإيمان المسيحي: الله لا يحتاج إلى مادة سابقة، بل بكلمة قدرته يوجد الكائنات من العدم. ومن هنا يصبح الكون شهادة يومية على فعل المحبة الإلهية، فعل يظل لغزًا مدهشًا يتجاوز حدود المنطق العقلي.
وفي هذا السياق يوضح البابا أن الله لم يكن محتاجًا إلى الكون، بل إن الدافع وراء الخلق هو فيض محبته:
«إنه لم يكن محتاجًا إلى هذا الكون. بل الكون هو المحتاج إليه. كان الله مكتفيًا بذاته، تمجده صفاته، وتمجده طبيعته السامية التي لا تحد… أما سبب خلقه لكل الكائنات، فهو جوده وكرمه ومحبته» (المصدر نفسه: https://st-takla.org).
هذه الكلمات تكشف عن بُعد لاهوتي عميق: الله المحب هو الذي يفيض بالخليقة لا ليُكمل نقصًا فيه، بل ليشرك الكائنات في غنى وجوده. إنها محبة باذلة، مجانية، تفتح مجال الحياة أمام كل الكائنات. وبالتالي يصبح الكون كله “أيقونة للمحبة”، لا مجرد فضاء مادي.
ويتجلّى غنى الخلق في تنوع المخلوقات، وهو أمر توقّف عنده البابا شنودة بإعجاب شديد، إذ رأى فيه فنّ الله الإلهي:
«خلق الله كل مستويات الخليقة، حتى ما يبدو ضئيلًا منها… خلق العاقل وغير العاقل، خلق الحي والجماد. خلق الفيل الضخم، كما خلق النملة الضئيلة… خلق الأسد القوى الشجاع، كما خلق الأرنب الضعيف الخائف» (المصدر نفسه: https://st-takla.org).
التنوع هنا ليس عبثًا، بل هو شهادة على حكمة الخالق: لو كان الكون على نمط واحد، لكان فقيرًا في المعنى والجمال. لكن في التعدد نجد الكمال والانسجام، كما نجد تعليمًا للإنسان أن يقبل الآخر المختلف، إذ إن الخليقة كلها قائمة على تنوع متكامل.
ومن هذا التنوع نصل إلى النظام الكوني الذي وصفه البابا شنودة بعبارات فلسفية مهيبة، مشيرًا إلى صورة الله كمهندس عظيم:
«يكفى أن ننظر مثلًا إلى الفلك، والروابط التي تربط الأجرام السمائية بقوانين تحفظها قائمة في مكانها… يدل على أن الذي نظّم هذه القوانين الفلكية هو -كما يسميه الفلاسفة- مهندس عظيم God the Geometer» (المصدر نفسه: https://st-takla.org).
القوانين الطبيعية، من حركة الكواكب إلى توازن الأجواء، ليست مجرد معادلات فيزيائية، بل هي إعلان عن العقل الإلهي. والنظام الذي يحكم الكون يكشف أنّ وراءه مصممًا حكيمًا. بل إن الإنسان نفسه، في تكوينه الجسدي والروحي، يختصر هذا النظام، حتى سمّاه البابا “العالم الصغير” (Micro Kosmos).
ويتوقف البابا شنودة أيضًا أمام خصوصية الإنسان في الخلق، مشيرًا إلى بصماته التي تميّزه عن سائر الكائنات:
«بل إن عجب خلق الله يظهر عميقًا في بصمات أصابع الإنسان… أيّ مهندس أو رسام -مهما كانت براعته- يستطيع أن يرسم أشكالًا متنوعة من بصمات الأصابع مثلما صنع الله الخالق؟!» (المصدر نفسه: https://st-takla.org).
ثم يضيف عن بصمة الصوت وملامح الوجه، باعتبارها دلائل على تفرد الإنسان. فالإنسان ليس مجرد كائن بيولوجي، بل هو شخص فريد في هوية لا تتكرر. وهذا التفرد لا يقود إلى الكبرياء، بل إلى إدراك سرّ العطية الإلهية. فالله لم يترك الإنسان مجرد جسد، بل منحه روحًا خالدة، كما منح الملائكة:
«من محبته منح للإنسان روحًا خالدة، وكذلك الملائكة… وماذا نقول عن خلق الله للملائكة وقوتهم وإمكانياتهم العجيبة… بحيث يمكن أن ينزل الملاك من السماء إلى الأرض في لمح البصر» (المصدر نفسه: https://st-takla.org).
إن وجود الإنسان والملائكة يكشف عن بُعد آخر للخلق، حيث المادة والروح يلتقيان، في انسجام مقصود من الخالق. وهكذا يصبح الكون بأسره ساحة للقاء المادي بالروحي، الأرضي بالسمائي.
و هذه النظرة تكشف أن الخليقة كلها، من أعظم المجرات إلى أصغر الحشرات، تحمل توقيع الله. فالمؤمن مدعو إلى احترام كل الكائنات، وعدم ازدراء أي منها، إذ حتى أصغرها يعلن عن حكمة الخالق.
ولم يغفل البابا شنودة الجانب الروحي والنفسي للعلاقة مع الطبيعة. ففي مقاله «هدوء الطبيعة والمساكن» كتب:
«الناس كثيراً ما يلجأون إلى الطبيعة ليستمدّوا منها الهدوء، فيسعدون بالمناظر الجميلة التي تبهج النفس وتهدئ الأعصاب. ومن هنا كانت الحدائق والبساتين والحقول أماكن للراحة، يجد فيها الإنسان شيئًا من الطمأنينة والسلام الداخلي» (الأهرام، 3 يونيو 2007: https://st-takla.org).
إن الطبيعة هنا ليست مجرد مسرح خارجي، بل علاج للنفس البشرية. إنها دواء روحي يمنح السكينة، وحين يفسد الإنسان البيئة، فهو في الحقيقة يحرم نفسه من مصدر رئيسي للسلام الداخلي.
وفي هذا الإطار شدّد البابا على أن الخليقة عطية إلهية، وديعة مقدسة في يد الإنسان، والاعتداء عليها اعتداء على الله نفسه. إن رؤية البابا تتقاطع هنا مع لاهوت “الأمانة” (stewardship): الإنسان ليس سيدًا متسلطًا، بل وكيل مسؤول. من هنا فإن حماية البيئة ليست خيارًا ثانويًا، بل واجبًا دينيًا.
هذا الربط بين البُعد الروحي (القيامة) والبُعد الإنساني (مشاكل الشعوب والأرض) يكشف أن رؤية البابا شنودة لا تفصل الطبيعة عن المجتمع، بل ترى أن سلام الإنسان مرتبط بسلام الأرض.
وفي النهاية يمكن تلخيص لاهوت البابا شنودة في ثلاثة محاور مترابطة:
• الجمال: الطبيعة مصدر للسكينة والسلام.
• الأمانة: الخليقة عطية إلهية تستوجب الحفظ والرعاية.
• الحدود: الإنسان خليقة لا خالق، مدعو للتواضع أمام الله والكون.
إن هذه الرؤية لا تُقدَّم كأفكار مجردة، بل كسردية لاهوتية متكاملة: الله خلق الكون بمحبة، وضع فيه نظامًا مدهشًا وتنوعًا بديعًا، أعطى الإنسان مكانة فريدة لكنه ذكّره بحدوده، وجعل الطبيعة مجالاً للسلام الروحي ومسؤولية أخلاقية. في كل هذا يظل فكر البابا شنودة شهادة نبوية للإنسان المعاصر، الذي يواجه اليوم أزمات بيئية غير مسبوقة، لكنه مدعو أن يسمع من جديد صوت الكنيسة الذي يقول له: الخليقة عطية الله، فاحفظها بمحبة وأمانة.
ثانيًا: الكاثوليكوس آرام الأول والاحتباس الحراري – نحو لاهوت أخلاقي جديد
في بيان صدر عن قداسة الكاثوليكوس آرام الأول من أنطلياس، نجد محاولة جريئة لدمج اليقين العلمي بأزمة الاحتباس الحراري مع رؤية لاهوتية-أخلاقية تعيد صياغة موقع الإنسان في الخليقة. البيان يشكّل نموذجًا أرمنيًا أرثوذكسيًا معاصرًا لما يمكن تسميته “لاهوت بيئي عملي”.
1. الاعتراف بالعلم والانطلاق منه
يبدأ آرام الأول من اعتراف واضح بما جاء في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بأن الاحتباس الحراري حقيقة علمية وأن النشاط البشري هو السبب الرئيسي في تسريعها. لكن الاعتراف لا يقف عند العلم، بل يُوظّف كمنطلق لتأمل لاهوتي.
2. الأزمة قضية لاهوتية-أخلاقية
يقول آرام الأول إن الأزمة البيئية قضية لاهوتية-أخلاقية، وليست مجرد شأن سياسي أو اقتصادي. هذا التحويل يعني أن كل إصلاح تقني أو سياسي يبقى ناقصًا ما لم يُؤطر بروح التوبة والأمانة أمام الله والخليقة.
3. إعادة قراءة مفهومي “السيادة” و”الأمانة”
يرى آرام الأول أن الفهم الخاطئ لـ”سيادة الإنسان” على الأرض فتح باب الاستغلال غير المحدود. أما القراءة الكتابية الصحيحة فهي أن الإنسان وكيل مسؤول لا سيد متعجرف. يقول:
«من مركزية الإنسان إلى مركزية الله» – أي أن الله هو مركز الخليقة، والإنسان مدعو إلى العيش في خضوع لخطة الله، لا وفق نزعاته الأنانية (بيان آرام الأول).
4. التوبة وأخلاق المساءلة
يؤكد البيان أن المدخل الحقيقي هو التوبة: التوبة من ثقافة الاستهلاك، ومنطق المصلحة القصيرة الأمد. كما يربط بين التوبة وأخلاق المساءلة، حيث الإنسان مسؤول أمام الله، والأجيال القادمة، والفقراء المتأثرين بالتغير المناخي.
5. استحضار اللاهوت الآبائي
يرى آرام الأول أن للتراث الكتابي والآبائي نماذج راسخة للاهوت بيئي، إذ نظر الآباء إلى الطبيعة كأيقونة لله. لكنه يشدد على ضرورة تطوير هذا التراث ليواكب تحديات اليوم عبر مفاهيم مثل الكرامة الكونية والعدالة البيئية.
6. الكنيسة والمجتمعات الدينية
الكنيسة، بحسب آرام الأول، مدعوة لأن تكون مدرّب ضميرٍ عام، تنشر ثقافة بديلة للحياة البسيطة، وتشجع على الاقتصاد الدائري. كما يشدد على التعاون بين الأديان، إذ أن القيم المشتركة (الرحمة، العدالة، الأمانة) هي أرضية حقيقية لمواجهة التحديات البيئية عالميًا.
7. تطبيقات عملية
يقترح البيان مبادرات عملية منها:
إدماج البعد البيئي في التعليم الكنسي.
شبكات كنسية ومسيحية للعمل المناخي.
مبادئ أخلاقية واضحة في السياسات الاقتصادية.
مساءلة شفافة على المستويين الوطني والدولي.
8. خلاصة رؤية آرام الأول
يحوّل الكاثوليكوس آرام الأول الأزمة البيئية من نقاش علمي مجرد إلى دعوة روحية أخلاقية مسكونية، يرى فيها الاحتباس الحراري امتحانًا لإيماننا وأمانتنا كأبناء لله.
● صوتان من الشرق الأرثوذكسي
تكشف قراءة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث والكاثوليكوس آرام الأول أن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تقدّم لاهوتًا بيئيًا أصيلًا، ينطلق من الروحانية والكتاب والآباء:
عند البابا شنودة: الطبيعة مصدر هدوء وجمال، وديعة إلهية يجب أن تُحفظ.
عند آرام الأول: الأزمة البيئية تحدٍّ لاهوتي-أخلاقي عالمي يستلزم توبة ومساءلة وعدالة بين الأجيال.
إنهما صوتان متكاملان: الأول ينطلق من تجربة روحية شخصية ورعوية، والثاني من خطاب كنسي عالمي معاصر، وكلاهما يضعان أمامنا مسؤولية واضحة: الخليقة هبة الله، وحفظها فعل إيمان وعدالة.