من سمات النضوج والتقدّم في العمر قطعًا تراكم الخبرات وازدياد الحصيلة المعرفية للفرد، غير أننا في مسيرتنا الطبيعية هذه نفقد الكثير من البراءة التي تميّز النظرة النقدية التحليلية للأطفال.
هذا الافتراض يبدو غير منطقي للوهلة الأولى، لكن في حقيقة الأمر إنَّ الآباءَ والأمهاتِ يدركون جيدًا أن الطفل حين يبدأ وعيه في التشكّل وتنفتح عيناه على العالم من حوله ما يلبث أن يبدأ في التساؤل عن ماهية الأشياء وطبيعتها وأسبابها، وبخاصة الأشياء التي تبدو بديهية للبالغين، أو ربما هي بديهية لنا لأننا قبلناها كحقائق مُقرَّة دون تساؤل.
إحدى هذه الأفكار البديهية للإنسان المسيحي هي العبادة، وأسباب هذه البديهية تكمن في أن المجتمع المسيحي يصدر لنا دومًا فِكرَ العبادة على أنها شكلٌ معين، وخطواتٌ معينة داخل إطار الكنيسة، وظروف محددة ـ مكانيًّا وزمانيًّا – حين تلتقي جميعها يطلق على هذا الشكل العام اسم «عبادة».
وإن لم يملك الوالدان أو المرشدُ الروحيّ حسًّا أرثوذكسيًّا مرهفًا، يتعسّر عليهم نقل هذه المعرفة الوجدانية للطفل أو حتى للبالغين، خصوصًا مع الثقافة البروتستانتية السائدة التي تسلّلت إلى وجدان الكنيسة القبطية مع انتشار الترانيم البروتستانتية.(يمكنك مراجعة مقالنا المنشور على آليثيا بهذا الصدد.)
فالعبادة من منظور بروتستانتي هي تقديم بعض الترانيم كتسبيحٍ لله، وتقديم قراءةٍ وعظةٍ كتابية، مع الصلاة وإعلان الإيمان… إلى آخره.
والكلمة «عبادة» إنجليزية الأصل؛ تعود إلى الجذور الأنجلوسكسونية القديمة وتُشتقّ من الكلمة الإنجليزية “worschip” أو “worthship”، والتي تعني في الأصل «قيمة» أو «استحقاق». وترتبط الكلمة بجذر “worth” أي القيمة أو الجدارة، بينما تعني اللاحقة “-ship” حالةً أو صفةً، لذا فإن أصل الكلمة يشير إلى «صفة أن يكون مستحقًا للتقدير أو الاحترام». في السياق الديني تطوّرت الكلمة لتأخذ معنى الإكْرام أو التقديس أو التعبير عن التقدير المطلق لله، متجاوزة نطاق الاحترام البشري لتدلّ على التعظيم الأعلى للمعبود.
بينما أرثوذكسيًا، لا تُفهم العبادة كمجرّد فعلٍ طقسيّ أو انفعالٍ روحيّ، أو فقط كتقديم للإحترام اللائق لله، بل هي خبرةٍ كيانيةٍ مستيكية تُدخل الإنسان في سرّ الاتحاد بالمسيح وفي شركة الحياة الإلهية. ويتجلّى هذا البُعد بوضوح في مفهومي لاتريا (λατρεία) وليتورجيا (λειτουργία)، حيث تتداخل العبادة الفردية والجماعية، الروحية والجسدية، لتشكّل مسارًا تصاعديًّا نحو التألّه (θέωσις).
العبادة الأرثوذكسية هي خدمة الخلاص، وهي تفاعل ديناميكي حيّ .. فاعل .. حقيقي .. بين الإنسان وبين الثالوث؛ ينفتح فيه الإنسان على تدبير الخلاص وتُستعلن له هذه الحقيقة الخلاصية بقدر انفتاحه على هذا التفاعل. وفي واقع الأمر، إفخارستيًا، فإن المسيح هو الذي يقدم لنا ذاته في هذه الخدمة ويدعونا لنتقدّم نحن أيضًا فنقدّم ذواتنا كي نتحدّ به كيانيًّا.
العبادة الأرثوذكسية إذن لا تعاني من حالة الانفصال الكياني التي ضربت البروتستانتية، لأن حركة الإصلاح جردت العبادة من بعدها التجسدي المستيكي حين تمردت على الإفخارستيا.
العبادة البروتستانتية تقف عند حدّ التسبيح، وتقديم الأشواق العاطفية والنفسية، والتأمّل في النصوص الكتابية، وإعلان الإيمان؛ وهذا كله حسن، لكنه يبقى اختزالًا معيبًا بل ضربة قاسية لتدبير الخلاص، لأنه يقدم عبادة مسيحية الشكل دون الدخول في شركة الحياة الإلهية مع الثالوث. تلك الشركة التي الذي لا يمكن بلوغها دون الاتحاد بالمسيح، وهو البعد الغائب بروتستانتيا.
وهنا تتكشف لنا حقيقة الخواء البروتستانتي التي ربما اختبرها من ترك الأرثوذكسية وذهب يبحث عن الارتواء من آبار البروتستانتية فَاكتشف أنه يزداد عطشًا وأن الماء شديد الملوحة.. وأنه لا ارتواء!
وهنا أدعو القارئ العزيز أن يذوق معي هذا الماء العذب الصافي وأن ندخل سويًا إلى أعماق القدّاس الغريغوري…
نصلّي في صلاة الصلح مخاطبين الإبن:
«أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب، الذي من أجل الصلاح وحده ممّا لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم، وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة، وأردت أن تجدّده وترده إلى رتبته الأولى، لا ملاكٌ ولا رئيسُ ملائكةٍ ولا رئيسُ آباءٍ ولا نبيٌّ ائتمنته على خلاصنا…»
تأمّل معي ماذا فعل المسيح وكيف بادر ليقدّم لنا ذاته:
«بل أنت بغير استحالةٍ تجسَّدت وتأنَّست وشابهتنا في كلّ شيء ما خلا الخطية وحدها، وصِرت لنا وسيطًا لدى الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وأصلحت الأرضيين مع السماويين وجعلت الاثنين واحدًا، وأتممت التدبير بالجسد.»
فما هو ردّ فعلنا نحو هذا الحبّ الجارف وهذه المبادرة الإلهية المُحيية؟
نعلن:
«أيها الكائن السيد الرب، الإله الحق من الإله الحق، الذي أظهر لنا نور الآب، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقة، الذي أظهر لنا هذا السرّ العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم، اقبل منا نحن أيضًا أصواتنا مع غير المرئيين، أَحْسِبْنا مع القوات السماوية، ولنقل نحن أيضًا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كلّ أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصواتٍ لا تسكت وأفواهٍ لا تفتر ونبارك عظمتك.»
يا ربّ، ها نحن نأتي إليك بكليتنا؛ نتقدّم نحوك وقد غمرتنا لُجة الحبّ الإلهي، نسبّحك كالسيرافيم ولا نقوى سوى على الصراخ دون فتور من شدّة هذا الحب.
ثم نكمل وقد انفتحت أعيننا على سرّ المسيح وعلى تدبير الخلاص كلّه:
«قدّوس قدّوس قدّوس أنت أيها الرب وقدّوس في كلّ شيء، وبالأكثر مُختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك، وليس شيءٌ من النطق يستطيع أن يحدّ عمق محبتك للبشر. خلقتني إنسانًا كمحبّ للبشر، ولم تكن أنت محتاجًا إلى عبوديّتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفًا، وثبّدت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كلّ شيء تحت قدمي، لم تَدَعْني معوزًا شيئًا من أعمال كرامتك؛ أنت الذي جبلتني ووضعت يدك عليّ، ورسمت في صورة سلطانك، ووضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علمَ معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة، وعرفتني شوكة الموت.
غرسٌ واحدٌ نهيتني أن آكل منه؛ هذا الذي قلت لا تأكل منه وحده. فأكلتُ بإرادتي وتركتُ عني ناموسَك برأيي وتكاسلت عن وصاياك؛ أنا اختطفت لنفسي قضية الموت.»
وهنا يستعلن ما قدّمه لنا المسيح:
«أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصًا، كراعٍ صالحٍ سعيت في طلب الضال، كأبٍ حقيقيٍّ تعبت معي أنا الذي سقطت، ربَطتني بكلّ الأدوية المؤدية إلى الحياة. أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عونًا. أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك، كنورٍ حقيقيٍ أشرقت للضالين وغير العارفين.
أنت الكائن في كلّ زمان؛ أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوي إذ أنت الإله. لم تضمر اختطافًا أن تكون مساويًا لله، لكنك وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، وباركت طبيعتي فيك، وأتممت ناموسك عني، وأريتني القيام من سقطتي، أعطيت إطلاقًا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطيئة بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أخضعت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرَك للسياط وخدّيك أهملتهما للطم؛ لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب، أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت باكورتي إلى السماء، وأظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كلّ واحدٍ كأعماله.»
هنا تنفتح أعيننا على حقيقة الشركة في جسد المسيح:
«أقدم لك يا سيدي مشوراتِ حريتي، وأكتبُ أعمالي تبعًا لأقوالك. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرًا، أعطيتني الشركة في جسدك بخبزٍ وخمر.»
العبادة الأرثوذكسية في جوهرها هي خدمة الخلاص، وهي الاتحاد الكياني في المسيح وشركة طبيعتنا في الحياة الإلهية؛ وحين يعود الإنسان طفلاً في دهشته وسؤاله وقبوله للسر، يستعيد القدرة على الرؤية وتعود إليه البصيرة الروحية الثاقبة. والمسيح حاول أن يلفت انتباهنا نحو هذا الأمر حين قال: «لِمِثْلِ هَؤُلاَءِ مَلكوت السَّمَاوَاتِ»، داعيًا إيّانا أن نتغيّر فنكون مثلهم في صدق الإيمان وقوة البصيرة ورهافة الحس.


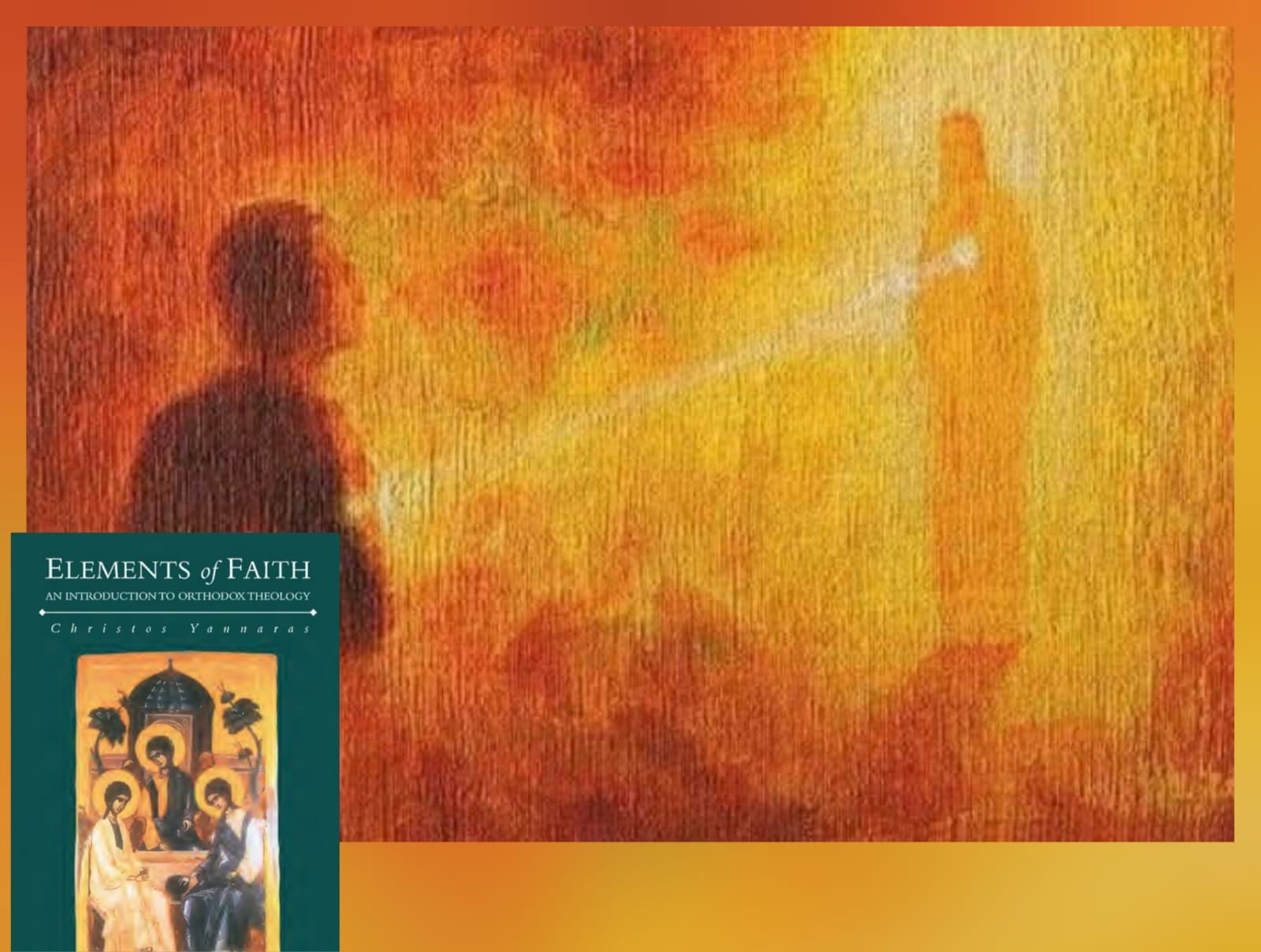

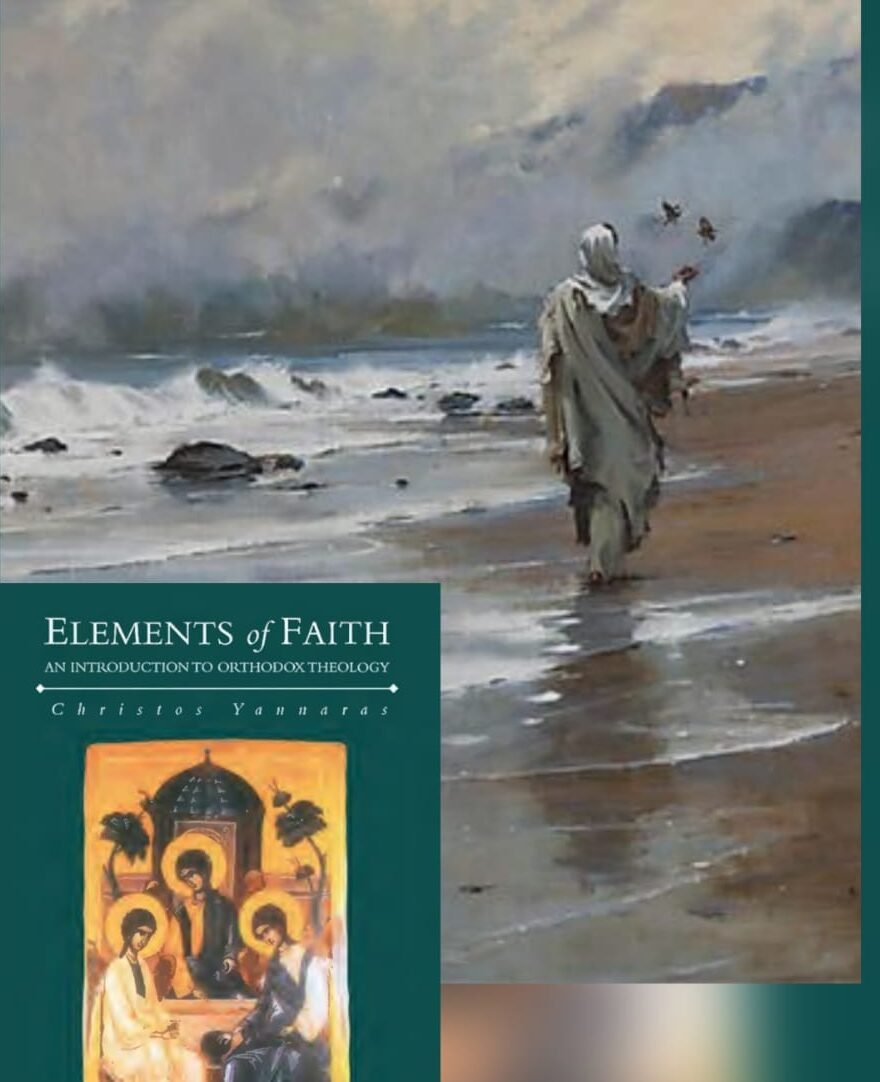

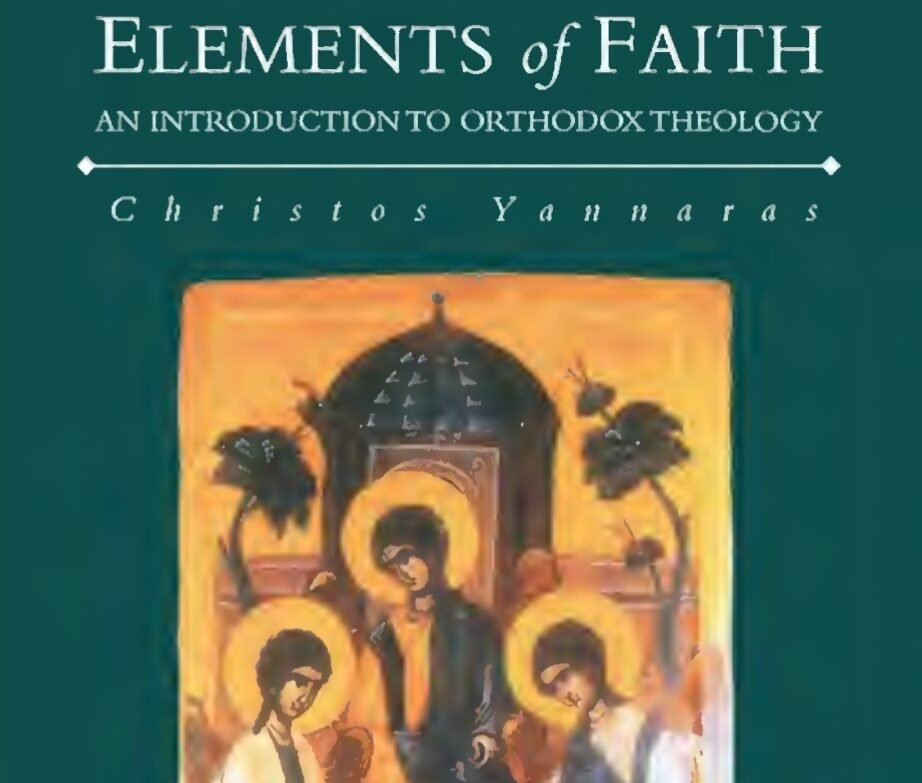

التعليقات
George
عمليا كيف نعود لحالة الطفولة فى بساطة الايمان و القدرة على الاندهاش؟
ماجد شوقي
أهلاً بيك يا چورچ،
العودة للحالة الطفولية دي ، هي في حقيقة الأمر دعوة إلى الكينوسيس أو إخلاء الذات ، ودي الحالة اللي الطفل بيكون عليها ، بلا إفتخار أو تعالي ، لكن بنقاء قلب وثقة مطلقة في أبويه.
الجانب الآخر إن الحالة الطفولية دي ممكن نعتبرها حالة آباثيا أو تحرر من الأهواء , الطفل بيكون بسيط ونقي القلب بلا مكر أو شر ولا يحمل في قلبه هموم العالم لكن واثق بشده في والديه.
المسيح هنا بيقدملنا الطفل كأيقونة للنفس النقية اللي عينيها على أبوها في ثقة تامة ، النفس البسيطة المتواضعة ، والمسيح بيدعونا فعلا إننا نرجع لحالة النقاوة دي.
ولو أمعننا في لوقا ١٨ هنلاقي الأصحاح سجل شهادة عن فكرة تقابل فكرة الطفولة وهي الغني المتكل على غناه ، وهي بالضبط الحالة اللي على النقيض تماما من الحالة الطفولية اللي المسيح بيدعونا إليها.
المفتاح لهذه الحالة في رأيي هو إننا ننفتح على الحب الإلهي ، الأطفال – كما دون لنا الإنجيل – راحوا بكل براءة وحب يستقبلوا الحب من المسيح ، والطفل في المراحل السنية المبكرة بيكون عالمه كله هو والديه ولا يشغله سوى استقبال الحب من والديه ، محتاجين نتعلم نستقبل الحب الإلهي ، نخلي ذواتنا من كل فخر، ونضع عن القلب أثقال الهموم وجراح العمر فننفتح قدر الإمكان على الحب الإلهي.