إهداء
إلى مَن خطا معي أولى خُطاي في درب المعرفة
إلى مَن أرشدني إلى منابع التعليم الأرثوذكسي
إلى رفيق الدرب، صديقي
مارك فيليبُس
M
لماذا تجسد الله؟
قد يبدو لك عزيزي القارئ أنَّ السؤال بسيطٌ وأنَّ إجابته معروفةٌ؛ فالله الابن قد تجسد كيما يفدي الإنسان مِن رباطات الخطيّةِ ويخلصه مِن الفساد الذي تسلل إلى طبيعته بعد السقوط.
نعم، تلك هي الإجابة الشائعة بين المؤمنين في كنائسنا، لكن ماذا لو لم يسقط الإنسان، أكان الله حينها سيتجسد؟ أو دعونا نصيغها بشكلٍ آخر: هل التجسد كان مشروطًا بالسقوط والفداء؟
هذا السؤال لم يشغل فِكْر آباء الكنيسة الأولين إلا أنه شغل فِكْر العديد مِن اللاهوتيين بدءً مِن مكسيموس المعترف مرورًا بدانس سكوت وصولاً بغريغوريوس بالاماس وغيرهم. كانت إجابة هؤلاء مُخالفة للفكرة الشائعة، فالتجسد بالنسبة لهم ليس مشروطًا لا بالسقوط ولا بالفداء، فحتى لو لم يسقط الإنسان لكان الله قد تجسد، لأن المعنى الحقيقي للخلاص هو اتحاد الإلهي بالإنساني، وغاية الخلق هو التألُّه، وما كان للإنسان أن يتألَّه إلا بتأنس الإله.
ملحوظة: كل ما وضعناه ما بين معكوفتين […] في الاقتباسات النصية هي اضافات مِنا للتوضيح وليست مِن متن النصوص المقتبسة. وقد اختصرنا لقب «القديس» إلى «ق.» فوجب التنويه.
- الصورة والمثال
ميز بعض أباء الكنيسة الأوائل بين الصورة[1] والمِثال، فالمِثال هو أن يصير الإنسان على مِثال الله بما يوافق طبيعته بينما الصورة هي الإمكانية لتحقيق المِثال وقد مُنحت له الصورة في خلقه. فالإنسان مدعو لتحقيق المِثال من خلال الشركة بين الروح القدس وحريته الإنسانية، فالصورة نعمة إلهية لكن المِثال جهاد إنساني.[2] فالإنسان مُتّجه أنطولوجيًا نحو الله، لأن بدايته كانت خلقه على صورة الله، وغايته أنْ يكون على مثاله.
ومِن ثمَّ فالإنسان حينما خُلق، لم يُخلق مُكتمَلاً، بل في صيرورة اكتمال على حد تعبير الأب فاضل سيداروس[3] أو أنه خُلق كاملاً لكن ليس في الواقع بل في الإمكانية على حد تعبير الأسقف تيموثي وير[4]. لذلك فإنَّ الإنسان قد مُنحت له «الصورة»، ودُعي لاكتساب «المثال» عن طريق جهده الخاص، وبالطبع تؤازره في ذلك نعمة الله. لذلك نجد ق. إيرينيئوس يقول: ”كان [آدم] كالطفل الذي لم يكتمل إدراكه بعد. وكان مِن الضروري له أن ينمو ويصبح كاملاً“. (في الكرازة الرسولية، 12) هذه اللوحة التي يرسمها ق. إيرينيئوس عن آدم قبل السقوط تختلف عن تلك التي رسمها ق. أغسطين والتي تقبّلها الغرب عمومًا منذ عهده. يرى ق. أغسطين أنَّ الإنسان كان في الفردوس منذ اللحظة الأولى بكل ما أعطي له مِن حكمة ومعرفة: فلم يكن كماله قط بـ «الإمكانية»، بل كان كمالاً «ناجزاً». إن المفهوم الديناميّ لدى ق. إيرينيئوس أقرب إلى النظريات العصرية حول التطور مِن المفهوم الجامد لأغسطين. ولكن بما أن كلا الاثنين يتحدثان كرجلي لاهوت وليس كعالِمين، فليس بوسع الفرضيات العلمية أنْ تدعم آراءهما أو تدحضها.[5]
تلك الرؤية التي نجدها عند بعض الآباء أنَّ الإنسان لم يُخلق كاملاً بل في صيرورة اكتمال، توافق تلك الرؤية المعاصرة التي نجدها في الفلسفة الوجودية. فالوجود والعدم في الفلسفة الوجودية هو علاقة جدليّة (ديناميّة) وليست علاقة ساكنة (ستاتيّة) حدثت لحظة الخلق. فالإنسان لا زال في طور الانبثاق emerging. فالفعل يوجد ex-ist مشتق مِن الفعل اللاتيني ex-sistere ويعني يبرز stand out أو ينبثق. أن يوجد الإنسان هو أن «ينبثق» مِن العدم، فـ «الوجودية» في عموميتها تعني بذاتي في كفاحي لكي أكون أنا ذاتي وسط العالَم والأشياء والآخرين. فالإنسان يتحرك باستمرار للخروج مِن العدم نحو الوجود الحقيقي بواسطة إدراك ذاته.
لذلك فإنَّ الشكل الإنسانيّ النهائي والأخير لم يظهر بعد إلى حيز الوجود – طبقًا للفلسفة الوجودية – وهو أمرٌ أيدته الدراسات البيولوجية الحديثة لا سيما نظرية التطور. هذا المنظور اللاَّ إكتمالي للوجود؛ أنَّ الإنسان هو كائن لا يزال في طريقه نحو الظهور، صار هو المنظور السائد بدلاً مِن ذلك المنظور أنَّ الإنسانَ مُنتجٌ نهائيٌّ. فالإنسان موجود ex-sistent، أي أنَّه الكائن الذي لم يمتلك بعد الماهية الكاملة بل يتحرك باستمرار للخروج مِن العدم نحو الوجود الحقيقي بواسطة إدراك ذاته.[6]
إلا أنَّ رؤيتنا اللاهوتية تتبنى أنَّ الشكل النهائي، الأخير، والكامل للإنسانية قد ظهر بالفعل في الوجود في المسيح. إنه هو الغاية التي تصبو إليها البشرية، وهو ما نجد ما يقابله عند ق. إيرينيئوس في كتابه «ضد الهرطقات»، فعنده أنَّ المسيح التاريخيّ الذي عاش على الأرض في زمنٍ معين، هو النموذج الأصلي pattern/archetype الذي كان في عقل الله حينما خلق الإنسان الأول، آدم. فقد خَلَقَ اللهُ الإنسانَ على صورة الله، أي على صورة الابن؛ فالابن هو صورة الله[7]، ومِن ثمَّ فالإنسان قد خُلق على صورة الصورة، وكان مُقدرًا له أنْ يرتقي إلى المثال، إلا أنَّ السقوط قد أفسد هذا الارتقاء، فأتى التجسد الإلهيّ لتحقيق هذه الغاية الأولى، ولذلك فالمسيح هو homo futurus وهو نفس التعبير الذي استعمله العلامة ترتليان.[8]
نعود مرةً أخرى لحديثنا عن الصورة والمثال. لأنَّ الصورة أصلها إلهيّ، وقد صارت جزءًا مِن الطبيعة الإنسانية، فإنَّها لا يمكن أنْ تتلاشى أو تُمحى تمامًا، لكن يمكن أنْ تتشوه بفعل الخطيئة. أمَّا المِثال فإنه يقع على عاتق الإنسان، لذلك ربما استراح الله في اليوم السابع – الذي لا زال حتى الآن – لا لأنَّه تعب بل ليترك الحرية لخليقته لتعمل لتحقق المِثال، أو كما قال الشاعر الألماني هردرلن: ”الله يصنع الإنسان كما يصنع البحر القارات: بالانسحاب“. لكن خليقة الله لا تعمل بعيدة عن الله، بل تشترك في عمل الله اشتراكًا وجوديًا، وربما هذه هي المفارقة التي نعجز عن فهمهما حضور الله واحتجابه في آنٍ.
وقد شرح العلامة أوريجانوس ذلك في هذا النص المُطول: ”يكمن الخير الأسمى في أن يصبح المرء، على قدر طاقته، شبيهًا بالله. ولكنّ هذا لا أحسب أنهم عثروا عليه من تلقاء ذواتهم، وإنما اقتبسوه عن الأسفار الإلهية. فإن موسى يشير، قبل أيّ سواه، إلى ذلك حينما يروي خلق الإنسان الأول: وَقَالَ اللهُ: لنصنعنّ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا ومثالنا. ويُردف مِن ثمَّ: وخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ، عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْا، وباركهما. إنه يقول إذًا: عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ، ولا ينبس بكلمة حول المثال. إن هذا يدل على أن الإنسان نال منزلة الصورة لدى خلقه الأول، ولكن كمال المثال محفوظ له عند الانقضاء. وهذا يعني أنه ينبغي عليه أن يحصل عليه بنفسه، عبر جهده الخاص، وهو يقتدي بالله. فإن إمكانية هذا الكمال، التي أُسديت له منذ الابتداء عبر منزلة الصورة، كان يجب عليه تحقيقها في آخر المطاف من خلال قيامه بأفعال، يتماثل بها تماثلاً تامًا.“[9] ويسير ق. غريغوريوس النيصي على ذات الدرب حيث يقول: ”لنصنع الإنسان على صورتنا كمِثالنا، إننا نمتلك الواحدة بالخلقة، بينما الأخرى نحصل عليها بإرادتنا الحرة.“[10]
إن ق. غريغوريوس النيصيّ يلخص ذلك في «تَمَطيّ»[11] الإنسان أي اتجاهه نحو الله. وذلك بأنَّ الإنسان النهائيّ هو في حركة ومسيرة مُستديم نحو الله اللانِهائيّ، وتَقدُّم متواصل نحو الغاية، ورغبة غير مُشبَعة في الله، ونزوع لامُتناه إليه.[12] ويتسم خطاب ق. غريغوريوس النيصيّ بصفتين: إنه كريستولوجيّ وديناميّ. كريستولوجيَ إذ أنه كُلّما نظر الإنسان إلى شخص المسيح، يكتشف أنه لم يعد بعد على صورته، بل عليه أن يصير صورة المسيح هذه، أن يصير مسيحًا، وذاك يتحقق بالروح القدس وحرية الإنسان الذي يتجاوب ودعوة الله هذه إلى الاشتراك في حياته الإلهية، أي إلى التألُّه[13]. والسمة الثانية فهي دينامية حركة التوجُّه، حيث أنه يعتمد على الإرادة أكثر مِن العقل، وكذلك نحو العمل أكثر مِنه نحو التأمل المجرَّد والميتافيزيقيّ. ولذا، فإن زمن الإنسان عند غريغوريوس ليس بالزمن اليونانيّ الدائريّ الذي يتكرر ويعود إلى نفسه، بل هو زمن مُتجه نحو الأمام، في حركة ديناميّة حيث ذِكر الماضي، والجديد غير المتوقع في الحاضر، وبلوغ الغاية في المستقبل، أو بقصير العبارة حيث التاريخ.[14]
وقصة الخلق في سفر التكوين لا تُعلن لنا فقط أنَّ الإنسان في حالة صيرورة اكتمال، بل تُعلن حقيقة الإنسانية، التي لا تُدرك إلا في الوحدة/التمايز. فالإنسان خُلق على صورة الله الأحد الثالوث، فالصورة الإلهية لا تتجلى في آدم، كما أنها لا تتجلى في حواء، بل تتجلى فيهما معًا، فالله حُب، والحب حركة نحو آخر، ولقد خَلَقَ الله الانسان على صورته، صورة الحب، لذلك لم يكن مِنْ الحسن أن يكن آدم لوحده، لأنَّ الصورة الإلهية لم تتحقق، بل بحواء تحققت، بالآخر. وكما قال الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار[15]: ”في البدء كانت العلاقة“، فالوجودية المسيحية تنظر إلى العلاقات الإنسانية نظرةً مخالفة لنظرة سارتر الذي يرى أن الجحيم هو الآخرون.
إذن كاتب سفر التكوين يُعلن حقيقة الإنسانية، أنّ الإنسان ليس فقط مخُلوق على صورة الله بل ومدعو أنْ يصير على مثاله. وهنا تتجلى محبة الله الثالوثية، فالله لا يريد إنسانًا متفوقًا على سائر الخلائق الأخرى ببعض المواهب وحسب، بل يريد إنسانًا يشاركه تلك المحبة الثالوثية، وهو ما عَبَّرت عنه الكنيسة الأولى بلغة التألُّه.
- التألُّه، غاية الخلق
- 1. مفهوم التألُّه
بالطبع لا نقصد بالتألُّه أنْ نصير آلهةً بالطبيعة، ورغم أنَّ الآباء الأولين تحدثوا بلغة التألُّه إلا أنهم لم يقدموا تعريفًا لها، وأول تعريف لذلك المصطلح التقني نجده في كتابات ديونسيوس الأريوباغي (المنحول) في القرن السادس الميلادي، حيث عَرَّف «التألُّه θέωσις» على أنَّه ”السعي للحصول على شبه الله والإتحاد به لأبعد حد ممكن“[16]. فالتألُّه هو أنْ نصير مثل الله بما يوافق طبيعتنا، أن نتحد به دون أن نتماهى معه أي دون أن نصير مثله بالحقيقة. وخلاصة القول فإنَّ التألُّه هو اتحاد الإنسان بالله ένωση του ανθρώπου µε το Θεό.
هناك العديد مِن الدراسات التي ناقشت مفهوم التألُّه عند الآباء، إلا أنّ كتاب نورمان راسل الذي نشرته له جامعة أكسفورد بعنوان: «عقيدة التألُّه في التقليد الآبائي اليوناني»[17] يأتي على رأس تلك القائمة.
في هذا الكتاب يرسم لنا راسل تاريخ لغة التألُّه في كتابات الآباء في القرون الخمس الأولى، منذ بداية استخدامها بطريقة مجازية إلى نضوجها كعقيدة كنسية، موضحًا أن الآباء استخدموا لغة التألُّه على مناحي: الاسمي، التناظري، والمجازي. فالاسمي Nominal يَعتبر وصف الكتاب للبشر بأنهم آلهة ما هو إلا من قبيل التكريم والتشريف، أما التناظري Analogical فهو يعقد مقارنة بين اثنين مثلما كان يبدو موسى كإله بالنسبة لفرعون أو كما يبدو الحكيم إلهًا بالنسبة للأحمق، أي أنَّ البشر صاروا آلهةً وأبناءً بالنعمة تناظريًّا مع المسيح الذي هو إله وابن بالطبيعة. أما المجازي فأخذ بعدين؛ بعدٌ أخلاقي وأخر واقعي، فالمنحى الأخلاقي يرى أنَّ الإنسان يستطيع أنْ يشبه الله عن طريق الممارسة النسكية والفلسفية التي تجعله يمتلك بعض الخصائص الإلهية، وقد قدم القديس اثناسيوس لنا حياة القديس أنطونيوس كمثال لهذا المنحى الأخلاقي مِن حيث التطبيق العملي للفكرة[18]. أما المنحى الواقعي فافترض أن البشر سيتحولون فعلاً بصورة ما عن طريق التألُّه.[19]
- 2. اتحاد الإنسانيّ بالإلهيّ
كما بيّنا آنفًا أنَّ غاية الخلق هو التألُّه، وأنَّ التألُّه هو اتحاد الإنسانيّ بالإلهيّ لكن دون أن يتماهى معه، حيث يبقى الإنسان دائماً هو هو، أي إنه كائن مخلوق. لكنه في الإله المتأنس، ينعم بمشاركة فعلية في ما هو إلهيّ، أي في الحياة الأبدية غير الفاسدة. لكن يُطرح السؤال: على أي مستوى يتحد الإنسان بالألوهة؟
بالتأكيد لن يتحد الإنساني بالإلهي على مستوى الجوهر، فلو قُدِّر للإنسان أن يتحد بجوهر الله نفسه، لصار حينها إلهًا بالطبيعة، ولا يكون الله عندئذٍ ثالوثًا بل إلهًا ذا آلاف الأقانيم بقدر كثرة الأشخاص المتحدين بجوهره.
وعلى الرغم مِن اشتراكنا في الطبيعة الإنسانية التي أتخذها أقنوم الابن الإلهيّ بتأنسه، إلا أننا لم نتحد بذلك بأقانيم الثالوث، فهذا أمرٌ خاص بأقنوم الابن وحده، ذاك الاتحاد الأقنوميّ بين الطبيعتين الإنسانية والإلهية.
إن لم يكن اتحادنا بالله على مستوى الجوهر ولا على مستوى الأقنوم، فكيف يكون إذن اتحادنا بالله؟
إنَّ اتحادنا بالله يكون مِن خلال القوى أو الطاقات الإلهية (الإنرجيا ἐνέργεια). فنحن لا نستطيع أن ندرك الله أو حتى ندنو مِنه مِن حيث جوهره، إلا أننا نستطيع أن نعرفه بل ونتحد به مِن خلال طاقاته.
- 3. النعمة غير المخلوقة
- 3. 1. خلفية تاريخية
أنوميوس في القرن الرابع الميلادي -وقد كان أريوسيًا- نادى بأن الإنسان يستطيع أن يدرك الله حتى دون مساعدة النعمة الإلهية. وهنا تبارى آباء الكنيسة للرد عليه بأن الله في جوهره لا يمكن إدراكه مطلقًا، إلا أن بعضهم قد تطرف للقول بأنه لا يمكن حتى إدراك الله بالنعمة الإلهية[20]. لكن ألا يُعتبر الموقف هذا مناقضًا لقول السيد المسيح: ﴿طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ.﴾ (متى 8:5) فكيف يمكننا أن نعاين الله إن لم نكن نستطيع أن ندنو مِنه ؟ نحن هنا أمام مفارقة، فالله المتعالي (الترنسندنتالي) لا يمكن أن نبلغه أو نحيطه علمًا، بينما في ذات الوقت هو يتواصل معنا، ويُعلن ذاته لنا، بل ونتحد به، ونصير ﴿شُرَكَاءَ الطَّبِيعَةِ الإِلهِيَّةِ﴾ (2بط 4:1) فكيف يمكننا أن نوفق بين العبارتين؟
هنا ظهر اللاهوتي البيزنطي غريغوريوس بالاماس لينادي بتصور مستيكي (صوفي) أن القديسين يستطيعوا أن يدركوا الله مِن خلال نعمته غير المخلوقة، مِن خلال اتحادهم به. يشرح الأب جورج فلورفسكي مفهوم «التألُّه» عند بالاماس فيقول: ”الإنسان يبقى دائماً هو هو، أي إنه كائن مخلوق. لكنه في يسوع المسيح، الكلمة المتأنس، وعده الله وأعطاه المشاركة الفعلية في ما هو إلهي، أي في الحياة الأبدية غير الفاسدة. إن الميزة الرئيسية للتألُّه، عند آباء الكنيسة، هي الخلود واللافساد، إذ لله ”وحده الخلود“ (1تيمو6: 16). لكن الإنسان يُقبل الآن في ”اتحادٍ“ صميم بالله بواسطة المسيح وبقوة الروح القدس. وهذا الاتحاد هو أكثر بكثير من اتحاد ”خلقي“ ومن كمال بشري.“[21]
ثم يتساءل الأب جورج فلورفسكي: ”إذا كان الإنسان لا يقدر أن يدنو مِن الله في جوهره، وإذا كان اتحاده بجوهره مستحيلاً فكيف يكون «التألُّه» ممكنًا؟“[22]
يجيب فلورفسكي بقوله: ”القديس أثناسيوس ميّز بين جوهر الله وقواه فقال: ”هو موجود بصلاحه في كل الأشياء، لكنه يبقى خارجها بطبيعته الخاصة“ (في مقررات مجمع نيقية 2). هذا المفهوم وسّعه بدقة الكبادوكيون. فقال القديس باسيليوس إن الإنسان لا يقدر أن يدنو من ”جوهر الله“ (ضد أفنوميوس 1: 14). إننا نعرف الله في قواه فقط ومن خلالها: ”نحن نقول إننا نعرف إلهنا من قواه وأفعاله لكننا لا نعطي وعداً بأننا ندنو من جوهره، لأن قواه تنحدر إلينا، أمّا جوهره فيبقى بعيدًا“ (الرسالة 234 ضد أمفيلوخيوس). لكنّ هذه المعرفة لا تكون حدسًا أو استدلالاً، إذ إن قواه تنحدر إلينا. وفي تعبير القديس يوحنا الدمشقي، هذه القوى إعلان عن الله نفسه: ”الإشراق الإلهي والقوة“ (العرض الدقيق للإيمان الأرثوذكسي 1: 14). فحضوره حقيقي ولا يكون فقط مثل ”حضور الممثِّل فيما يفعله“. ورغم التعالي المطلق في الجوهر الإلهي تعلو هذه الطريقة السرية للحضور الإلهي على كل فهم، لكنّ هذا التعالي لا يجعلها غير أكيدة بالنسبة للعقل.“[23]
ثم يوضح فلورفسكي الأساس اللاهوتي الذي بنى عليه بالاماس مذهبه اللاهوتي فيقول: ”بدأ القديس غريغوريوس التمييز بين «النعمة» و «الجوهر» فيقول : ”لا تكون الإنارة الإلهية المؤلِّهة جوهر الله، بل قوته“ (الفصول الفلسفية واللاهوتية 68- 69).“[24] ”بما أن الجوهر الإلهي لا يُدانى فمصدر التألُّه الإنساني وقوته لا يعودان إلى الجوهر الإلهي، بل إلى «نعمة الله»، لأن ”القوة الإلهية المؤلِّهة التي يتألَّه بها المشاركون فيها هي نعمة إلهية لا جوهر إلهي“ (المصدر نفسه 92-93). فما النعمة (Kharis) جوهراً (Ousia)، بل هي ”النعمة الإلهية غير المخلوقة والقوة غير المخلوقة“ (المصدر نفسه 69). لكنَّ هذا التمييز لا يحمل انقسامًا أو انفصالاً (المصدر نفسه 127). إن القوى تصدر عن الله وتظهر كيانه ووجوده ولفظة «تصدر» (proiene, προιεναι) تشير إلى التمييز لا إلى الانفصال. ”وإن اختلفت نعمة الروح عن طبيعته، لكنها لا تنفصل عنها“ (ثيوفانيس ص. 940).“[25]
في الجهة المقابلة نجد برلعام يتهم غريغوريوس بالاماس بأنه قسم الله بتعليمه إلى طبيعة إلهية لا تُدرك وإلى طاقات إلهية يُمكن إدراكها.[26]
- 3. 2. بين الكبادوكيين وأنوميوس المهرطق
كان آباء الكنيسة الأولون يعبرون عن أقنوم الابن بـ «قوة δύναμις» الله أو «فعل/طاقة ἐνέργεια» الله، مؤمنين أن قوة الله أو فعله غير مخلوق، وذلك بناءً على آية (رومية 1: 19-20) ﴿إِذْ مَعْرِفَةُ اللهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لأَنَّ اللهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ، لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις وَلاَهُوتَهُ θειότης﴾ ومِن ثمَّ فإن قوة الله أو طاقته إلهية، أزلية، غير مخلوقة طبقًا للنص البولسيّ.
كانت حجة أنوميوس بسيطة؛ أن الابن لا يمكن أن يكون الله، لأن الله لا يلد ingenerate ولا يولد unbegotten، وهذا ليس مجرد صفة في الله بل هو طبيعة الله (أي عدم الولادة)، ومِن ثمَّ فإن الجوهر الإلهي لا يمكن أن يتشارك مع أحد بالولادة. وبالتالي فإن الابن المولود مِن الله الآب ليس واحدًا معه في الجوهر.[27] فما الابن سوى طاقة الله غير الأزلية، المخلوقة والخالقة في آنٍ.
إن حجة أنوميوس قد تأسست على فصله الطاقة عن الجوهر. وأن جوهر الله أزليّ بينما الطاقة الإلهية زمنية، ومِن ثمَّ فهيّ مخلوقة.
هنا انبرى ق. باسيليوس للرد على أنوميوس، فنجده يكتب:[28]
”هل تعبد ما تعرف أم تعبد ما لا تعرف؟ إذا أجبت: أنا أعبد ما أعرف. سيجيبون على الفور: ما هو جوهر الذي تعبده؟ عند ذلك، إذا اعترفت إنني أجهل الجوهر. سينقلبون عليَّ بقولهم: إذن أنت تعبد ما لا تعرف. وأنا أجيب بأن كلمة «تعرف» لها عدة معاني، فنحن نقول: نحن نعرف عظمة الله، قوته، حكمته، صلاحه، عنايته بنا، وعدل أحكامه، لكن ليس جوهره. ومِن ثمَّ فإن السؤال قد وُضع فقط لأجل الجدل. لأن الذي ينكر معرفة جوهر الله لا يعترف أنه جاهل بالله، لأن فكرتنا عن الله تتجمع مِن كل تلك الصفات التي ذكرتها. لكن الله كما يقول هو [أنوميوس] بسيط، وأن أية صفة تحسبها معروفة هي لجوهره. لكن السخافات في تلك السفسطة لا تعد. هل كل تلك الصفات التي نعددها هي جميعها أسماء للجوهر الواحد؟ فمحبة الله، عدالته، قدرته الخلاقة، عنايته الإلهية، معرفته السابقة، عطاءه بالثواب والعقاب، عظمته. فهل نعلن جوهر الله بذكر أي مِن تلك الصفات؟ إن كان جوابهم بنعم، لا تدعهم يسألون إن كنا نعرف جوهر الله، بل دعهم يسألون ما إذا كنا نعرف الله العادل والرحيم. فإننا سنعترف حينها أننا نعرف. لو قالوا أن جوهرَ الله مميزٌ distinct فلا تدعهم يتهمونا بالخطأ فيما يخص بساطة الله، لأنهم أنفسهم صاروا يعترفون بالتمييز بين الجوهر والصفات الإلهية المتعددة. فالأعمال [الطاقات] متنوعة لكن الجوهر بسيط. لكننا نقول ذلك: أننا نعرف الله مِن خلال أعماله [طاقاته] لكننا لا ندنو مِن جوهره. إن أعماله [طاقاته] تنزل إلينا مِن فوق أما جوهره فيظل بعيدًا عن منالنا.“
وقد سار ق. غريغوريوس النيصي على نهج أخيه الأكبر، فقد ميز بين الجوهر والطاقة لكنه رأى أن الطاقة هي ما يفعله الله وما يكونه[29]. فالله في طاقاته كما في طبيعته[30]، فهناك تمييز لا فصل بين الجوهر والطاقة. يقول ق. غريغوريوس النيصي: ”لقد قيل عن الابن أنه صورة وختم طاقة الله … فما المقصود بختم الطاقة ”the seal of the energy“؟ إن كل طاقة تُفهم على أنها التأثير أو الجهد exertion في الطرف الذي يظهرها، وتُفهم مِن خلال اكتمالها، فليس لها وجود مستقل [عن صاحبها]. ومِن ثمَّ، وعلى سبيل المثال، فإن طاقة مَن يجري هي حركة قدميه، وعندما تتوقف الحركة لم يعد أي طاقة هناك. وعلي نفس النهج يمكن أن يُقال أن جهد/تأثير مَن ينشغل بأي شئ يتوقف، حينما تتوقف الطاقة أيضًا، فليس للطاقة وجود منفصل، سواء كان الشخص مشارك نشط في هذا الجهد الذي يبذله أو عندما يتوقف عنه.“[31]
- 3. 3. الليتورجيا القبطية
دومًا ما نقول أنَّ العقيدة هي عبارة عن علاقة بين الله والإنسان، وما الهرطقة سوى كسر لتلك العلاقة[32]، وتلك العلاقة تُمارس وتُعبّر في الصلوات، أو كما قال ق. إيريناؤس: ”إن عقيدتنا تتفق مع الافخارستيا، والافخارستيا بدورها تؤسس عقيدتنا.“[33] أو حسب المبدأ اللاتيني الأبائي الذي صاغه ق. بروسبير الأكويتاني تلميذ ق. أغسطينوس Lex orandi, lex credendi والتي تعني: قانون الصلاة هو قانون الإيمان، فالليتورجيا هي لغة اللاهوت، فنحن نصلي ما نؤمن به، وما نؤمن به هو ما نصليه. فماذا تعلّمنا الليتورجيا فيما يخص نعمة الله: أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟
في صلاة سيامة القس يقول الكاهن:
- 2. التجسد سبيل التألُّه
”لقد تأنّس ابنُ الله لكي نتألَّه نحن، واستُعلن في جسد إنسان منظور لكي نتقبّل نحن صورة الآب غير المنظور، واحتمل ظلم ووقاحة الإنسان لكي نحتمل نحن ميراث الخلود“
البابا أثناسيوس الرسوليّ[34]
”وإن كان الله قد أرسل ابنه مولودًا مِن امرأة، فإن هذا الأمر لا يسبب لنا عارًا بل على العكس مجدًا ونعمة عظمى. لأنه قد صار إنسانًا لكى يؤلهنا في ذاته. وقد صار (جسدًا) مِن امرأة ووُلد مِن عذراء كي ينقل إلى نفسه جنسنا (نحن البشر) الذين ضُلِّلنا، ولكى نصبح بذلك جنسًا مقدسًا، ونصير شركاء الطبيعة الإلهية (2بط4:1) كما كتب بطرس المُطوب.“
البابا أثناسيوس الرسوليّ[35]
إنَّ كريستولوجية ق. اثناسيوس الرسوليّ قد بُنيت على التألُّه، فلو كان الابن مشابهًا للآب όμoioύσioς كما ينادي أريوس وليس مِن جوهر الآب ὁμοούσιος، لما استطاع الابن بتجسده أنْ يؤلِّهنا، وأنْ يوحدنا بالألوهةِ. يقول ق. أثناسيوس الرسوليّ: ”لذلك، فهو [المسيح] لم يكن إنسانًا ثم صار فيما بعد إلهًا، بل كان إلهًا وفيما بعد صار إنسانًا بالأحرى كي يؤلِّهنا.“[36] … ”لأن مِن غير المستطاع أن يحدث التبني بغير الابن الحقيقي، وهو نفسه القائل: ﴿لَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحَدٌ يَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ.﴾ (متى 27:11). وكيف يحدث التأليه بدون اللوغوس، وقبله؟“[37]
لقد شَكَّلَ التجسد محور الدفاع ضد الأريوسية والنسطورية على حدٍ سواء، فعند البابا اثناسيوس إنْ لم يكن الابن هو إلهًا بالحقيقة، واحدًا مع الآب في الجوهر، ما كان للإنسان أنْ ينال التبني وأنْ يدعو الله الآب بـ «أبانا»، وما كان له أنْ يتألَّه. وعند البابا كيرلس إنْ لم يتحد الإلهيّ بالإنسانيّ اتحادًا حقيقيًا في المسيح الذي ﴿هُوَ بِكْرٌ بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ﴾ (رومية 29:8)، فكيف له أن يتحد بالقديسين؟ وكيف له أن يسكن فيهم؟
يقول ق. كيرلس السكندريّ في نصٍ هام: ”لاحظوا، أرجوكم، كيف أنَّ الإنجيلي [يوحنا] اللاهوتيّ يتوِّج بحكمة كل طبيعة البشر بقوله أنَّ الكلمة ﴿حَلَّ فِينا﴾. فهو يقصد بذلك – على ما يبدو لي – أنْ يقول أنَّ تجسد الكلمة لم يحدث لأية غاية أخرى إلاَّ لكي نغتني نحن أيضًا بشركة اللوغوس بواسطة الروح القدس فنستمد مِنه غِنى التبني.“[38] في ذاك المقبوس يخبرنا ق. كيرلس السكندريّ أنَّ غاية التجسد هو اتحاد الإلهيّ بالإنسانيّ، وأنْ ينال الإنسان نعمة التبني. وبالطبع هناك فرقًا شاسعًا بين حلول الكلمة في جسده الخاص وبين حلوله النسبي فينا بواسطة النعمة.
يقول ق. كيرلس السكندريّ: ”نحن نقبل داخلنا اللوغوس الذي مِن الله الآب، الذي صار إنسانًا مِن أجلنا وهو اللوغوس الحي والمُحيي. ولنبحث الآن كيفية هذا السر … لقد صار اللوغوس جسدًا … ووُلد بحسب الجسد مِن امرأة آخذًا مِنها جسده لكي يتحد بنا اتحادًا لا يقبل الإنفصال …!“[39]
لاحظ عزيزي القارئ أنَّ البابا كيرلس السكندريّ يربط بين الإتحاد الأقنومي الذي تم في المسيح وبين حلول اللوغوس فينا، أي بين شطري الآية ﴿والكلمة صار جسدًا﴾ و ﴿حَلَّ فِينا﴾. فالشطر الأول هو أساس أو وسيلة تحقيق الشطر الثاني، والثاني هو غاية الأول.
إنَّ الإشكال الحقيقيّ في كلا الهرطقتين الأريوسية والنسطورية أنها جعلت كلام السيد المسيح عن الوحدة خاويًا مِن كل معنى، وجردت عمودي الكنيسة: المعمودية والافخارستيا مِن كل فاعلية.
- استقلال التجسد عن الفداء
- 1. مدخل تاريخيّ
لماذا صار الله إنسانًا؟ أو Cur Deus homo باللاتينية كما صاغها أنسلم أسقف كانتربري في القرن الحادي عشر الميلادي. إجابة أنسلم كانت أنَّ الله قد تجسد كيما يفدي الإنسان مِن الخطيّة، مؤسسًا بإجابته تلك ما سيُعرف لاحقًا بالنظرية القضائية للترضية juridical theory of satisfaction.
إلا أنَّ بعد قرنين مِن الزمان، وتحديدًا في القرن الثالث عشر الميلاديّ، خرج دانس سكوت ليتحدى إجابة أنسلم معلنًا أنّ التجسد الإلهيّ مُستقل independent عن السقوط الإنسانيّ. فبالنسبة لسكوت فإن تجسد الله هو غاية الخليقة كلها، يقول سكوت: ”مرة أخرى، لو كان السقوط هو سبب تدبير predestination المسيح، فإن أعظم أعمال الله ستكون عرضية occasional، ومجد الجميع لن يكون عظيمًا كمجد المسيح. ويبدو أنه مِن غير المعقول أن نعتقد بأن الله كان سيتخلى عن هذا العمل [العظيم] لو أنّ آدم تصرف حسنًا ولم يُخطئ.“[40]
فالتجسد بالنسبة لسكوت هو الألفا والأوميجا للخطة الإلهية للخلق؛ فالمسيح، الكلمة المتأنس، هو ﴿بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ … فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ … الْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ … فِيهِ يَقُومُ الْكُلُّ﴾ (كو 1: 15-17)، فالخليقة كلها مركزها المسيح Christocentric cosmology[41]، فالصانع المُطلق للتاريخ هو المسيح، الكلمة المتأنس، وفيه وحده تُصبح البشرية هي أيضًا صانعة للتاريخ. وعند دراستنا للاهوت التاريخ الإنساني تنفتح أعيننا أمام ذلك السر العظيم، سر التدبير الإلهيّ، قصد الله الأزلي المُتجسد في التاريخ الإنسانيّ، أن يصنع الإنسان تاريخه مع الله وله، ليصبح التاريخ الإنسانيّ إلهيًا، فمصدر التاريخ وغايته ونهايته هو الله[42].
وهناك فقرة هامة للاهوتي البيزنطي مكسيموس المعترف[43]، نستشف فيها نفس الرؤية اللاهوتية التي تنادي باستقلال التجسد عن السقوط، يقول مكسيموس المعترف: ”إنها النهاية المنشودة التي لأجلها كل شيء قد خُلق، إنها الغاية الإلهية التي كانت في فكر [الله] قبل بدء الخليقة، والتي ندعوها بالغاية المنشودة intended fulfillment [التي هي الإتحاد الأقنومي بين الإلهيّ والإنسانيّ في المسيح]. كل الخليقة وُجدت لأجل هذه الغاية لكن تلك الغاية نفسها لم تُوجد لأجل شيء مخلوق. ولأن هذه الغاية كانت في فكر الله [منذ الأزل]؛ هو أنتجَ طبيعة الأشياء [في الزمن]. إنها حقًا تحقيق العناية والتدبير. التي مِن خلالها تجمّعت recapitulation كل الخليقة إلى الله. إنها السر الذي حدد كل الأزمنة، خطة الله المُدهشة، الموجودة قبل كل زمان. الرسول الذي هو نفسه في الجوهر كلمة الله، صار إنسانًا لتحقيق هذه الغاية.“[44]
في المقبوس السابق يؤكد مكسيموس المعترف على أنَّ غاية الخلق هي اتحاد الإنساني بالإلهيّ، وما كان لهذا أنْ يتحقق دون التجسد. لذلك فإنَّ مكسيموس المعترف يعتبر التجسد هو الغاية الأولى والمُطلقة لفعل الخلق الإلهيّ.
في القرن الثامن عشر قام الأب نيقوديموس الأثوسي بمعالجة تلك القضية اللاهوتية مِن خلال تحليل التعاليم الآبائية[45]، وقد توصل لذات النتيجة التي توصل لها كلٌ مِن دانس سكوت ومكسيموس المعترف بأنَّ تجسد الابن لم يكن نتيجة سقوط الإنسان بل كان الغاية الأصلية من فعل الخلق، لأنه بهذه الطريقة – أي التجسد – يستطيع الإنسان أن ينال التألُّه.
يطوّر الأب نيقوديموس الأثوسي هذه الرؤية اللاهوتية في مقاله المعنون بـ «دفاع عن شروحي الخاصة بسيدتنا، والدة الإله، في كتاب الحرب اللامنظورة» والذي دفعه لكتابة دفاعه هذا هو تلك العبارة العابرة التي كتبها في كتابه المومأ إليه حيث كتب: ”إنَّ كل العالم العقلي والحسي خُلق لأجل هذه الغاية، لأجل سيدتنا والدة الإله. وسيدتنا والدة الإله خُلقت بدورها لأجل ربنا يسوع المسيح.“
أثارت هذه العبارة حفيظة بعض لاهوتيي عصره، ولهذا كتب الأب نيقوديموس دفاعه. بنى الأب نيقوديموس رؤيته اللاهوتية بشكل أساسي على ثلاث نصوص كتابية هي: ﴿اَلرَّبُّ قَنَانِي أَوَّلَ طَرِيقِهِ، مِنْ قَبْلِ أَعْمَالِهِ، مُنْذُ الْقِدَمِ.﴾ (أمثال 22:8)، ﴿الَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ.﴾ (كولوسي 15:1)، ﴿لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ، لِيَكُونَ هُوَ بِكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ.﴾ (رومية 29:8)
في تفسيره لهذه النصوص على أساس تعليم الآباء القديسين، يقول أنها لا تشير إلى الألوهة، لأنَّ الكلمة لم يُخلَق من الله ولا هو أول المخلوقات كما فهم أريوس، لكن هذه المقاطع تشير إلى إنسانية المسيح. فناسوت المسيح مخلوق، وهو بذلك أول الخلائق المُتألّه، ويكون بذلك المسيح هو بكرٌ بين إخوة كثيرين.
يقول الأب نيقوديموس الأثوسي: ”هل فهمت أنَّ الله قد خلقَ الإنسان على صورته لأجل هذه الغاية، لأنه بذلك قد يكون الإنسان قادرًا، مِن خلال التجسد، على احتواء النموذج الأصلي؟ ولهذا خلقَ اللهُ الإنسانَ كصلة بين العالمين العقلي والحسي، كصورة مُصغرة جامعة لكل المخلوقات، حتى باتحاده معه يتحد بكل الخليقة التي في السماء [العالم العقلي] والتي على الأرض [العالم الحسي]، كما يقول القديس بولس، وبالتالي فإنَّ الخالق والخليقة يصبحان واحدًا أقنوميًا [في المسيح] بحسب مكسيموس المتشّح بالإله.“
يختتم الأرشمندريت إيروثيوس فلاخوس دراسته بقوله: ”يظهر مِن كل ما رأيناه، أنَّ كلمة الله قد تجسد لا لكي يسترضي العدالة الإلهية كما يقول اللاهوتيون الغربيون، بل ليؤلّه الطبيعة الإنسانية وذلك مِن فيض حبه وإحسانه للبشرية. إنَّ استرضاء العدالة الإلهية يُعطي بُعدًا قانونيًا للحياة الروحية لأنه يُظهر كل نسكنا وكأنه ممارسة تهدف استرضاء الله. ومن ناحية أخرى، فإنَّ الله ليس هو مَن يحتاج إلى المداواة بل نحن. لذلك فإنَّ تجسد المسيح كان إرادة الله الُمسبقة، والهدف المُطلَق لخلق الإنسان. لم يكن للإنسان أن يبلغ الشركة مع الله لو لم يكن هناك وحدة أقنومية بين طبيعتي المسيح الإلهية والإنسانية، لأنَّ هناك فارق عظيم بين المخلوق وغير المخلوق. لم يكن للمخلوق أن يتحد بغير المخلوق لو لم تكن هذه الوحدة بين الإثنين في شخص المسيح. ما أُضيف بسقوط الإنسان هو آلام المسيح وصليبه وموته. وهذه الأمور يُمكن أن تُفسر بالطبع مِن خلال حقيقة أنَّ المسيح بتجسده اتّخذ طبيعة إنسانية فائقة النقاوة لكنها قابلة للموت وللهوى.“
- 2. تأسيس كتابيّ
نحن أمام محورين لفهم التجسد: 1) السقوط-الفداء Fall-Redemption. 2) الخلق-التألُّه Creation-Deifcation. إذا تبنى خِطابنا اللاهوتيّ المحور الأول كمنطلق له، سيكون حينها فهمنا للتجسد مشروطًا بالسقوط. أمّا إذا تبنى خِطابنا اللاهوتيّ المحور الثاني كمنطلق له، سيكون حينها فهمنا للتجسد مستقلاً عن السقوط. والجدير بالذكر أنَّ كثيرًا مِن الآباء واللاهوتيين دمجوا بين المحورين في خِطابهم اللاهوتي.
رفعَ السيد المسيح في صلاته نحو الآب طلبته: ﴿لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا.﴾ (يوحنا 21:17) فالغاية النهائية مِن سر التدبير الإلهيّ أن تتحد الخليقة بخالقها في المسيح الذي يحقق في نفسه ملء الوجود الكلي للخالق والمخلوق معًا. ويشرح لنا هذا ق. بولس الرسول بقوله: ﴿لِتَدْبِيرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى الأَرْضِ ، فِي ذَاكَ الَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا، مُعَيَّنِينَ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ الَّذِي يَعْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْيِ مَشِيئَتِهِ﴾ (أفسس 1: 10-11)
وعلى النص البولسيّ أسس ق. إيريناؤس لاهوته القائم على ما يُعرف بـ «الانجماع الكلي في المسيح ἀνακεφαλαίωσις، recapitulation». حيث يقول: ”في ملء الزمان، ولأجل أن يكمل ويجمع كل الأشياء، صار [الكلمة] إنسانًا بين الناس، منظورًا وملموسًا، لكي يبيد الموت، ويظهر الحياة، ويحقق الوحدة بين الله والإنسان.“[46]
فالمسيح جَمَعَ في ذاته الإنسانية كُلها، يقول ق. إيريناؤس: ”عندما تجسد [الكلمة]، وصارَ إنسانًا، جمع في نفسه تاريخ الإنسان الطويل، وقدّم لنا بطريقة موجزة وشاملة – مع الخلاص – ما فقدناه في آدم، أي صورة وشبه الله، وهذا ما استعدناه في يسوع المسيح.“[47]
فما نالته الطبيعة الإنسانية التي أتخذها أقنوم الكلمة بتأنسه، قد مُنح للإنسانية جمعاء، نقول في القطعة الثالثة مِن ثيؤطوكية الجمعة:
| هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحداً معه مِن قبل صلاحه. | `N;of af[i `ntencarx@ af] nan `mPef`Pneuma =e=;=u@ afaiten `nouai nemaf@ hiten tefmet`aga;oc. |
| هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوًا. | N;of af[i `nny`ete noun@ af] nan `nny`ete nouf@ tehwc `erof ten]`wou naf@ ten`erhou`o [ici `mmof. |
يقول ق. باسيليوس الكبير: ”ولكنه اقتنى البشرية مغروسة فيه ومتحدة به. فقد جمع في نفسه البشرية كلها بواسطة جسده.“ (Homily on Christmas)[48] ونفس الأمر يؤكده ق. كيرلس الكبير بقوله: ”فإن كل ما في المسيح قد صار لنا. فإنه لم يقبل هذا التقديس لأجله – إذ أنه هو صانع التقديس – بل قبله لكي يوصله لطبيعتنا بواسطة نفسه. وهكذا قد صار طريقًا وبدايةً للخيرات الحاصلة لنا، وبهذا المعنى قال ﴿أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ﴾ (يوحنا 6:14)، أي الذي مِن خلاله تنحدر نحونا النعمة الإلهية، لكي تُرفع وتُقدس وتُمجد وتُؤله طبيعتنا أولاً في المسيح!“ (Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate, 20)[49]
ونختتم حديثنا في هذه النقطة بقول ق. اثناسيوس الرسوليّ: ”إنَّ كل ما كُتب فيما يختص بناسوت مخلصنا ينبغي أنْ يُعتبر لكل جنس البشرية.“ (الدفاع عن هروبه، 13)[50]
الخاتمة
منحَ اللهُ الإنسانَ نعمةَ الصورة الإلهية في الخلقة الأولى ودعاه أنْ يصير مثله، فكيف كان ممكنًا للإنسان أنْ يُلبي الدعوة ويحقق هذا دون أنْ يتحد أولاً بالله؟ يخبرنا بولس الرسول أنه ﴿لِتَدْبِيرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ، لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ﴾، فكيف يمكن أن ينجمع كل شيء في المسيح، لو لم يتأنس الكلمة أولاً، ويوحد طبيعتنا الإنسانية بطبيعته الإلهية في أقنومه؟
هذه التساؤلات اللاهوتية هي التي دفعت العديدَ مِن اللاهوتيين للقول: أنه حتى لو لم يسقط آدم لكان الله قد تجسد.
بالطبع قد يتبادر لذهنك عزيزي القارئ ذلك السؤال المنطقي: وما هي أهمية تلك الدراسة؟ فما كان قد كان، فما الذي يُعنينا إنْ كان التجسد مستقلاً عن السقوط أم لا؟
إنَّ أهمية تلك الدراسة تكمن في أنها مجرد محاولة لبناء نظام لاهوتيّ غير قائم على قصة السقوط الواردة في سفر التكوين. فهؤلاء الذين يعتقدون بصحة نظرية التطور وبأسطورية قصة الخلق التكوينية لا يكفوا عن طرح السؤال اللاهوتيّ: لماذا الله قد تجسد إنْ لم يكن هناك آدم وحواء مِن الأساس فما بالك بالسقوط؟!
إنني كما ناديت في كتابي «العلم اللاَّ معقول: إشكالية العلاقة بين الدين والعلم» بضرورة التمييز لا الفصل بين الخطابين العلميّ واللاهوتيّ، فالخطاب العلميّ ينصب اهتمامه على إجابة سؤال «كيف؟» بينما الخطاب اللاهوتيّ ينصب اهتمامه على إجابة سؤال «لماذا؟»، وكلا السؤالان يشغلان فكر الإنسانية.
فعلى مدار صفحات هذه الدراسة رأينا أنَّ المسيح، الكلمة المتأنس، هو أصل الخليقة وغايتها، هو السرُ في عمليّة التطور، هو المرآة الحقيقية لاكتمال الإنسانية، لذلك فإن الإنسانية تتّجه نحوه، تتطّور نحوه وترتقي.
إنَّ التعبير الأنسب مِن السقوط الإنسانيّ هو السَّقطُ الإنسانيّ[51]، أيّ أنَّ الإنسان قد خُلق جنينًا غير مكتمل النمو لكنه يجنح لتحقيق الكمال. فالسقوط الإنساني الذي صوره كاتب سفر التكوين بصورةٍ رمزية في شخصيتي آدم وحواء لم يكن حدثًا تاريخيًا بل واقعًا تعيشه الإنسانية جمعاء عبر تاريخها، فسقوطها هو فشلها لتحقيق الكمال وبلوغ الأبدية بعيدًا عن الله. فقصة السقوط التكوينية ليست قصةً عن ماضي الإنسانية بل عن حاضرها الذي ما كان له أن يتغير دون تجسد الألوهةِ. فسعي الإنسانية نحو الكمال والأبدية ما له أن يتحقق دون شركة الله. فالتجسد؛ اتحاد المخلوق بغير المخلوق، هو مفتاح فِهمنا لفعل الخلق الإلهيّ.
وبهذا نكون قد فهمنا التجسد بمعزل عن السقوط، لكن يَبَقى السؤال: لماذا يموت المسيح إنْ لم يكن آدم قد سقط؟
يمكننا القول بخصوص قضية موت المسيح، أنَّ الله بتأنسه قد عبر هذه الهوة الأنطولوجية بين الخالق والمخلوق، لكن نتاج هذه الهوة (الموت) لم يكن قد عبره بعد بالتجسد، لكن بموته عبر الموت، وانتصر عليه بقيامته. عليّنا أنْ نضع دائمًا صوب أعيننا ذلك المبدأ الآبائي: ما لا يُؤخذ لا يخلص. وهو المبدأ الذي تُرجم ليتورجيًا في ثيؤطوكية الجمعة: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فلو لم يعبر الابن الموت لما أخذنا نحن الحياة.
[1] الصورة تقوم على الاتصال بالأصل لذلك فالصورة الإلهية تعني أولاً أن يكن للإنسان صلة وجودية مع الله مِن صميم كيانه؛ لأن غاية الخلق هي الشركة في الحياة الإلهية، فكلما يتعمق الإنسان في معرفة الإلهيات كلما تجلت الإلهيات فيه، فالعلاقة بين الإنسان والله هي علاقة ديناميّة حية، فالصورة الإلهية في الإنسان متعددة لا يمكن حصرها فى صفات محددة وكما يقول القديس غريغوريوس النيصي أن الإنسان يعكس صورة الله غير المدرك، لكن يمكننا القول أن «الصورة» تتضمن جوانب أنثروبولوجية وجودية، مِنها على سبيل المِثال: الحب، العقل والإدراك، الحرية والإرادة، الخلود والحياة الأبدية، أو قُل أن الصورة تمثل الشخصية.
[2] وهذا التمييز يشابه تمييز هيجل بين الوجود في ذاته Being in itself والوجود لذاته Being for itself، فالوجود في ذاته هو الإمكانية التي ليست متحققة بعد، وهو أيضاً الإمكانية غير الواعية بذاتها، وغير الواعية بما فيها مِن إمكانية مثل البذرة وجود في ذاته بمعنى أنها شجرة بالقوة. أما الوجود لذاته فهو الوجود الواعي لذاته والمحقق لإمكاناته، مثل الوجود الإنساني.
[3] فاضل سيداروس، الأنثروبولوجيا المسيحية: (1) الإنسان على صورة الله كمثاله (بيروت: دار المشرق، 2013م)، ص 188
[4] تيموثي وير، الكنيسة الأرثوذكسية: إيمان وعقيدة (بيت لحم: منشورات النور، 1985م)، ص 39
[5] تيموثي وير، الكنيسة الأرثوذكسية: إيمان وعقيدة، ص ص 39-40
[6] أنصح بالرجوع لدراسة: مارك فيليبُس، ”خريستولوجيا الوجود: مبادئ أولى في المسيحانية المعاصرة“، في: دورية المبادئ، السنة الأولى، العدد الثاني، ص ص 72-91 وكذلك كتاب: صموئيل طلعت أيوب، العلم اللاَّ معقول: إشكالية العلاقة بين الدين والعلم (الأسكندرية: كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسبورتنج، 2015م)، ص ص 52-71
[7] ﴿الَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ εἰκὼν τοῦ θεοῦ غَيْرِ الْمَنْظُورِ﴾ (كولوسي 1: 15-20) ﴿الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ μορφῇ θεοῦ﴾ (فيلبي 2: 6-11).
[8] Gustaf Wingren, Man and the Incarnation: A Study in the Biblical Theology of Irenaeus (trans. Ross Mackenzie; Eugene: Wipf and Stock, 2004), 18
[9] أوريجانوس، في المبادئ، ترجمة: الأب جورج خوام البولسي (جونيه: منشورات المكتبة البولسية، 2003م)، ص ص 353-354 (3، 6، 1)
[10] نقلاً عن: الراهب سارافيم البرموسي، الأيقونة فلسفة الروح (برية شيهيت: دير السيدة العذراء برموس، 2011م)، ص 36
[11] التَمَطيّ هو لفظ تصوفي مُستوحى مِنْ قول ق. بولس: ﴿أَنْسى ما ورائي وأتَمطَّى إلى الأمام﴾ (فيلبي 13:3، الترجمة اليسوعية) والكلمة مُشتقة مِنْ الكلمة اليونانية ἐπέκτᾰσις والتي تعني الامتداد، لذلك نجد آية (فيلبي 13:3) في ترجمة سميث-فاندايك هكذا: ﴿أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَأَمْتَدُّ إِلَى مَا هُوَ قُدَّامُ﴾. فالقديس غريغوريوس يتحدث عن تَمَطيّ الإنسان أي امتداده نحو الله.
[12] فاضل سيداروس، الأنثروبولوجيا المسيحية؟، ص ص 40-41
[13] غاية الخلق هو التألُّه ليس بمعنى أنْ تتغير طبيعتنا إلى طبيعة الله، بل بمعنى أنه يحلّ هو فينا بحسب قوله: ﴿أَنْتُمْ فِيَّ، وَأَنَا فِيكُمْ.﴾ (يو 20:14) أنْ نتحد به، فيهبنا شركة في صفاته الخاصة، وسيأتي شرح التألُّه تفصيلاً لاحقًا.
[14] راجع: فاضل سيداروس، الأنثروبولوجيا المسيحية، ص ص 183-184
[15] غاستون باشلار Gaston Bachelard (1884-1962م): فيلسوف فرنسيّ، له العديد مِن الإسهامات في الشعر وفلسفة العلوم. والجدير بالذكر أن باشلار في كتابه “الفكر العلمي الجديد” تحدث أن العلم الحديث استبدل أنطولوجيا الجوهر بأنطولوجيا العلاقات.
[16] Ecclesiastical Hierarchy 1. 3, Patrologia Graeca 3. 376a
[17] Norman Russell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition (New York: Oxford University Press; 2004).
وقد تمت ترجمة هذا العمل الماتع إلى اللغة العربية: نورمان راسل، عقيدة التأله في التقليد الآبائي، ترجمة: مجموعة من المترجمين (القاهرة: مركز إبيفانيا للنشر والتوزيع، 2019م).
[18] كان محور الخلاص عند أثناسيوس هو أن البشرية بحالتها تلك غير متوافقة مع طبيعة الله ومِن ثمَّ يجب أن تمر بعملية انعاشية متصاعدة لتنال نوعًا ما شبه لله تستطيع من خلاله أن تتحد بالله بقدر الإمكان، وبرغم مِن الطبيعة الآخروية لفكرة التألُّه فهذا لا يعني أن العملية غير ممكنة في الحياة الأرضية، ولهذا يقدم لنا ق. اثناسيوس في كتابه «حياة أنطونيوس» صورة للإنسان الذي يستطيع أنْ يبدأ رحلة التألُّه مِن خلال النظام النسكي وإتباع حياة الكمال بحسب الإنجيل، فالقديس أنطونيوس قال ”أن اللوجوس قد أخذ جسد بشري واشترك في الطبيعة البشرية لكي يمّكن البشر مِن المشاركة في الطبيعة الإلهية والروحية“. (Vita Antony 74). مفهوم التألُّه الذي قدمه اثناسيوس في «حياة أنطونيوس» يعتمد على المجاز الأخلاقي، فهو يشدد على قصص الكمال الأخلاقي عند أنطونيوس على مدار السرد، فمثلاً نجد التحكم بالنفس المبهر الذي قدمه أنطونيوس في مواجهة حروب الشيطان عن طريق حالة فريدة مِن قمع الجسد. (Vita Antony 7).
Cf. Barnes TD. “Angel of Light or Mystic Initiate? The Problem of the Life of Antony”, JTS, 1986; 37: 353–68.
[19] Norman Russell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, 1-3
ولقراءة معالجة تفصيلية عن «التألُّه» انصح بالرجوع لدراسة: كيرلس سمعان شهدي، ”التألُّه: سعي البشرية نحو الله“، في: دورية المبادئ للدراسات المسيحية، السنة الثانية، العدد الأول، ص ص 120-142
[20] B. Forshaw, “Heaven (Theology of)”, in: Thomas Carson and Joann Cerrito eds., The New Catholic Encyclopedia, 2nd ed. (Detroit: Thomson Gale,2003), 6: 687
[21] جورج فلورفسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، ترجمة: الأب ميشال نجم (بيروت: منشورات النور، 1984م)، ص 153
[22] جورج فلورفسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، ص 154
[23] جورج فلورفسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، ص ص 154-155
[24] جورج فلورفسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، ص 155
[25] جورج فلورفسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، ص ص 155-156
[26] H. D. Hunter, “Barlaam of Calabria”, in: The New Catholic Encyclopedia, 2: 99
[27] David Bradshaw, “The Concept of the Divine Energies”, in: Philosophy and Theology, 2006; 18 (1): 106
[28] [Do you worship what you know or what you do not know? If I answer, I worship what I know, they immediately reply, What is the essence of the object of worship? Then, if I confess that I am ignorant of the essence, they turn on me again and say, So you worship you know not what. I answer that the word to know has many meanings. We say that we know the greatness of God, His power, His wisdom, His goodness, His providence over us, and the justness of His judgment; but not His very essence. The question is, therefore, only put for the sake of dispute. For he who denies that he knows the essence does not confess himself to be ignorant of God, because our idea of God is gathered from all the attributes which I have enumerated. But God, he says, is simple, and whatever attribute of Him you have reckoned as knowable is of His essence. But the absurdities involved in this sophism are innumerable. When all these high attributes have been enumerated, are they all names of one essence? And is there the same mutual force in His awfulness and His loving-kindness, His justice and His creative power, His providence and His foreknowledge, and His bestowal of rewards and punishments, His majesty and His providence? In mentioning any one of these do we declare His essence? If they say, yes, let them not ask if we know the essence of God, but let them enquire of us whether we know God to be awful, or just, or merciful. These we confess that we know. If they say that essence is something distinct, let them not put us in the wrong on the score of simplicity. For they confess themselves that there is a distinction between the essence and each one of the attributes enumerated. The operations are various, and the essence simple, but we say that we know our God from His operations, but do not undertake to approach near to His essence. His operations come down to us, but His essence remains beyond our reach.] Basil of Caesarea, “Letter CCXXXIV”, in: The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. VIII (trans. Blomfield Jackson; Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 274.
[29] [energeia always indicated the energy which God both is and does.] David Bradshaw, “The Concept of the Divine Energies”, 108
[30] وهذا ما نستشفه مما كتبه ق. غريغوريوس في رده على أنوميوس، راجع الكتاب الأول، الفصل السابع عشر.
Gregory of Nyssa, “Against Eunomius”, in: The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series, Vol. V (trans. William Moore et al.; Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 54.
[31] Gregory of Nyssa, Against Eunomius 2: 12, trans. William Moore et al., in: the Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. V (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 124.
[32] راجع: صموئيل طلعت، ”لاهوت الشياطين“، في: دورية المبادئ للدراسات المسيحية، السنة الأولى، العدد الأول، 2013م، ص ص 3 – 5
[33] Irenaeus of Lyons, Against Heresies 4: 18. 5, in: The Ante-Nicene Fathers, Vol.I (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 486.
[34] تجسد الكلمة:54
[35] مِن رسالة القديس أثناسيوس إلى أدلفيوس المعترف أسقف أونوفيس، عام 370م. (PG 26.1077.10-15) ترجمه عن اليونانية الدكتور جورج فرج.
[Καὶ εἰ ὁ Θεὸς δὲ ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ γεννώμενον ἐκ γυναικὸς, οὐκ αἰσχύνην ἡμῖν ἐπάγει τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐδοξίαν καὶ μεγάλην χάριν. Γέγονε γὰρ ἄνθρωπος, ἵν’ ἡμᾶς ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃ· καὶ γέγονεν ἐκ γυναικὸς, καὶ γεγέννηται ἐκ Παρθένου, ἵνα τὴν ἡμῶν πλανηθεῖσαν γέννησιν εἰς ἑαυτὸν μετενέγκῃ, καὶ γενώμεθα λοιπὸν γένος ἅγιον, καὶ κοινωνοὶ θείας φύσεως, ὡς ἔγραψεν ὁ μακάριος Πέτρος·]
[36] القديس أثناسيوس الرسوليّ، المقالة الأولى ضد الأريوسيين (القاهرة: المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، ط3)، ص 103
[37] القديس أثناسيوس الرسوليّ، المقالة الأولى ضد الأريوسيين، ص 104
[38] تعاليم في تجسد الابن (PG 75, 1400). نقلاًعن: الأب متى المسكين، التجسد الإلهيّ في تعليم القديس كيرلس الكبير (وادي النطرون: دير القديس أنبا مقار، ط3، 2007م)، ص 31
[39] تفسير لوقا 19:22 (PG 72, 908-909). نقلاًعن: الأب متى المسكين، التجسد الإلهيّ في تعليم القديس كيرلس الكبير، ص 32
[40] Georges Florovsky, “Cur Deus Homo? The Motive of the Incarnation” in Εὐχαριστήριον: ῾Αμίλκας ᾿Αλιβιζᾶτος (᾿Αθῆναι, 1957), 70-79. English translation from: Georges Florovsky, the Collected Works of Georges Florovsky, Vol. III: Creation and Redemption (Belmont, Massachusetts: Nordland Publishing Company, 1976), 165.
[41] Christocentric cosmology: هو مصطلح تم صكه لأول مرة لوصف تلك الرؤية الكونية لمكسيموس المعترف. فالبنسبة له فإنَّ الابن اللوغوس هو مركز كل الخليقة، فبتأنسه قد تأسست شركة بين المخلوق وغير المخلوق، وتحققت للخليقة وجودها الحقيقيّ. وتتجلى تلك الرؤية الكونية فيما يُعرف بـ «بذار اللوغوس λόγοι σπερματικοὶ» وهو التعبير الذي نقرأه لأول مرة في كتابات ق. يوستينوس الشهيد، ثم تناقله بعده كلٌ مِن كليمندس السكندريّ وأوريجانوس وغريغوريوس النيصيّ حتى وصلت لمكسيموس المُعترف. ذلك المذهب يوضح كيفية اتصال اللوغوس الخالق بخليقته، فبذار اللوغوس موجودة في كل الجنس البشري حتى قبل مجيء المسيح، لذلك فإن هؤلاء الذين عاشوا قبل المسيح لكن بحسب اللوغوس هم مسيحيون بالحقيقة. وتعاليم الفلاسفة الوثنيين الحسنة نبعت من خلال اشتراكهم في بذرة اللوغوس الإلهيّ. (راجع الفصلين العاشر والثالث عشر مِن الدفاع الثاني للقديس يوستينوس). فالوجود الإلهيّ حاضر بالفعل في الخليقة مِن خلال «بذار اللوغوس» لكن بصورةٍ كامنة، فاللوغوس (الله) يعمل في داخل الخليقة، يدفعها نحو الأبدية، نحو اتحادها به، نحو التألُّه.
لقراءة معالجة تفصيلية أنصح بالرجوع لكتاب:
Torstein Tollefsen, The Christocentric cosmology of St. Maximus the Confessor (Oxford: Oxford University Press, 2008).
[42] لقراءة معالجة تفصيلية أنصح بالرجوع لكتاب: الأب فاضل سيداروس، لاهوت التاريخ البشري (بيروت: دار المشرق، 1997م).
[43] مكسيموس المعترف (580-662م): راهب ولاهوتي بيزنطي، مُعترف بقداسته في كلا الكنيستين الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية.
[44] Georges Florovsky, the Collected Works of Georges Florovsky, 168-9. [This is the blessed end, on account of which everything was created. This is the Divine purpose, which was thought of before the beginning of Creation, and which we call an intended fulfillment. All creation exists on account of this fulfillment and yet the fulfillment itself exists because of nothing that was created. Since God had this end in full view, he produced the natures of things. This is truly the fulfillment of Providence and of planning. Through this there is a recapitulation to God of those created by Him. This is the mystery circumscribing all ages, the awesome plan of God, super-infinite and infinitely pre-existing the ages. The Messenger, who is in essence Himself the Word of God, became man on account of this fulfillment.]
[45] اعتمدنا في عرضنا لرؤية الأب نيقوديموس الأثوسي اللاهوتية على دراسة:
Archimandrite Hierotheos Blachos, “Τὸ ᾿Απροϋπόθετο τῆς Θείας ᾿Ενσαρκώσεως” [The unconditionality of the divine incarnation], Ἐκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, No. 355 (16 December 1992).
[46] Irenaeus, The Demonstration of the Apostolic Preaching (trans. J. Armitage Robinson; London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1920), 75. [who also at the end of the times, to complete and gather up all things, was made man among men, visible and tangible, in order to abolish death and show forth life and produce a community of union between God and man.] (paragraph 6)
[47] Irenaeus of Lyons, “Against Heresies”, in: The Ante-Nicene Fathers Vol.I : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325 (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 446. [but when He became incarnate, and was made man, He commenced afresh1 the long line of human beings, and furnished us, in a brief, comprehensive manner, with salvation; so that what we had lost in Adam—namely, to be according to the image and likeness of God—that we might recover in Christ Jesus.] (Book: 3. Chapter: 18. Paragraph: 1)
[48] أقوال مضيئة لآباء الكنيسة، (القاهرة: دار القديس يوحنا الحبيب للنشر، 2008م)، ص 34
[49] أقوال مضيئة لآباء الكنيسة، ص 526
[50] رهبان دير القديس أنبا مقار، وجودنا وكياننا في المسيح في فكر القديس كيرلس الكبير، (وادي النطرون: دار مجلة مرقس، 1994م )، ص 6
[51] راجع دراسة: جون إدوارد، ”تكوين التكوين“، في: دورية المبادئ، السنة الأولى، العدد الثاني، ص ص 34-47


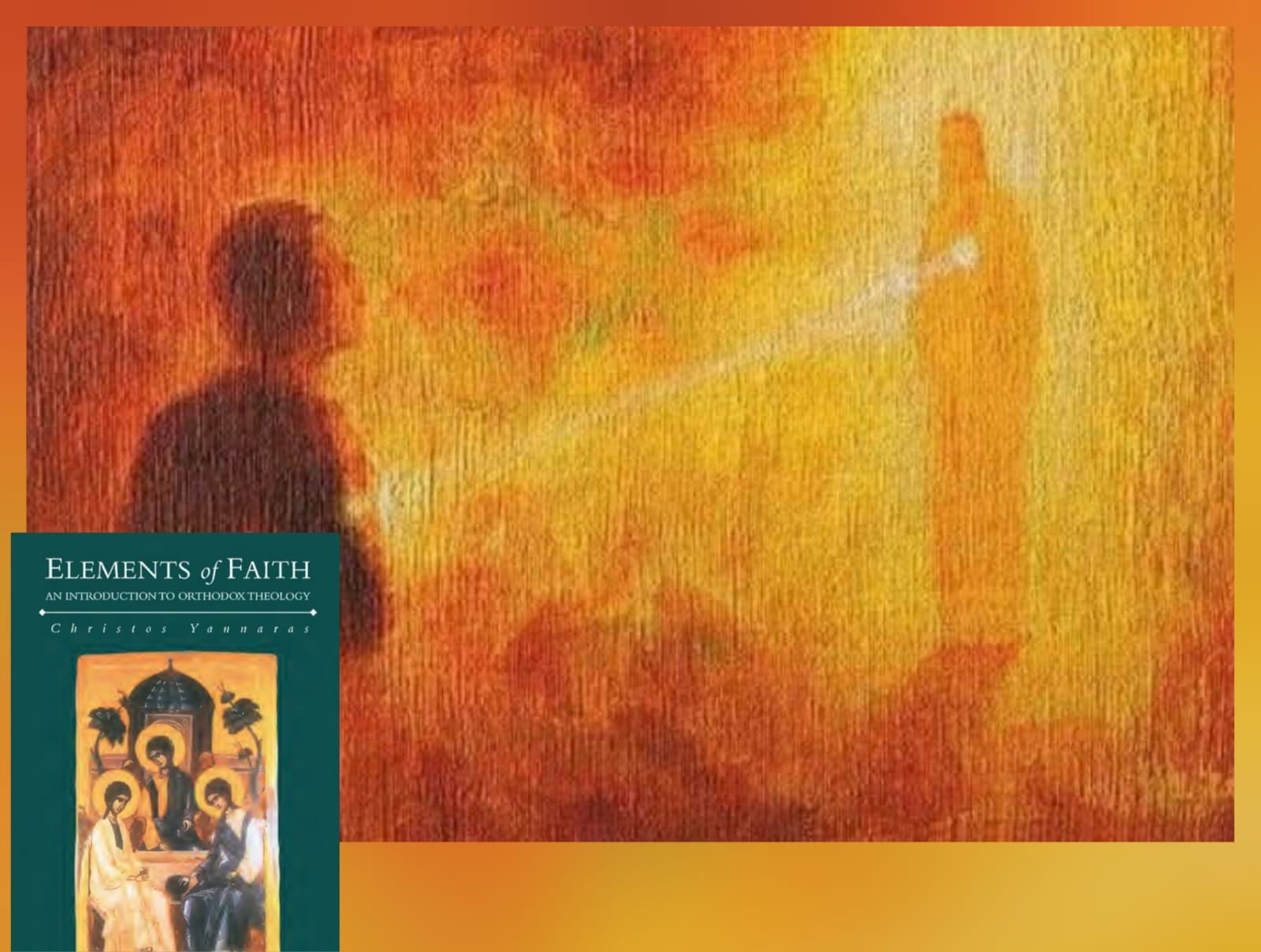
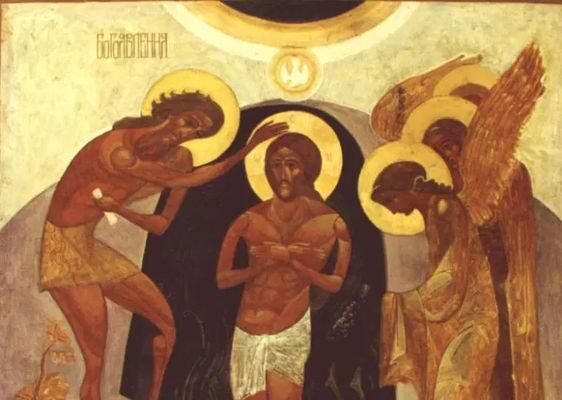
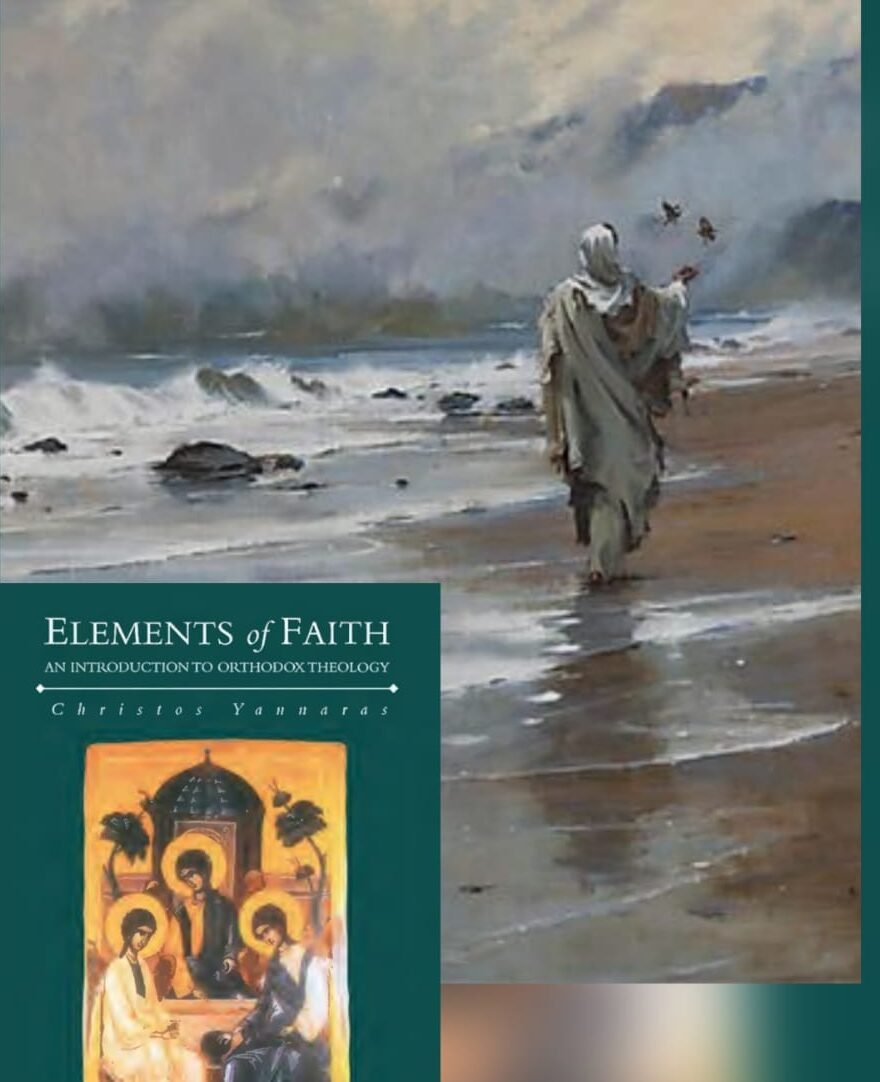

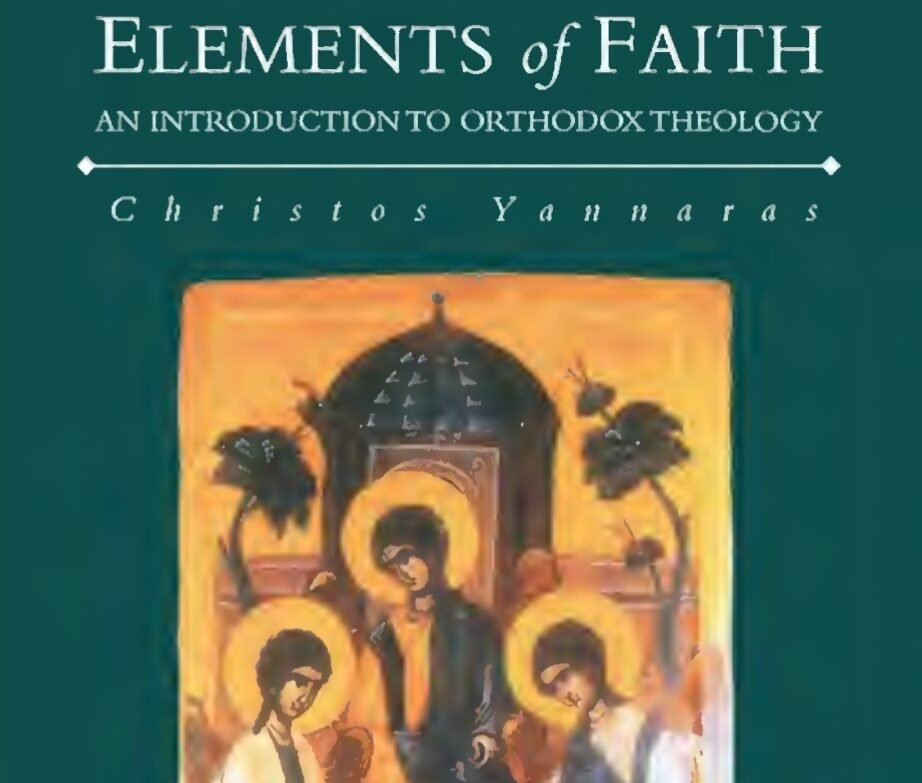

التعليقات
ظافر مرجانة
شكرا على توضيح معنى التجسد
Youssif Mourad
يا الله ❤️