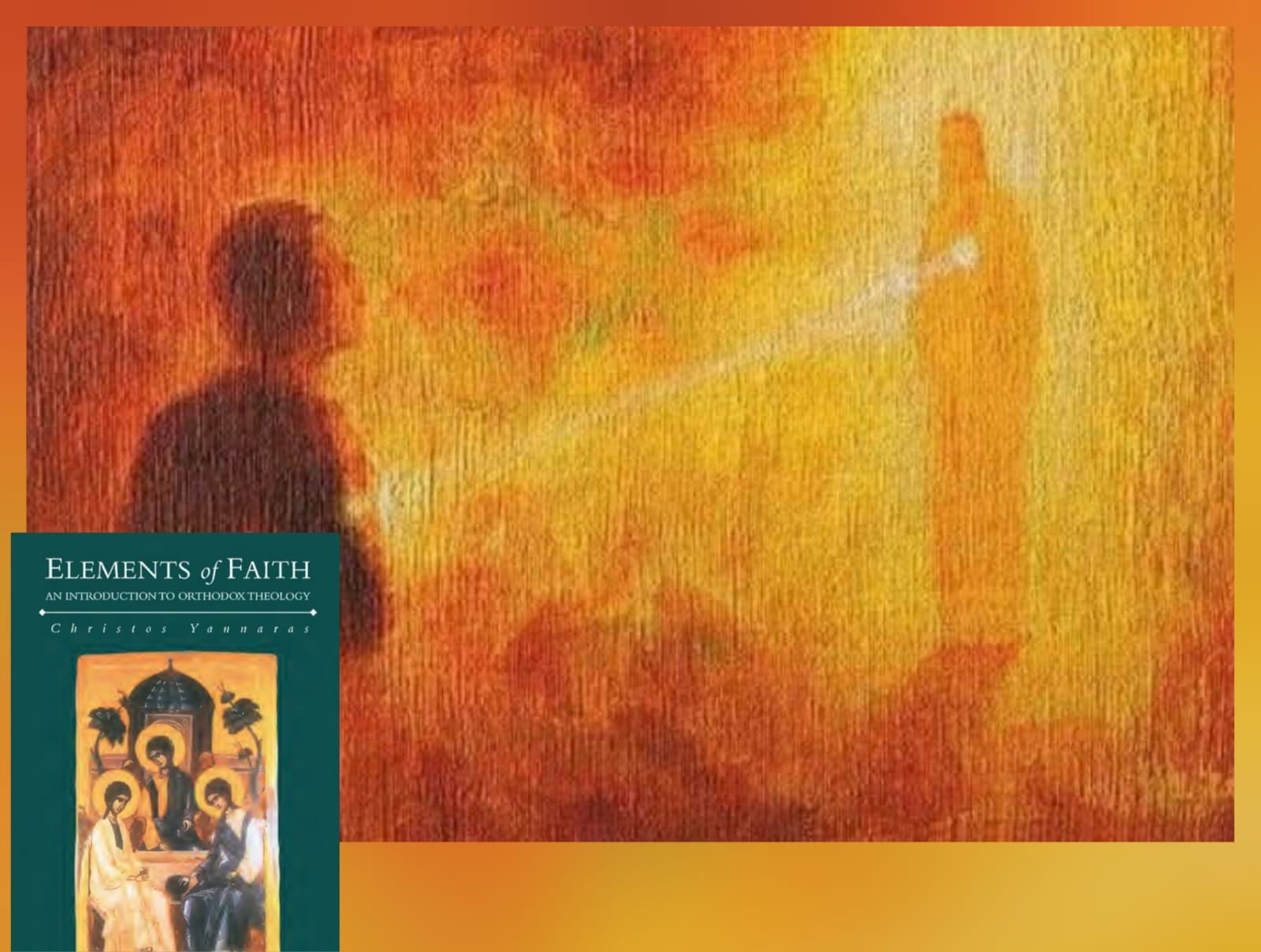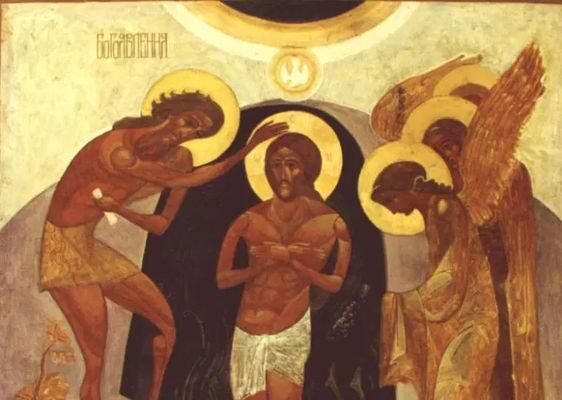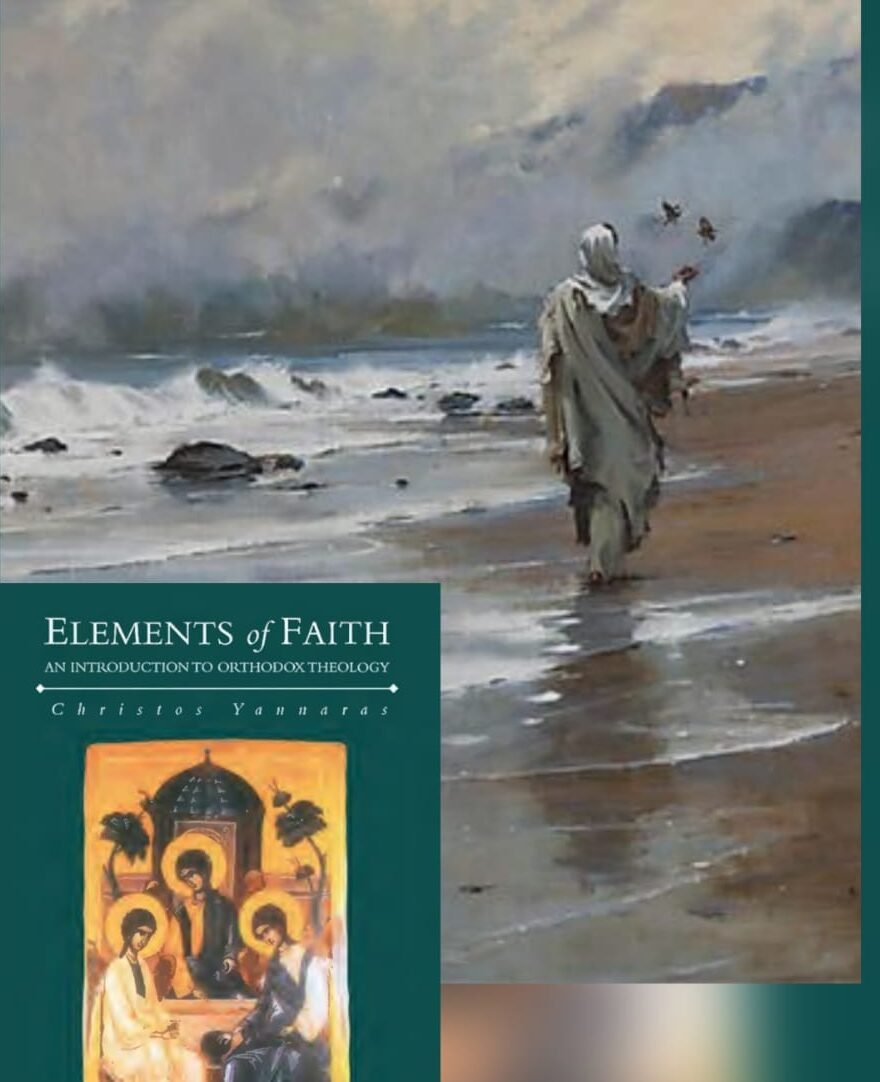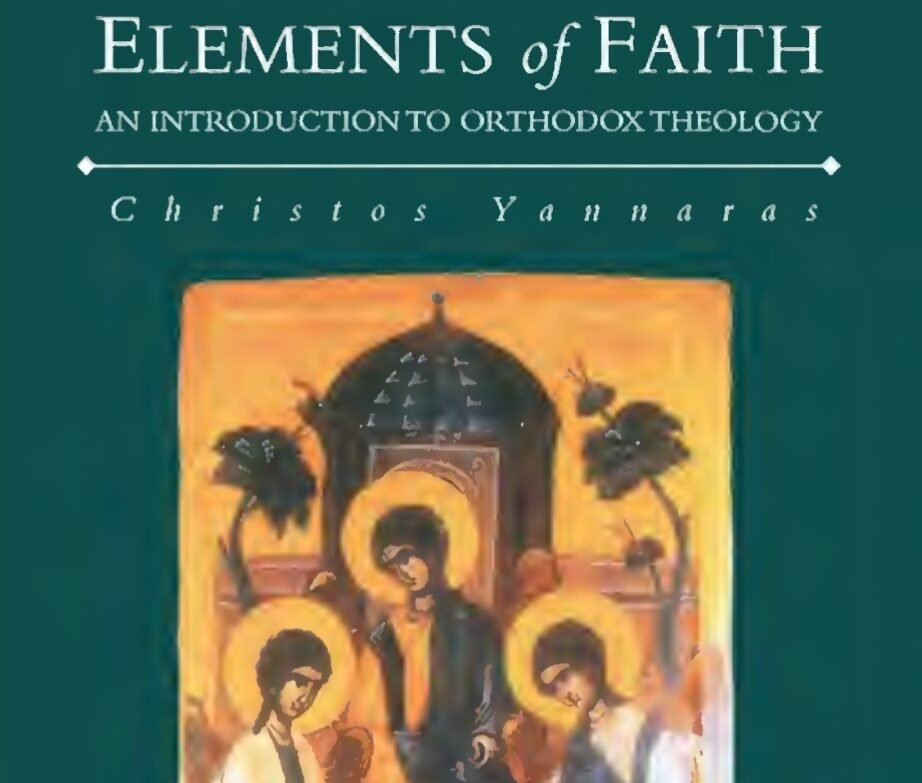المعرفة الثالوثية
يرى البروفيسور توماس تورانس (لاهوتي بروتستانتي) أنه كان لابد من التجسد سواء قبل أو بعد سقوط آدم لكي يمكن للجنس البشري أن يدخل إلى معرفة الله بطريقة عملية من خلال التجسد الإلهي، أي من خلال معرفة ذاته كثالوث من خلال نقطة في ذاته وفي كياننا كمخلوقات، حيث يقول التالي:
”الأمر الأول: أنه إذا أرادنا حقًا أن نعرف الله فلابد أن يكون قد أُعطيت لنا نقطة للدخول إليه، بحيث تكون هذه النقطة في كل من الله ذاته، وفي كياننا نحن كمخلوقات. وهذا هو بالتحديد ما حصلنا عليه في التجسد، حيث إعلان الله عن ذاته «كآب» يتم من خلال إعطائه ذاته لنا في يسوع المسيح ابنه، وعندما يعطينا الله أن نصل إلى معرفته بهذه الصورة فهو يفعل هذا في إطار ظروف المكان والزمان؛ أي داخل حدود ما يمكن أن نفهمه نحن البشر. وفي نفس الوقت، فإن المعرفة التي يعطيها لنا الله عن ذاته في ابنه المتجسِّد يكون مركزها في الله ذاته، وبالتالي يكون كل فهمنا البشريّ لله، وكل تصوراتنا عنه يمكن فحصها وضبطها وفقًا لطبيعته الإلهية. لذلك عندما نقترب إلى الله «كآب» من خلال الابن، فإن معرفتنا للآب في الابن يكون أساسًا قائمًا في صميم كيان الله، كما أن هذه المعرفة تتحدِّد بما هو الله بالحقيقة في طبيعته الذاتية. وبما أننا في يسوع المسي، نستطيع بالحقيقة أن نعرف الله وفقًا لطبيعته الذاتية كآب وابن، فإننا من الممكن أن نعرفه بطريقة تقوية ودقيقة معًا“. [1]
كما يؤكد الأب جورج فلوروفسكي على أن هناك الكثير من اللاهوتيين الكاثوليك المدرسيين مثل: روبرت من دويتش، وأونوريوس أسقف أوتون، ودنس سكوتس؛ الذين تحدثوا عن التجسد غير المشروط، حيث يقول التالي:
”يبدو أن روبرت من دويتش Rupert of Deutz (مات عام 1135 القرن الثاني عشر) هو الأول من بين اللاهوتيين في العصر الوسيط الذي أثار وبشكل رسمي السؤال عن دافع التجسُّد الإلهيّ، وكانت نظريته أو قناعته أن التجسد الإلهيّ يخص التصميم الأصيل للخلق، ومن ثم كان مستقلاً عن السقوط، كان التجسد اٌلهي بحسب تفسيره ورؤيته، هو تمام وكمال تحقيق غاية الله الأولى من الخلق أصلاً، وهو هدف في حد ذاته، وليس مجرد علاج بالفداء والخلاص للفشل البشريّ. وكان أونوريوس أسقف أوتون Honorius of Autun (مات عام 1152 في القرن الثاني عشر) يتبع نفس القناعة. أما علماء القرن الثالث عشر العظماء، مثل: ألكسندر أسقف هيلز، وألبرت ما جنوس، فقد تبنيا فكرة التجسُّد مستقلاً عن السقوط كأكثر الحلول إقناعًا وموائمةً للمشكلة. أما دنس سكوتوس (Duns Scotus 1266-1308) فقد شرح وفسَّر المفهوم بأكمله بمنتهى الحيطة والحذر والرصانة المنطقية“. [2]
ثم يستطرد الأب فلوروفسكي شارحًا مفهوم التجسد غير المشروط عند دانز سكوتس (اللاهوتي الكاثوليكي) كالتالي:
”فإن التجسُّد الإلهيّ بالنسبة له وبمعزل عن السقوط، لم يكن مجرد افتراض موائم ومناسب، بل تجسُّد ابن الله كان بالنسبة له هو السبب ذاته لظهور فعل وتدبير الخلق. وإلا هكذا فكَّر هو؛ فإن هذا الفعل الفائق الذي أتمَّمه الله يُفترض أنه كان مجرد شيء ما عارض أو حادث أو ظرفي. مرةً أخرى، فإن كان السقوط هو علة وسبب ما سبق أن عيَّنه الله لمجيء المسيح، لنجم تبعًا لذلك، إن كان العمل الأعظم لله هو مجرد فعل عارض أو حادث أو ظرفي وطارئ، فإن مجد الكل لن يكون بهذه الكثافة التي لمجد المسيح، ولبدا الأمر غير معقول، وغير منطقي التفكير فيه أن الله قد سبق وأتَّم مثل هذا العمل بسبب خير آدم أو عمله الصالح، إنْ لم يكن آدم قد أخطأ. إن السؤال بأكمله بالنسبة للباحث دانز سكوتس كان وبالضبط حول أمر «سبق التعيين»، أو الهدف الإلهيّ أي ترتيب وفق الأفكار التي في المشورة الإلهية للخلق. وكان المسيح، ذلك المتجسِّد هو أول موضوع وهدف مشيئة الله الخالقة، ولكان لأجل المسيح أي شيء آخر قد تم خلقه لأجل الجميع“. [3]
ويقتبس الأب فلوروفسكي فكرة دنس سكوتس (لاهوتي كاثوليكي) عن أسباب التجسد غير المشروط كالتالي:
”إن تجسُّد المسيح لم يكن قد تم النظر فيه هكذا عرضيًا أو بشكل طارئ، بل قد تم النظر إليه كغاية فورية وحاسمة بواسطة الله منذ الأزل، هكذا، وحين نتحدث عن أمور قد سبق، وأن عيَّنها الله، فإن المسيح بالطبيعة البشرية، كان قد سبق وعُيَّن مثل الآخرين، إذ هو الأقرب إلى نهاية وقصد ما“. [4]
ويؤكد الأب فلوروفسكي أن توما الأكويني (لاهوتي كاثوليكي) تبنى فكرة التجسد غير المشروط معتمدًا على ق. أوغسطينوس كالتالي:
”وقد ناقش الأكويني أيضًا (1224- 1274) المشكلة تلك بإفاضة طويلة. وقد رأى الثقل كله للمجادلات لصالح الرأس بأنه، حتى بمعزل عن السقوط: «فإنَّ الله رغم ذلك سيتجسَّد»، وقد اقتبس عبارة القديس أوغسطينوس: «في تجسُّد المسيح، لابد من اعتبار أمور أخرى إلى جانب غفران الخطايا ورفعها» (الثالوث13: 17)“. [5]
ثم يعطي الأب فلوروفسكي تقريرًا عن حرص بونافنتورا (لاهوتي كاثوليكي) وذلك عند مناقشة التجسد غير المشروط أو التجسد المشروط بالسقوط كالتالي:
”وقد اتبع بونافنتورا (1221-1274) نفس الحرص؛ مقارنًا الرأيين -أحدهما لصالح التجسُّد بمعزل عن السقوط، والآخر معتمدًا عليه، وخلِص إلى أن: «كلا الرأيين يحفِّز النفس على التكريس بعدة اعتبارات مختلفة: الأول (أي التجسُّد غير المشروط)، رغم ذلك، والأكثر توافقًا مع حُكم المنطق والعقل، ومع ذلك يبدو أن الأمر الثاني أكثر قبولاً لتقوى الإيمان“. [6]
ثم يسرد الأب فلوروفسكي العديد من اللاهوتيين الكاثوليك (خاصةً الرهبان الفرنسيسكان) والبروتستانت المؤمنين بالتجسُّد غير المشروط كالتالي:
”وبالإجمال، فإن دنس سكوتس قد تبعته الأغلبية من اللاهوتيين في النظام الفرنسيسكانيّ، بل وبواسطة عدد ليس بالقليل خارجه، على سبيل المثال: يوتيسيوس كارتوسيانوس، وجابرييل بييل، وجون فيسل، وفي عصر مجمع ترنت بواسطة جياكومو ناتشيانتي أسقف تشيوزان، وجاكوبوس ناكلانتوس، وأيضًا بواسطة بعض المصلحين الأوائل، على سبيل المثال: بواسطة أندرياس أوسياندر […] ومن بين الأبطال الكاثوليك الغربيين عن القانون المطلق للتجسُّد الإلهيّ (أي التجسد غير المشروط)، على المرء أن يذكر وبصفة خاصة فرانسوا دو سال، ومالبرانش، ولقد أصر مالبرانش وبشدة على الضرورة الميتافزيقية لسر التجسُّد بمعزل نهائيّ عن السقوط، وإلا هكذا يزعم، لما صار هنا من سبب مقبول ومضبوط أو هدف لفعل الخلق ذاته […] ومن بين الأنجليكان، وفي القرن الأخير، فإن الأسقف ديسكوت يتذرع وبقوة بما يُسمَى «الدافع المطلق» في مقاله الرائع المثير للإعجاب حول «إنجيل الحق». أما الأب الراحل سيرجي بولجاكوف، فقد كان من المؤيدين بشدة للرأي القائل بأن سر التجسد الإلهيّ لابد أن نعتبره قانونًا مطلقًا وضعه الله، حتى قبل كارثة ومأساة السقوط“.[7]
ونبدأ من حيث أنتهى الأب فلوروفسكي، وننتقل للحديث عن أسباب ومناقشة الأب سيرجي بولجاكوف لموضوع التجسُّد غير المشروط، مستخدمًا نص قانون الإيمان النيقاوي القسطنطينيّ للتأكيد على تعليم التجسُّد غير المشروط كالتالي:
”السؤال الأعم والأكثر استباقية الذي ينشأ هنا هو هل التجسُّد هو وسيلة فقط للفداء ومصالحة الله مع الإنسان؛ أي هل بهذا المعنى هو نتيجة السقوط: «فيا لا ذنب آدم السعيد» ، وفعل سوتيرلوجيّ (خلاصيّ)، أم هل بمعنى محدَّد هو مستقل عن السوتيرلوجي، وفعل محدَّد مسبقًا في حد ذاته. بكلمات أخرى، كيف يُطرح هذا السؤال عادةً في علم اللاهوت والآبائيات، ويتم الإجابة عليه بالطريقتين، بالرغم من هيمنة التفسير السوتيرلوجيّ (الخلاصيّ) للتجسُّد (خاصةً في علم الآبائيات). بمعزل عن النصوص المقدَّمة أعلاه، [8] يُقدَّم التجسُّد عادةً أيضًا في الكتاب المقدس على أنه لخلاص الإنسان من الخطية، ورفع حمل الله خطايا العالم على نفسه على نحو ذبائحيّ. ويتفق ذلك مع التحقيق الحقيقيّ والثابت للتجسُّد: «من أجلنا، ومن أجل خلاصنا». ولكن الجزء الأول من صيغة قانون إيمان نيقية: «من أجلنا» لها معنى عام أكثر من استعمالها المحدَّد في الجزء الثاني: «من أجل خلاصنا». علاوة على ذلك، لا تشير النصوص المعروضة أعلاه إلى الهدف المباشر والفدائيّ (الخلاصيّ) للتجسُّد، بل إلى غايته النهائية والعالمية: غاية اتحاد وانجماع كل شيء سماويّ وأرضيّ في المسيح“. [9]
كما يناقش الأب سيرجي بولجاكوف موضوع هل كان تدبير التجسُّد الأزليّ لسبق علم الله بسقوط الإنسان، فأعدَّ له التجسُّد أم أنه كان سيحدث سواء أخطأ أو لم يخطئ؛ حيث يرى أن القائلين أنه بسبب علم الله السابق بالسقوط فأعدَّ التجسُّد بأنهم يقحِّمون تصوراتهم البشرية ويفرضونها على الله، مما يعتبره أنثروبومورفيزم Anthropomorphism (تجسيم اللاهوت أو إقحام تصورات بشرية على اللاهوت) كالتالي:
”وبمحاذاة هاتين الغايتين، لا يوجد إما/أو، بل يوجد فقط كلاهما/و. فعلى وجه التحديد أكثر، المعضلة السوتيرلوجية (الخلاصية) متضمَنة في المعضلة الأسخاتولوجية (الأخروية) كالوسيلة في الغاية: فالفداء هو الطريق إلى «مجدنا». لذلك ربما أفضل طريقة للإجابة على سؤال: هل كان من الممكن حدوث التجسُّد دون السقوط هي الاعتراض على السؤال نفسه كسبب غير منطقيّ، أو كأنثروبومورفيزيم غير لائق من جهة أعمال الله“. [10]
ثم يشرح الأب بولجاكوف عدم منطقية السبب أي أن السقوط فقط هو علة تجسُّد الله، حيث يقول التالي:
”يتشكَّل السبب غير المنطقيّ هنا في الاعتقاد بأنه لو لم يخطئ الإنسان، فكان من الممكن أن يترك الله نفسه بدون تجسُّد. وهكذا صار التجسُّد معتمدًا على الإنسان، وبالأخص على سقوطه، وعلى خطيته الأولى، وبالتحليل النهائيّ، حتى على الحية (أي الشيطان). ولكن تشير شهادات الكتاب المقدس المقتبسة أعلاه إلى العكس، حيث كان سر التجسُّد مُعَدَّ «قبل إنشاء العالم»، أي أنه يعبِّر عن العلاقة المقرَّرة والضرورية أكثر بين الله والعالم، وليس فقط بحدث معيَّن في حياة العالم، حتى لو كان حدثًا له أهمية ضرورية لأجلنا. فلم يستخدم العالم سقوط الإنسان لإجبار الله على أن يجعل نفسه متجسِّدًا (لأنه كيف يمكن للعالم أن يضطر الله على فعل أي شيء؟)، بل بالأحرى خلق الله العالم من أجل التجسُّد“. [11]
كما يشير الأب كالستوس وير إلى تعليم الآباء الشرقيين بالتجسُّد غير المشروط كالتالي:
”التجسُّد هو فعل محبة الله للبشر. ويدَّعي العديد من المؤلفين الشرقيين بأنه حتى لو لم يكن الإنسان قد تعرّض للسقوط، فإن الله في محبته للبشر، كان سيصير إنسانًا. ويقولون أيضًا إنه يقتضي فهم التجسُّد على أنه جزء من قصد الله الأزليّ، وليس مجرّد رد فعل على السقوط. تلك كانت وجهة نظر مكسيموس المعترف ومار اسحاق السريانيّ، وكذلك آراء بعض اللاهوتيين الغربيين، ولا سيما دنس سكوتس (1265-1038)“. [12]
[1] الإيمان بالثالوث، ص75، 76.
[2] التجسد والفداء (موضوعات لاهوتية)، ص 105، 106.
[3] المرجع السابق، ص 106.
[4] المرجع السابق، ص106، 107.
[5] المرجع السابق، ص 107.
[6] المرجع السابق، ص108.
[7] المرجع السابق، ص 108، 109.
[8] يقصد النصوص التالية: (1بط1: 19-20؛ 1كو2: 7؛ أف1: 4؛ أف1: 5، 6؛ يو3: 16-17؛ 1يو4: 9، 19).
[9] Bulgakov, Sergius, The Lamb of God, Trans. By Boris Jakim, (USA & U.K: Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2008), p.180.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] كالستوس وير، الكنيسة الأرثوذكسية: إيمان وعقيدة، ص35.