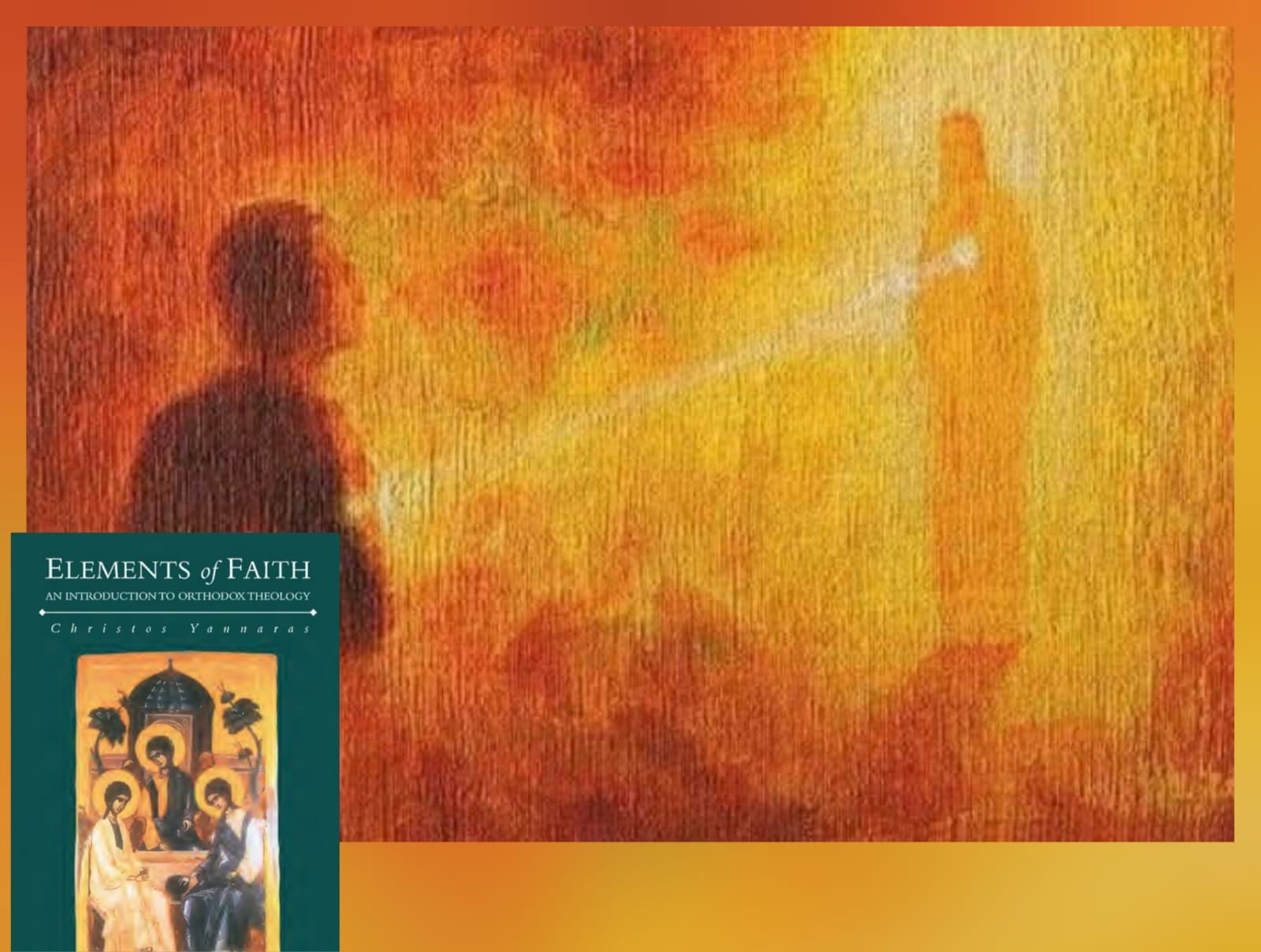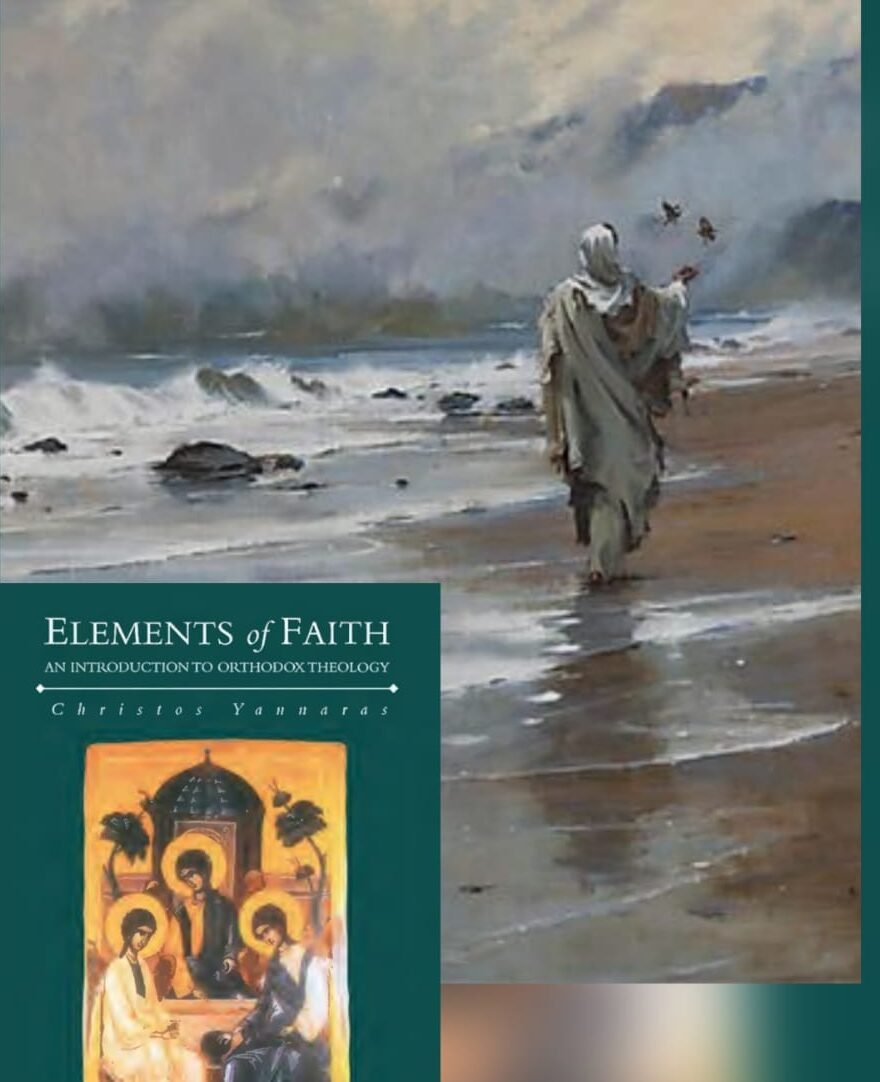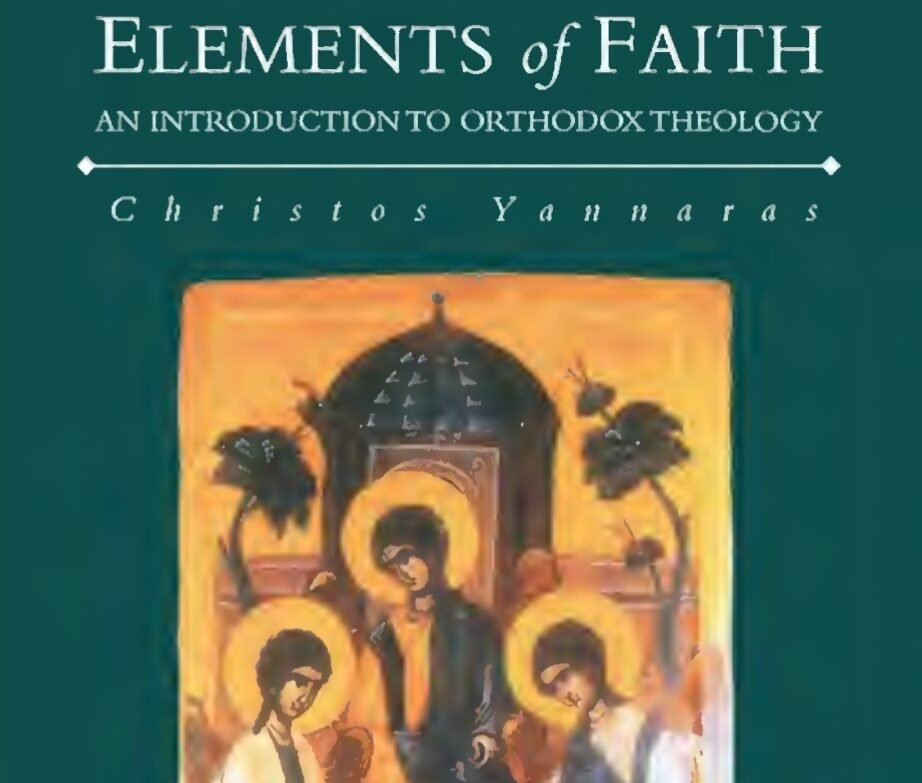في المقال السابق واصلنا تتبّع مسار الانزلاق اللاهوتي في الغرب والذي بدأ مع أنسلم وتعمّق مع توما الأكويني. فبعد أن حوَّل الغرب الخلاص إلى معادلة قضائية محكومة بمنطق الدين والعقاب، أدخل الأكويني ثنائية جديدة بين الطبيعة البشرية والنعمة، مقدّمًا رؤية تجعل النعمة وكأنها إضافة خارجية أو ترقية للطبيعة، بدل أن تكون شركة حيّة في الحياة الإلهية. هذه الفكرة التي لم يعرفها اللاهوت الشرقي، الذي يؤكد لنا أن النعمة ليست “مكافأة” تُعطى من فوق، بل هي الشركة عينها في الحياة الإلهية، والتي بها يُشفى الإنسان ويتقدّس بالتآزر (السينيرجيا) بين إرادته الحرّة وعمل الله فيه. وهكذا يستمر هذا التمييز الغربي في زرع بذور الانقسام في الوعي المسيحي، بينما ظل الشرق الأرثوذكسي متمسكًا بسرّ الاتحاد والتأله، حيث الخلاص هو مسيرة شفاء ونموّ نحو ملء الحياة في المسيح.
وإمعانا في توطيد حالة الإنقسام في الوعي ، قام الإكويني بطرح مفاهيمه عن “الاستحقاق” “Merit” ودعا إلى نوعين من الاستحقاق:
1- الاستحقاق الكامل Condign Merit وهو ثواب على عمل صالح تم بالنعمة ويستوجب مكافأة بعدالة الله
2-الاستحقاق الملائم Congruous Merit وهي مكافأة يمنحها الله برحمته، لا بعدالته الصارمة
وكما نرى، كان الإكويني مولعًا بالتقسيمات العقلية، وهو ولع قاد اللاهوت الغربي إلى متاهات فلسفية معقدة، وأبعد الكنيسة عن جوهر دعوتها: الشركة في الحياة الإلهية. لقد أسس الرجل لنمط من التعريفات الذهنية الصارمة التي ساهمت في اختزال الخلاص إلى مجموعة من المفاهيم التي تُفحص بالعقل، بدلاً من أن يُفهم الخلاص كاتحاد كياني أبدي بالابن المتجسد، اتحاد مدعوّة الكنيسة أن تحياه وأن تقود الناس إلى ملئه.
يقول الإكويني في “الخلاصة اللاهوتية” :
[الاستحقاق والمكافأة يشيران إلى الأمر نفسه، فالمكافأة تُعطى لشخص مقابل عمله وكأنه ثمن له… وحيثما تَتَحقق العدالة تمامًا، يظهر طابع الاستحقاق والمكافأة تمامًا]
(STh I–II, q.114, a.1)
غير أن الإنسان، بحسب الأكويني، لا يمكن أن يستحق شيئًا أمام الله ما لم تُفترض النعمة الإلهية أولًا:
[لا يكون أي فعل للإنسان مستحقًا أمام الله إلا على أساس النعمة الإلهية] (a.2)
فالاستحقاق ثمرة النعمة، ولذلك فإن الاستحقاق بالعدل (meritum de condigno) مستحيل للإنسان بدون النعمة:
[لا يستطيع الإنسان أن يستحق النعمة الأولى المُبِرِّرة… فالاستحقاق ثمرة النعمة.]
وبالنعمة وحدها يصير الإنسان مشاركًا في الطبيعة الإلهية، فيعمل بحرية مدفوعًا من الله نفسه:
[استحقاق الإنسان يقوم على أنه يعمل بإرادته الحرة مدفوعًا من الله] (a.3).
[بنعمة الله نصير شركاء في الطبيعة الإلهية… وهكذا يمكننا أن نستحق الحياة الأبدية.]
وهكذا يخلص الأكويني إلى أن النعمة هي أساس الاستحقاق، وبها وحدها يستطيع المؤمن أن ينال ميراث البنوة والحياة الأبدية.
استحقاق .. عدل .. مكافأة .. ثمن .. لا يكف الإكويني عن تكبيل الذهن الغربي بالمزيد من المصطلحات القانونية التي أمعنت في تشتيت الوعي اللاهوتي عن الحقيقة الخلاصية التي عاشها الشرق وهي أن جوهر تدبير الخلاص هو الشفاء واللإرتقاء عن طريق الإتحاد الأقنومي في المسيح لا على أساس المكافأة أو الاستحقاق!
وحقيقة الأمر أن الشرق لا ينكر أن الخلاص هو عمل النعمة الإلهية ،لكنه يرفض طرح الإكويني الذي يصوّر النعمة كوسيلة تجعل الإنسان جديرًا بالخلاص. لأن الشرق عاش وعلم أن النعمة هي الحضور الإلهي نفسه الذي يشفي الطبيعة البشرية من الفساد ويعيدها إلى شركة الحياة الإلهية.
النعمة ليست وسيلة بل هي الله نفسه ، والإكويني جعل النعمة تُفهم على أنها قوة مخلوقة أو عطية مضافة تساعد في الوصول إلى غاية أعلى ، بينما في اللاهوت الشرقي النعمة هي الطاقة غير المخلوقة وهي حضور الله ذاته وشركة الإنسان المباشرة فيه ، وبالتالي فهي ليست مكافأة ولا وسيطاً ، بل هي اشتراك حي في حياة الثالوث القدوس.
وبالتالي، لا مجال أصلًا لفكرة الاستحقاق، إذ إن الآباء شدّدوا على أن كل ما لنا هو عطية من الله الآب، بالابن، في الروح القدس؛ وعليه فإن الخلاص لا يُفهم أبدًا في إطار المكافأة أو الجزاء، بل في إطار الشركة في الحياة الإلهية.
صحيح أن الإنسان مدعو للمشاركة مع عمل النعمة بحرية ، لكن هذه المشاركة لا تجعل عمله مستحقا بحد ذاته ، لأن الشركة هي تجاوب حر مع المبادرة الإلهية يسمح للإنسان بالإنفتاح على الحقيقة الخلاصية التي هي سر اتحانا في المسيح ، وهكذا خلص الآباء لمفهوم السينيرجيا أي التعاون الحر بين الإرادة والنعمة بعيدا عن منطق المكافأة.
إن الخلاص لم يكن معاملة قضائية، بل فعل حب جارف من الثالوث نحو الطبيعة البشرية. وهذا الحب لا يترك مجالًا للمفاهيم القانونية التي غرق فيها الغرب، إذ أن الشرق لم يعرف منطق الاستحقاق والثواب أو المكافأة، بل عرف التجاوب والشركة والشفاء والتأله. فالاستحقاق لا يمكن فهمه كمكافأة عن عمل، أو كآداة للخلاص ، لأن الخلاص في جوهره ليس استحقاقًا ولا أداةً، بل هو اتحاد المسيح بطبيعتنا ليشفيها ويؤلهها.
جدير بالذكر أن البروتستانتية المصرية تعيد إطلاق هذه الجدلية في وجه الكنيسة القبطية ، وهذا الجدال هو سياق غربي في الأساس وكما نرى فهو صراعٌ كاثوليكي-بروتستانتي ، لكن يبدو أن البروتستانتية ككيان دخيل يعيش على الإنقسام والشقاق ، لا يرى شرعية لوجوده دون استعداء أي كنيسة رسولية ووصمها بما ليس فيها كتبرير للوجود البروتستانتي ذاته ، وهو نوع من الميكانيزمات الدفاعية لأن جوهر البروتستانتية كما قلنا قائم على الإنقسام وهم – على مستوى اللاوعي- يشعرون بحقيقة الأساسات الواهية للبناء اللاهوتي البروتستانتي والتي لا يمكن لها أن تدوم دون شيطنة الكنائس التقليدية من أجل جذب الإنتباه بعيدا عن حقيقة الخواء والفراغ اللاهوتي البروتستانتي!
فلا يمكن للبروتستانتية سوى أن تحاول صبغ الارثوذكسية بمشاكل لم تعرفها أصلا ، فيدَّعون أن الكنيسة القبطية تُعَلِّم أن الخلاص هو بالأعمال مما يهيء الساحة لهجوم بروتستانتي لإيجاد شرعية للمبدأ البروتستانتي: الخلاص بالإيمان وحده sola fide ، وهي الأزمة التي لا تعرفها الأرثوذكسية لأنها لم تعرف هذا الفصام الذي أصاب العقل الغربي ، فالخلاص هو استعلان اتحادنا في المسيح ، هذا الاستعلان الذي ننفتح نحن عليه بقدر تجاوبنا مع النعمة!
ثم يمعن الإكويني في تأصيل فكرة المكافأة فيقول في الخلاصة ضد الوثنيين الكتاب الثالث فصل 119 وما بعده :
[إنه من كرم الله أن الأفعال الإنسانية، التي في ذاتها لا تستحق الحياة الأبدية، تصبح جديرة بها بواسطة ترتيب النعمة الإلهي]
إذن هو يقول أنه لا استحقاق طبيعي للخلاص لكن النعمة ترفع أفعال المؤمن فتكون مستحقة
ثم يبدأ الإكويني في التأصيل اللاهوتي لأحد أسوأ الأفكار التي عرفها الغرب اللاتيني :
[من وحدة الجسد السري تنبع عمومية استحقاقات المسيح والقديسين للجميع… وللكنيسة سلطة توزيع هذا الكنز]
الخلاصة اللاهوتية (Suppl., Q.25, esp. a.1–2)
الأكويني هنا يبنى جسراً منطقيًا يبدأ من (الاستحقاق بعد النعمة) ويمر بـ (وجود فائض من استحقاقات المسيح والقديسين للجسد كله) وصولاً إلى (سلطة الكنيسة في توزيع هذا “الكنز”)، وهذه هي البنية اللاهوتية التي ستدعم لاحقًا نظام صكوك الغفران.
إن الأثر العميق الذي تركه الإكويني بفكرة الاستحقاق قد ألقى بظلاله في قلوب قادة حركة الاصلاح الذين عانوا من الاضطراب الوجداني الذي خلقته هذه الفكرة ـ ونرى ذلك وبوضوح في مارتن لوثر الذي رفض فكرة الاستحقاق وطرح فكرته بمجانية الخلاص كهبة إلهية ، ولم يدرِ لوثر إنه قد وضع الاساس لتحطيم الجانب الإنساني في تدبير الخلاص والعمل التآزري بين الله والإنسان كما عاشه الشرق ، نعم الخلاص هو هبة إلهية ولكن حصر هذا الخلاص في هبة تُمنَح بدلا من شفاء للطبيعة وتألهها هو ضرب خفي للتجسد وللإتحاد الأقنومي في المسيح!
علاوة على أن ماقام الإكويني بتأصيله قد فتح الباب على مصراعيه أمام فكرة صكوك الغفران والتي شكلت إحدى المبررات الرئيسية لقيام حركة الإصلاح ، وهذا كله أمعن في تشويه تدبير الخلاص واستمرا التيه اللاهوتي الذي عاش فيه الغرب وتعمَّق افتراقه عن لاهوت الشرق الثري.
وجدير بالذكر بعد الأزمة التي أثارتها تجارة صكوك الغفران في القرن السادس عشر، تناول مجمع ترنت الموضوع بصرامة في دورته الخامسة والعشرين (1563)، مؤكدًا أن سلطة منح الغفرانات أعطاها المسيح للكنيسة، لكنه حذر من الإسرافات والإساءات مثل التجارة والبيع، وأمر الأساقفة والقسوس بضبط الممارسة ومنع أي استخدام مالي لها. وفي العقود والقرون التالية، شددت الكنيسة على أن الغفران لا يتعلق بمحو الذنب — الذي يُغفر بالتوبة والاعتراف — بل بالعقوبة الزمنية، ومنحته عبر أعمال روحية مثل الصلاة، وزيارة الأماكن المقدسة، وممارسة أعمال الرحمة، دون أي علاقة بالمال. وقد أكد مجمع الفاتيكان الثاني (1962–1965) والقانون الكنسي الجديد (1983) هذا الموقف، معرفًا الغفران بأنه إعفاء من العقوبة الزمنية المستحقة عن الخطايا المغفورة عبر خدمة الكنيسة وخزينة الاستحقاقات، مع التأكيد على عدم السماح بأي معاملات مالية. واليوم، تواصل الكنيسة الكاثوليكية تعليم وجود الغفرانات الجزئية والكاملة، مع التركيز على ممارستها كعمل روحي مرتبط بالتوبة والأعمال الصالحة، بعيدًا عن أي شراء أو بيع.
وكما نرى فقد وضعت البدلية العقابية الأساس الذي قاد إلى إختزال تدبير الخلاص في صفقة قانونية باردة، ومهدت الطريق أمام الإكويني لوضع تفسيراته الخاصة عن الاستحقاق والمكافأة ، فإزداد الغرب تيها واغترابا وافتراقا عن أصالة اللاهوت الشرقي ، مفسحا المجال أمام انقسامات لا حصر لها ، و أفرز عوارًا لاهوتيًا عميقًا تجلى بوضوح في ما أنتجته حركة الإصلاح ، وهو ذات النهج الذي ما زال يُعاد تقديمه حتى اليوم!
أما نحن فنعود إلى أحضان “أم الشهداء” لنسمع ونتعلم ما حفظته لنا الليتورجيا، حيث نقول في صلاة الصلح للقداس الغريغوري :
[أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب،
الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم،
وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة،
وأردت ان تجدده وترده إلى رتبته الأولي،
لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا
بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها
وصرت لنا وسيطًا لدى الآب
والحاجز المتوسط نقضته
والعداوة القديمة هدمتها
وأصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدًا
وأكملت التدبير بالجسد
وعند صعودك إلى السموات جسديًا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم
هذا أيضًا الآن أنعم به علينا يا سيدنا، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت.]
المسيح أكمل التدبير بتجسده لتجديد الطبيعة البشرية وردها إلى مسار التأله ، لا كمعاملة قضائية بل كفعل حب إلهي لا يُحدّ. والكنيسة لا تشير هنا إلى استحقاق ، ولا تقف عند حدود “مجانية” النعمة ، بل أنها تصرخ من أعماقها وتطلب بحرارة وتتجاوب بحرية مع المبادرة الإلهية التي استعلنت لنا في سر المسيح.
وللحديث بقية